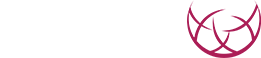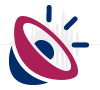 الصوتيات
الصوتيات
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أخرج النسائي في سننه، والبخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند، والبزار والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (أتى أعرابي من البادية عليه جبة من طيالسة، مكفوفة بديباج أو مزرورة بديباج فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم هذا هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، وأن يرفع كل راعٍ ابن راعٍ، ثم قام إليه فجذبه بمجامع جبته، وقال له: أرى عليك ثياب من لا يعقل، ثم تركه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن نوحاً قال لابنه -وفي رواية لـ
هذا حديث جليل وهو من القصص الصحيحة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أخرج الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار هذا الحديث مختصراً تحت النهي عن لبس الحرير، وهذا يوضح لماذا جذب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي جذبة شديدة، مع أن خلقه عليه الصلاة والسلام هو السماحة، وأنه كثير ما آذاه الناس أو كثير ما رأى بعض المخالفات من بعض المسلمين فكان يترفق بهم؟!
من بدا فقد جفا
قوله: (إن هذا يريد أن يضع كل فارس ...)
أورد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية روايةً: أن هذا يريد أن يضع كل رأس ابن رأس وهوالفارس، يضع. أي: من الضعة، وهي الهوان، ويرفع. أي: من الرفعة، يريد أن يقول: إن هذا الرجل الأعرابي جاء متبختراً مختالاً مفتخراً بحلة من سندس، يريد أن يضع وأن يلحق الهوان بكل فارس ابن فارس، والفارس: هو الرجل النبيل.
الرواية التي ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية: (رأس)، فهذا يريد معنى الفارس، والمقصود به الرأس.
وجرى في اللغة أنهم إذا رأوا رجلاً نبيلاً يسمونه فارساً، يقولون: هذا له أخلاق الفرسان. أي: أنه نبيل، رأس.
فهذا الأعرابي جاء مختالاً متكبراً يريد أن يرفع كل راع ابن راع، فأنت تعلم أن الراعي هذا إنما يكون من أهل البادية، الذين يرعون أغنامهم، بخلاف أهل الحضر، فإن عندهم الخيول.
فالمقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الكبر على وجه هذا الرجل وعلى مشيته، فقال: إنه يريد أن يضع المرفوع ويرفع الوضيع. هذا معنى الكلام، ولذلك أخذه فجذبه جذبة شديدة.
قوله: (أرى عليك ثياب من لا يعقل)
قال له: (أرى عليك ثياب من لا يعقل). أي: الحرير.
هذه شهادة بأن الذي يلبس الحرير كأنه لا عقل له، والسر في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (من لبس الحرير في الدنيا حُرِمَه في الآخرة) أهناك رجلٌ عنده عقل أو ذرة من عقل يلبس الحرير هنا ثم يحرمه إذا دخل الجنة وهو يرى أترابه يلبسون الحرير؟
فالذي يفضل هذا الحرير على حرير الجنة غير عاقل، لذلك قال له النبي : (أرى عليك ثياب من لا يعقل) أي: لا يزن الأمور وزناً صحيحاً.
معنى قوله: (إني قاصر -أو قاص- عليكما الوصية )
كلمة: قاصر. هنا تحتمل معنيين:
المعنى الأول: (إني قاصر عليكما الوصية) أي: إنني سأوصيكما أنتما فقط، ولعلك لو تأملت في قول نوح عليه السلام: ![]() رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً
رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً ![]() [نوح:26] تعلم أن امرأة نوح وابنه ومعظم قومه كفروا، وقد ظل ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم فلم يستجيبوا، فهذا يوحي إليك أن المؤمنين كانوا قلة، فلم يجد في حال موته غير ابنيه، لذلك قال: (إني قاصر عليكما الوصية) أي: إني سأقتصر عليكما في هذه الوصية.
[نوح:26] تعلم أن امرأة نوح وابنه ومعظم قومه كفروا، وقد ظل ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم فلم يستجيبوا، فهذا يوحي إليك أن المؤمنين كانوا قلة، فلم يجد في حال موته غير ابنيه، لذلك قال: (إني قاصر عليكما الوصية) أي: إني سأقتصر عليكما في هذه الوصية.
هذا هو المعنى الأول.
المعنى الثاني: (إني قاصر عليكما الوصية) أي: إني سأقصِّر في وصيتي ولن أطيل عليكم، فهذا واضح من رواية النسائي ، والنسائي إنما روى هذا الحديث في السنن الكبرى -وله السنن الصغرى لم تطبع حتى الآن، إنما المطبوع من سنن النسائي الآن: السنن الكبرى- فيُفهم من سياق الحديث في سنن النسائي أن نوحاً عليه السلام قال: (إني سأقصر) يعني: لن أطيل عليكم حتى تحفظوا وصيتي، ولذلك قال: (آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين) ما أطال.
(إني قاص عليكما الوصية): أي: وصية نوح عليه السلام، وتجد أن كثيراً من الأنبياء كانوا يوصون عند الموت، وكثير من الصحابة كانوا يوصون عند الموت، ولا ترى رجلاً صالحاً إلا ويوصي عند الموت، وهذا شيء يغفل عنه أهل الدنيا العاملين لها، قلَّما يوصي، يوصي بماذا؟ بماله الذي سيتركه فلا يحتاج هذا المال إلى وصية، قال صلى الله عليه وآله وسلم (خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تبقى حتى إذا كانت ههنا -أي: الروح- قلت: هذا لفلان، وهذا لفلان، وقد كان لفلان) يعني: بغير أن تتكلم، وبغير أن توصي هذا المال سيذهب رغم أنفك إلى فلان إرثاً يرثه.
بـ![]() أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ![]() [البقرة:131]؛ لأن هذا أقرب مذكور للضمير، وأقرب مذكور للضمير هو المقصود من الكلام، فقوله: (بها)، والهاء هنا هو الضمير، ؟ وأقرب مذكور:
[البقرة:131]؛ لأن هذا أقرب مذكور للضمير، وأقرب مذكور للضمير هو المقصود من الكلام، فقوله: (بها)، والهاء هنا هو الضمير، ؟ وأقرب مذكور: ![]() أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ![]() [البقرة:131] أي: أنه أوصى أولاده بالإسلام.
[البقرة:131] أي: أنه أوصى أولاده بالإسلام.
ويعقوب أيضاً وصى أولاده: ![]() أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي
أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ![]() [البقرة:133] فهو يطمئن على هذه الذرية، وعلى دورها في الحياة.
[البقرة:133] فهو يطمئن على هذه الذرية، وعلى دورها في الحياة.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، فقال: (استوصوا بالنساء خيراً) مِن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، وهذا ومن آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام أيضاً قوله: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك -ثلاث مرات).
وعند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أوصى في مرض موته قال: (الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليَّ اللبِن كما صُنِع برسول الله صلى الله عليه وسلم).
وفي سنن ابن ماجة ومسند أحمد بسند حسن عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما جاءته الوفاة قال: (ألا لا تتبعوني بمجمر -أي: بنار - ولا تبنوا على قبري بناءً، وإني بريء مِن كل سلق وحلق وخرق، قالوا: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم).
وقصة الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه إنما أوصى بذلك؛ لأنه كان نباشاً للقبور، يعني: فإذا دفنوا الميت يفتح القبر ثم يأخذ الكفن ويترك الميت عرياناً.
فلما قرب أجله وأحس بدنو أجله جمع أولاده فقال لهم: (أي بَنِيَّ! كيف كنتُ لكم؟ قالوا: يا أبانا كنت خير أب، قال: فإن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني -أي: يطحنوه- ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قَدَر علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين، فلما مات نفذوا الوصية، فجمعه الله تبارك وتعالى بقوله: كن، فكان الرجل فقال: أي عبدي! ما حملك على ما صنعتَ؟ قال: خشيتُك، قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك).
فجرت عادة الصالحين الخائفين من لقاء الله عز وجل أن يوصوا؛ ولكن لا يفوتني أن أنبه إلى أن الوصية إن كانت بمعصية فلا تنفذ بالاتفاق، وهذه قصة رجل ممن سبقنا، فلا حجة بهذه القصة؛ لأن في شرعنا ما يخالفها.
وفي الحديث المشهور عند أهل السنة باسم حديث البطاقة: (أن رجلاً عاصٍ، يُنْشَر له تسعة وتسعون سجلاً من الذنوب -السجل الدفتر الطويل، فلما أيقن الرجل أنه ذاهب إلى النار وسُحب، فقال الله عز وجل: أعيدوا عبدي، فقال له: إنه لا يُظْلَم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا شيئاً، فأخرج بطاقة -انظر! تسعة وتسعون سجلاً موضوعة في كفة من الميزان- فأخرج بطاقة فيها: (لا إله إلا الله) -أي: أن هذا الرجل كان يقول هذه الكلمة -، فوضعت هذه البطاقة في كفة أمام السجلات فطاشت كل هذه السجلات، ورجحت (لا إله إلا الله وليس هناك شيء يترجح على اسم الله تبارك وتعالى)).
قال الله تبارك وتعالى: ![]() تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ![]() [الإسراء:44].
[الإسراء:44].
إذاً: هذا التسبيح هو حياة كل شيء، ولذلك الإنسان الذي لا يلهج بذكر الله عز وجل ميت، وذكر الله تبارك وتعالى بالنسبة للقلب كالماء بالنسبة لكل شيء حي، فيه الري وفيه الحياة: ![]() وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ![]() [الإسراء:44].
[الإسراء:44].
وقوله تعالى: ![]() وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ ![]() [الإسراء:44] يدل على أن كل شيء يسبح بحمده، قال بعض السلف: حتى صرير الباب يسبح بحمده، انظر! لما تفتح الباب يصدر صريراً، فهذا الصرير تسبيح، وهذا الحجر الذي تراه يخر يسبح،
[الإسراء:44] يدل على أن كل شيء يسبح بحمده، قال بعض السلف: حتى صرير الباب يسبح بحمده، انظر! لما تفتح الباب يصدر صريراً، فهذا الصرير تسبيح، وهذا الحجر الذي تراه يخر يسبح، ![]() وَإِنَّ مِنْهَا
وَإِنَّ مِنْهَا ![]() [البقرة:74] أي: من الحجارة
[البقرة:74] أي: من الحجارة ![]() لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ![]() [البقرة:74].
[البقرة:74].
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (لا يسمع صوتَ المؤذن شجر ولا حجر -إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة). وقد وردت رواية مفصلة في سنن ابن ماجة، ومسند الإمام أحمد، عن أبي سعيد بلفظ: (لا يسمع صوت مؤذن إنس ولا جن، ولا شجر ولا حجر ولا مدر، إلا شهد له يوم القيامة).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: (كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم).
واحتج الذين يقولون: إن الذي يسبح هو الحي وليس الحجر بقوله صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين يعذبان: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، ثم دعا برقائق من جريد -جريدة خضراء- فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفاً وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) وقالوا: الدليل أنه قال: (ما لم ييبسا) فهذا يدل على أنهما إن يبسا لن يسبحا.
ورد العلماء الآخرون على هذا القول منهم الخطابي أبو سليمان وغيره أن التخفيف عن صاحبي القبرين ليس للنداوة التي في الجريد، وإنما بشفاعته -عليه الصلاة والسلام-، بدليل حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم : (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب، فوضع عليه رقائق من جريد، وقال: لعله يرفعه عنه بشفاعتي)، فدل على أن الشفاعة المذكورة أو التخفيف المذكور، ليس للنداوة التي في الجريد، وإنما هي لشفاعته عليه الصلاة والسلام.
ومن هنا تعلم خطأ الذين يضعون الأشجار في المقابر أو يضعون الرياحين والورود، وقد توسعوا فيه توسعاً منكراً، كما يفعل بعض مَن يُسَمون بالعظماء في بلاد المسلمين، فإنهم إذا ذهبوا إلى بلاد الكفرة يأخذون هذه الورود التي لا حياة فيها ولا نداوة ولا طلاوة، ويذهبون إلى قبور الكفرة الفجرة ويضعونها، وقد عقدوا وجوههم مظهرين التألم والتأسف والحزن، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا مررتم بقبور الظالمين فمرُّوا مسرعين حاسري رءوسكم، خشية أن يحيق بكم ما حاق بهم)، زفتا صلى الله عليه وسلم: (حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار).
ولكن هؤلاء -الذين يسمون بالعظماء- يقولون: تيتو صديقي، تيتو يرحمه الله، وتيتو هذا لم يكن حتى نصرانياً بل إنه شيوعي، ومع ذلك يقول: صديقي وماكاريو رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترحم المسلم على الكافر.
ومثل هذه الورود أو الأشجار أو الجريد لا يحصل بها تخفيف على صاحب القبر لمجرد النداوة الموجودة فيها، إنما هو لشفاعته عليه الصلاة والسلام في أولئك، وهذا كما قال بعض العلماء خاص به صلى الله عليه وسلم.
فقوله: ![]() وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ![]() [الإسراء:44] : يدل على أن كل شيء يسبح كما قال سعيد بن جبير وغيره أن هذا عام في كل شيء،
[الإسراء:44] : يدل على أن كل شيء يسبح كما قال سعيد بن جبير وغيره أن هذا عام في كل شيء، ![]() وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ![]() [الإسراء:44].
[الإسراء:44].
ورد في صحيحي البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر)، زبد البحر: الفقعات التي تكون فوق الماء، وترى هذا لو ذهبت إلى أي شلال أو نافورة يطلع منها الماء بقوة ستجد هذه الفقاقيع، فهذا اسمه الزبد، كما قال تعالى: ![]() فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ![]() [الرعد:17] يتفرقع، ولا أحد ينتفع منه:
[الرعد:17] يتفرقع، ولا أحد ينتفع منه: ![]() وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ
وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ ![]() الرعد:17] ما الذي ينفع الناس؟ الماء، فهذا يمكث في الأرض.
الرعد:17] ما الذي ينفع الناس؟ الماء، فهذا يمكث في الأرض.
فيقول عليه الصلاة والسلام: (لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر فقلت: سبحان الله وبحمده مائة مرة غُفِرَت لك ذنوبك).
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم مائة مرة لم يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد عليه) أي: تزيد فوق المائة، تقول مائة وخمسين أو مائتين أو ثلاثمائة أو أربعمائة على حسب ما يُتاح لك، أو على حسب ما تستطيع فهذا معنى قوله: (إلا رجل زاد على ما جاء به).
وفي صحيح مسلم من حديث جويرية بنت الحارث وهي أم المؤمنين رضي الله عنها : (أنها جلست بعد صلاة الغداة تسبح الله تبارك وتعالى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة فوجدها جالسة كما تركها، تسبح؛ فقال لها: أنتِ جالسة منذ خرجتُ؟ قالت: نعم. قال: لقد قلتُ أربع كلمات أفضل مما قلتيه: سبحان الله وبحمده، رضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته)، هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها أفضل مما قالته جويرية من صلاة الغداة حتى قرابة الظهر.
وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم).
فـ(سبحان الله وبحمده) صلاة كل شيء كما قلنا: ![]() وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ ![]() [الإسراء:44] فالتسبيح صلاة.
[الإسراء:44] فالتسبيح صلاة.
![]() وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ![]() [الإسراء:44].
[الإسراء:44].
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله! إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً أفَيُعَدُّ هذا من الكبر؟ قال: لا.إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس) (بطر الحق): البطر. معناه: الكفر، بطر بالنعمة، أي: كفرها، بطر بالحق: أي كفر بالحق ورده بعدما ظهر له، فهذا هو الكبر، الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما ألقيتُه في النار ولا أبالي).
وقوله: (وغمط الناس) معنى الغمط: أي: الحط، غمط على فلان. أي: حط منه واحتقره، ونسبه إلى الضعف والهوان، فغمط الناس أي: الحط عليهم واحتقارهم.
فهذا هو الفعل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى عنه نوحٌ عليه السلام وهو يوصي ولديه.
وإن يسر الله تبارك وتعالى سيكون لنا بعض الدروس -لكن ليست في مواعيد ثابتة- في مثل هذه الصفات المذمومة مثل: الكذب، والعُجْب، والبطر، حتى لا يركن المسلم إلى مثل هذه الصفات؛ لأن مثل الرياء أو الشرك قد يكون أحياناً أخفى من دبيب النمل، والرجل قد يأمن مكر الله تبارك وتعالى، ويتصور أنه لا يمكن أن يغتر في يوم من الأيام، فتزل قدمه . ولا يدخل الجنة إلا خائفٌ، أي: لا يصل إلى الجنة بأمان إلا الخائف، فأين الذي قد نام ملء جفونه وظن أن مثل هذه الصفات لا يمكن أن تحوم حوله، ونام (قرير العين هانيها)! هذا في الغالب، وكما يقول بعض السلف: (رب طاعة أورثت عزاً واستكباراً، ورب معصية أورثت ذلاً وانكساراً).
ويقول بعض السلف -وهو متسرع في هذه الكلمة- (إن العبد ليذنب الذنب فيأخذ بيده إلى الجنة، وإن العبد ليفعل الطاعة فتقوده إلى النار).
لو أن أي رجل سطحي التفكير قرأ هذا الكلام لهذا العالِم الجليل لظن أن هذا ضد الآيات وضد الأحاديث، وهو لا يقصد هذا، لا يقصد أن الذي يفعل الطاعة تأخذه طاعته إلى النار، وأن الذي يفعل المعصية تأخذه معصيته إلى الجنة، فهذا مستحيل، بل لا يمكن أن يخطر على بال أحد.
إنما يقصد هذا العالِم الجليل أن الرجل قد يطيع الله تبارك وتعالى في طاعة ما، فيفتخر بها، ويقول: أنا أقوم الليل، وأصوم، وأتصدق بمالي، وفلان كان جائعاً وأنا أكَّلته، وفلان كان يريد غطاءً وأنا كسوته، وفلان الفلاني في المستشفى أنا وصِّيت عليه وأعطيته مبلغاً، ويجهر بهذا، وعنده من الشهوة الخفية وهو العُجْب، شيء كثير يحبط مثل هذه الأعمال.
هذا معنى ما يريده هذا العالِم.
(ورب معصية أورثت ذلاً وانكساراً): كالرجل يفعل الذنب ويظل مشفقاً على نفسه، ويظن أن الله تبارك وتعالى سيؤاخذه بذنبه، فيظل خائفاً من لقاء الله تبارك وتعالى، فلا يقارف المعاصي أبداً.
فهذه المعصية عادت عليه بالنفع، وهذه الطاعة عادت عليه بالضر.
ومحور ارتكاز هذا المفهوم هو: النية. فكلما أخلصت لله تبارك وتعالى، وخلَّصت أعمالك من شوائب الرياء والسمعة والعُجب، كان عملك أقرب إلى القبول.
ففي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت عندما تلت قوله تبارك وتعالى: ![]() وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ![]() [المؤمنون:60]، معنى الآية: أن عباداً لله تبارك وتعالى يفعلون الشيء وهم خائفون، وسر خوفهم أنهم سيرجعون إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبهم على ما فعلوا:
[المؤمنون:60]، معنى الآية: أن عباداً لله تبارك وتعالى يفعلون الشيء وهم خائفون، وسر خوفهم أنهم سيرجعون إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبهم على ما فعلوا: ![]() وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا ![]() [المؤمنون:60] أي: يفعلون الفعل الذي يفعلونه، ويأتون به:
[المؤمنون:60] أي: يفعلون الفعل الذي يفعلونه، ويأتون به: ![]() وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ![]() [المؤمنون:60] من هذا الفعل:
[المؤمنون:60] من هذا الفعل: ![]() أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ
أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ![]() [المؤمنون:60] أي: بسبب أنهم راجعون إلى الله عز وجل، فقالت عائشة : (يا رسول الله! أهذا الرجل يسرق ويزني؟ -الرجل يفعل الشيء وهو خائف، من المؤكد أنه يفعل معصية؛ فهل سيتصدق وهو خائف؟! أو يدخل مثلاً يصلي أو يقوم الليل وهو خائف؟! هذا لم يخطر في بال
[المؤمنون:60] أي: بسبب أنهم راجعون إلى الله عز وجل، فقالت عائشة : (يا رسول الله! أهذا الرجل يسرق ويزني؟ -الرجل يفعل الشيء وهو خائف، من المؤكد أنه يفعل معصية؛ فهل سيتصدق وهو خائف؟! أو يدخل مثلاً يصلي أو يقوم الليل وهو خائف؟! هذا لم يخطر في بال
إذاً: المسألة لم تَعُد مسألة معصية، بل إن هذا أرقى درجات الورع، بمعنى أننا الآن بعيدون جداً عن حيز المعصية، نحن مع أتقى خلق الله عز وجل: ![]() يُؤْتُونَ مَا آتَوا
يُؤْتُونَ مَا آتَوا ![]() [المؤمنون:60] يتصدقون ويصلون، ويصومون ويزكون، ويفعلون الخيرات وقلب الواحد منهم خائف، خائف من أن الله تبارك وتعالى يردُّ عليه عمله، بأن يكون قد تسلل إلى قلبه شيء من هذه الشهوة الخفية، والله تبارك وتعالى لا يظلم، فإن رد على العبد عمله فهو لم يظلمه.
[المؤمنون:60] يتصدقون ويصلون، ويصومون ويزكون، ويفعلون الخيرات وقلب الواحد منهم خائف، خائف من أن الله تبارك وتعالى يردُّ عليه عمله، بأن يكون قد تسلل إلى قلبه شيء من هذه الشهوة الخفية، والله تبارك وتعالى لا يظلم، فإن رد على العبد عمله فهو لم يظلمه.
(فيخشى هؤلاء ألاَّ يُتَقَبَّل منهم).
لذلك من منطلق قول حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري: (كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ..) أما وقد استطالت مثل هذه الشرور فإننا نضع إن شاء الله تبارك وتعالى معالم لكل صفة مذ مومة حتى يتجنبها المسلمون.
نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير، وأن يتقبل منا العمل الصالح إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
 البث المباشر
البث المباشر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
12918
قراءة متن الشاطبية
مشاري راشد العفاسي -
10944
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
4775
قصص الأنبياء - قصة ابراهيم في فلسطين وبناء الكعبة - قصة اسماعيل واسحاق- قصة قوم لوط
طارق السويدان -
4384
منظومة عشرة الإخوان
توفيق سعيد الصائغ -
2820
قصة آدم عليه السلام
نبيل العوضي -
2696
سلسلة السيرة النبوية من الظلمات إلى النور
راغب السرجاني -
2356
الرقية الشرعية - مشاري راشد العفاسي
-
2252
متن الدرة المضية__عثمان المسيمي
عثمان المسيمي -
2061
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي -
2057
عمر بن الخطاب
بدر بن نادر المشاري

عدد مرات الاستماع
3086718663

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك