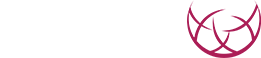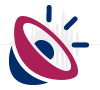 الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- أبو إسحاق الحويني
- صلاح الآباء
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
![]() يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ![]() [آل عمران:102].
[آل عمران:102].
![]() يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ![]() [الأحزاب:70-71].
[الأحزاب:70-71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال الله عز وجل: ![]() وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ * وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ
وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ * وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ![]() [القصص:5-7].
[القصص:5-7].
إن جيل التمكين يبدأ من الرضاعة، وأي أمة تريد أن تنتصر على عدوها ويُمَكَّن لدينها ومذهبها، إنما يبدأ ذلك من الرضاع.
والآباء الذين يتولون تربية الأبناء، إذا لم يعرفوا حقيقة رسالتهم، فلا يمكن أن يخرج جيل التمكين.
فلابد من صلاح الوالد أولاً؛ لأن للوالد أثراً عميقاً في نفس ولده.
اتباع سنن الآباء سبب في الصد عن سبيل الله
أرسل الله عز وجل أنبياءه إلى الأرض، فأرسل نوحاً عليه السلام إلى قومه فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء، ![]() فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ ![]() [المؤمنون:24]، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء.
[المؤمنون:24]، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء.
ثم أرسل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام فصدوا عن سبيل الله أيضاً بسنة الآباء: ![]() وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ![]() [الأنبياء:51-53].
[الأنبياء:51-53].
![]() وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ![]() [الشعراء:69-74].
[الشعراء:69-74].
ثم أرسل الله عز وجل موسى إلى قومه فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء، قال موسى لقومه: ![]() قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ * قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ
قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ * قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ![]() [يونس:77-78].
[يونس:77-78].
وأرسل الله عز وجل صالحاً عليه السلام إلى ثمود ، ![]() قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّاً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ
قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّاً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ![]() [هود:62].
[هود:62].
وأرسل الله عز وجل شعيباً إلى مدين ، ![]() قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ
قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ![]() [هود:87].
[هود:87].
وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قومه فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء أيضاً، ![]() أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ![]() [الزخرف:21-23].
[الزخرف:21-23].
وقال تعالى: ![]() فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ
فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ![]() [هود:109].
[هود:109].
فسنة الآباء الصد عن سبيل الله عز وجل، اتخذوا سنة الآباء ذريعة؛ وذلك لأن للوالد تأثيراً عميقاً جداً في نفس الولد.
قال الله عز وجل: ![]() فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ![]() [البقرة:200].
[البقرة:200].
فلو كان الواحد منا يذكر الله جل وعلا أكثر من الوالد، فكانوا يأتون في المواسم فيقول القائل: أبي كان على السقاية، وأبي أنفق كذا، وأبي أطعم كذا، ولا يذكرون شيئاً من أمر الآخرة، فقال الله عز وجل لهم ذلك: ![]() فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً
فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ![]() [البقرة:200]، (أو) هنا بمعنى (بل)، جاءت لتحقيق الخبر وزيادة، يعني: اذكروا الله أكثر من ذكركم لآبائكم.
[البقرة:200]، (أو) هنا بمعنى (بل)، جاءت لتحقيق الخبر وزيادة، يعني: اذكروا الله أكثر من ذكركم لآبائكم.
وهذا كقول الله تبارك وتعالى: ![]() ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ![]() [البقرة:74]، يعني: بل هي أشد قسوة.
[البقرة:74]، يعني: بل هي أشد قسوة.
وكقوله تبارك وتعالى: ![]() وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ![]() [الصافات:147]، يعني: بل يزيدون.
[الصافات:147]، يعني: بل يزيدون.
وكقول الله تبارك وتعالى: ![]() أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ![]() [النساء:77]، يعني: بل أشد خشية.
[النساء:77]، يعني: بل أشد خشية.
وكقول الله تبارك وتعالى: ![]() فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ![]() [النجم:9]، يعني: بل أدنى.
[النجم:9]، يعني: بل أدنى.
وكقول الله تبارك وتعالى: ![]() وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أقرب
وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أقرب ![]() [النحل:77]، يعني: بل هو أقرب.
[النحل:77]، يعني: بل هو أقرب.
وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) يعني: بل عابر سبيل.
فـ(أو) هنا جاءت لتحقيق الخبر وزيادة، يعني: اذكر الله عز وجل أكثر من ذكرك لأبيك.
فهذا يدل على أن ذكر الواحد منا لأبيه أمر عظيم، يقضي حياتَه في ذكر الوالد.
ولا تظن أن ولدك أعمى! ولدُك ينظر إليك مثل الكاميرا المسجلة، قد تفعل الفعل ولا تنظر إليه ولا تأبه له، فيأخذ الولد منه الأسوة والقدوة، كما قال الشاعر:
وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه
ما ضيع أبا طالب إلا الآباء، ورفقة السوء، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه المسيب ، قال: (لما حضرت
عبد المطلب كان رجلاً شريفاً في قومه، والفخر بالأنساب أصله الاعتزاز بالآباء، وقد جاء الإسلام فأبطله، وأنت تلحظ في دنيا الناس! يُسَب الله عز وجل بأقذع السباب، فيسمع السامع فيكتفي بأن يقول: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم فقط، ولو أن هذا الساب سب والد ذلك السامع ما اقتصر على الاستغفار، بل لدخل معه في معركة، ولربما فقد حياته دفاعاً عن والده.
لذلك قال الله عز وجل: ![]() فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ![]() [البقرة:200] لما في نفس الولد من تعظيم الوالد، فـعبد المطلب كان رجلاً شريفاً في قومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه، بل كان يرتجز ويقول:
[البقرة:200] لما في نفس الولد من تعظيم الوالد، فـعبد المطلب كان رجلاً شريفاً في قومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه، بل كان يرتجز ويقول:
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
ولما كان يجيء الرجل من البادية مسلماً، فكان يسأل عن محمد بن عبد المطلب ، فكان لـعبد المطلب هذا الشرف، وهذه العراقة عند العرب، وكان العرب إذا احتقروا إنساناً نسبوه إلى جد غامض لا يُعَرف، كما قال أبو سفيان في الحديث الذي رواه البخاري في أوائل صحيحه عن ابن عباس -حديث هرقل - قال أبو سفيان لما دخل على هرقل وجعل يسأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا يقول، كان من جملة ما قال أبو سفيان بعد أن قال هرقل : (فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده، ونترك ما كان يعبد آباؤنا -يعني أوردها على سبيل الاستنكار، أنحن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد الآباء؟ أوردها
يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو كبشة جد أمه الأبعد وهو غير معروف.
فلما أحبَّ أن يسبه لم يقل: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابن عبد المطلب؛ لأن النسبة لـعبد المطلب شرف، وهو لا يريد أن يشرفه، هو يريد أن يسبه، فنسبه إلى جد غامض لا يُعْرَف.
ولذلك الأنساب كانت لها قيمة عند العرب، وهذا كله طَبْعٌ على الافتخار بالآباء وتعظيم الآباء.
وأول كفر حدث في الأرض كان سببه الآباء، قال الله تبارك وتعالى: ![]() وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً
وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ![]() [نوح:23]، هؤلاء خمسة من صالحي قوم نوح عليه السلام، جاء الشيطان للآباء، فقال: هؤلاء الصالحون إذا ماتوا لم يعلم الأبناء بذلك، فما هو المانع أن تُصور صوراً لهم، فإذا سألك ولدك مَن هذا؟ قل: يا بني! هذا ود ، هذا سواع، هذا يغوث. فيكون وجود الصنم مبرراً ومسوغاً لسؤال الولد إياه؛ فإذا لم يوجد ما يذكره بالماضين نسيهم، ولا تعرف الماضين إلا إذا رأيت أثراً. ولذلك تجد آثار الفراعنة، تلمح ويسمونهم: أجدادنا. ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه النسبة، فليسوا جدودنا، لكن .. لماذا يلمعون هذه الآثار؟ إحياءً لتراث الفراعنة. لكن هب أنه لا يوجد هرم ، ولا يوجد (أبو الهول)، ولا يوجد رمسيس .. فيطلع الناشئة من الجيل لا يعرفون من هو أبو الهول، لماذا؟ لأنه لا يوجد مقتضىً ليسأل عنه.
[نوح:23]، هؤلاء خمسة من صالحي قوم نوح عليه السلام، جاء الشيطان للآباء، فقال: هؤلاء الصالحون إذا ماتوا لم يعلم الأبناء بذلك، فما هو المانع أن تُصور صوراً لهم، فإذا سألك ولدك مَن هذا؟ قل: يا بني! هذا ود ، هذا سواع، هذا يغوث. فيكون وجود الصنم مبرراً ومسوغاً لسؤال الولد إياه؛ فإذا لم يوجد ما يذكره بالماضين نسيهم، ولا تعرف الماضين إلا إذا رأيت أثراً. ولذلك تجد آثار الفراعنة، تلمح ويسمونهم: أجدادنا. ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه النسبة، فليسوا جدودنا، لكن .. لماذا يلمعون هذه الآثار؟ إحياءً لتراث الفراعنة. لكن هب أنه لا يوجد هرم ، ولا يوجد (أبو الهول)، ولا يوجد رمسيس .. فيطلع الناشئة من الجيل لا يعرفون من هو أبو الهول، لماذا؟ لأنه لا يوجد مقتضىً ليسأل عنه.
فقال لهم: لما يجد الولد تمثالاً يقوم فيسأل:
- ما هذا يا أبي؟ فتقول له: يا بني هذا فلان. فيقول الولد: من فلان؟ فتقول: فلان يا بني هذا كذا وكذا، وكان رجلاً صالحاً، يقوم الليل ويصوم النهار... إلخ.
فأدخل الشيطان عليهم الشبهة من هذا الباب، فصنع الآباء التماثيل وهم آمنون من عبادتها.
فلما مات الآباء الذين كانوا يعرفون ذلك، جاء الأبناء الذين لا يعرفون الحامل للآباء على هذا التصوير، فقالوا: ما صوَّر آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم كانوا يعبدونهم؛ فعكفوا على عبادتهم فكان هو أول كفر في الأرض.
ما بين آدم عليه السلام ونوح لا يوجد كفر. بدأ الكفر في قوم نوح، وهذا كله بسبب تعظيم الآباء.
وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقول: (وأبي، وأبي -يعني يحلف بأبيه، بـ(واو القسم)- قال: يا
انظر إلى عمر ! ما حلف بأبيه لا ذاكراً في نفسه ولا ناقلاً عن غيره، كأن يقول: أنا كنت مع فلان فقال: وأبي، يعني: ما قالها من نفسه ولا نقلها عن غيره؛ لأن الله يبغض ذلك: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم).
فهذا هو موقع الوالد وخطورته في حياة ولده.
أنت أيها الوالد! نريد أن يخرج من صلبك جيل التمكين، فهل يستقيم الظل والعود أعوج؟! وهل فاقد الشيء يعطيه؟! فلابد أن تكون -أيها الوالد- عالماً لماذا خُلِقت حتى تورث ولدك هذه المعرفة؛ لذلك كان تبصير الآباء بحقيقة خَلْقهم ضرورة من آكد الضرورات لاستقامة الولد.
أيها المبتلى الممتحن! -وأنت لا تدري- تعرف ما هي أعظم مصيبة تعترضك في حياتك؟!
أعظم مصيبة ليست أن تمرض بمرض عضال، ولا ألاَّ تجد القوت، ولا ألاَّ ترزق الولد، ولا أن تضطهد في الدنيا، ولا أن تسجن، ولا أن تعذب. لا. فأعظم مصيبة تعترض الإنسان في حياته قطاع الطرق؛ قطاع الطريق إلى الله. فالطريق إلى الله فيه لصوص يسرقون قلبك ولبَّك، فلماذا تفرِّط؟
إن الذين ينشرون الشبهات كل يوم يسرقون لبَّك وقلبك. فهل تحققت وتمسكت بمذهب الصحابة الذي هو الباب الوحيد للنجاة.
أمامك ثلاث وسبعون باباً مفتوحاً، والباب الوحيد الذي ينجيك ويوصلك إلى الله في وسط الثلاثة والسبعين باباً هو باب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهل عرفت علامة الباب؟
إذا لم تعرف علامة الباب ربما دخلت من باب يوصلك إلى النار، وعلى كل باب من هذه الأبواب من يدعو إليه، ويزين مذهبه، ويقول: أنا على الحق، وسائرهم في النار.
فهذه محنة من أعظم المحن.
وإن بعض أهل البدع قد يأتيك من باب الجدل وبسطةٍ اللسان، فما يؤمِّنك أنك إذا أعطيت أذنك لهذا المبتدع شدَّكَ، فإذا دخلت من الباب ضعتَ؟!
هذه هي المحنة حقاً؛ لأن أول خطوة لها تبعات فأخطر خطوة هي الأولى.
فهل تحققتَ بمذهب القرن الأول: (ما أنا عليه اليوم وأصحابي).
إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إنه ليس شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته). إذاً: علامة الباب الوحيد معروفة، وليست بمجهولة، ودورك أن تبحث عن علامة الباب الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة، والبحث عنه أولى من طلب لقمة الخبز، بل أولى من سفرك إلى الخارج تبتغي العلاج أو الرزق، فحياتك في الدنيا والآخرة مرهونة بالاستقامة على هذا الطريق، ولا تصل ولا تلج الطريق إلا من هذا الباب.
تريد أن تتصدق؟ تصدَّق بجنيه واحد في الشهر؛ لكن ثَبِّتْه.
تريد أن تكون محبوباً؟
صلِّ ركعتين فقط قيام ليل، وثبِّتها، لا تصلِّ (100) ركعة في ليلة وتظل تنزل عن ذلك حتى تترك ليس هذا محبوباً إلى الله تعالى.
المحبوب أن تعمل العملَ ولو كان قليلاً، وتداوم عليه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أحب العمل إلى الله -عز وجل- أدومُه وإنْ قَل).
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم) وقد أريتكم نموذجاً لـعبد الله بن عمرو .
خذ نموذجاً آخر لـعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: (كنت شاباً عزباً أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤىً فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم ...) وهناك بعض الرؤى كانت بشارات مثل رؤيا عبد الله بن سلام أنه أمسك بحلقة في السماء، فقص على النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا، فقال: (
وفي الرؤيا الأخرى لما رأى نفسه على قمة الفسطاط؛ فقال له: (أنت تموت على الإسلام)، بشارة من أعظم البشارات.
فـعبد الله بن عمر كان يسمع تعبير الرؤيا وكبده يتفتت، يتمنى أن يرى رؤيا هو أيضاً، حتى يحكيها فيقول له: أنت من أهل الجنة، فيستريح، فتكون بشارة.. قال: (... فقلت لنفسي ليلة: لو كان فيك خيراً لرأيت رؤيا. قال: فنمت ليلة فرأيت رؤيا، رأيتُ مَلَكين يجراني إلى النار، وأنا أقول: أعوذ بالله من النار، فلما وقفت على شفيرها، إذا أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، فجاء ملك فأخذني منهما وقال لي: لم تُرَع -أي: لم تخف- فاستيقظت فاستحيا أن يقصها على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقصها على
هذا هو الجيل الفريد: (ما عليه اليوم أنا وأصحابي)، هذا هو الجيل الناصع، غُرَّة في جبين الزمان، لا تجد مثلهم من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الزمان، لأنه جيل فريد.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: (نظر الله عز وجل في قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار قلوب أصحابه له). اختارهم الله له، لذلك فهو جيل يشرف والأسوة به ممكنة، بل واجبة.
مثال آخر عن عبد الله بن عمر : أنه كان إذا رأى عبداً صالحاً -من عبيده- عليه أمارات الصلاح والنجابة، والإخبات والخشوع، أعتقه. يقول له: أنت حر، فإذا قال لعبدٍ من العبيد: أنت حر، فكأنه تصدق بثمن العبد، فأعتق عدداً من العبيد، فلما رأى العبيد هذا تظاهروا بالصلاح والزهد والخشوع، فجاء ابنه -ابن عبد الله - قال له: (يا أبتِ! إنهم يخدعونك، وهذا تفريط. أي: تَحَقَّقْ من المسألة؛ لأن هناك بعض العبيد يخادعون، فقال: يا بني! من خَدَعَنا في الله خُدِعْنا له. ولم يأسف عبد الله بن عمر على خروج المال حتى وإن كان في غير مظنته.
إنه يعامل ربه، ولا يعامل الخلق.
هذا هو الوجه المشرق الناصع للجيل الفريد الذي مكن الله عز وجل له في عشر سنوات فقط، رأيتم رجالاً كوَّنوا دولة على وجه الأرض في عشر سنوات!! وما تكون السنون العشر في عمر الزمان؟! في عشر سنوات كانت لهم دولة.
إذاً: الباب الوحيد له سمة وله علامة، ونحن نذكر علامات أبواب أصحاب البدع حتى لا تخطف قلبك، وهم على اثنين وسبعين باباً، وتبحث عن الباب الوحيد الذي ينجيك لتكون عارفاً بالعلامة؛ لأن صلاح ولدك لا يكون إلا بصلاحك؛ ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، والعلماء يقولون في المناظرات لَمَّا يكون الدليل غير مستقيم يكون الاستنباط غير مستقيم. يقولون: (لا يستقيم الظل والعود أعوج). العود الذي هو: الوالد؛ لأنه هو الأصل، والظل فرع عن العود، وهو أثر من آثار العود، والعلماء كانوا يقولون: ثبت العرش ثم انقش، تريد نقشاً حسناً؟ يعني واحدٌ شَغَّال في الزخرفة، إذا أحب أن يزخرف لوحة لا يضعها على سطح الماء ويزخرف، سطح الماء مُهْتَز، فلا يستطيع الزخرفة.
إذاً: حتى يزخرف لابد أن يثبت العرش. يعني: يثبت مكان اللوح، فكأنهم يقولون بهذا المثال: إذا أردت أثراً جيداً فثبت الأصل.
إذا: الأصل الوالد، والولد هو الأثر، فلا يكون مستقيماً إلا باستقامة الوالد.
إذاً: الهدى والضلال بضاعتان في سوق الحياة، فأنت إذا دخلت السوق انظر كيف تختار.
واعلم أن الطريق الحق من (ما عليه اليوم أنا وأصحابي).
إذاً: دراسة مذهب القرن الأول صار فرضاً وهو العلامة الوحيدة للباب الوحيد: (ما عليه اليوم أنا وأصحابي).
وهذا مترجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) وإن كان لفظ: (ما عليه اليوم أنا وأصحابي) أوسع في الدلالة من حديث الخلفاء الراشدين، لأن حديث (أنا وأصحابي) يشمل التأسي بالصحابة جميعاً.
إذاً: معرفة مذهب القرن الأول صار ضرورة فلننظر: كيف كان اعتقادهم؟ كيف كان سلوكهم؟ كيف كان فقههم؟ هذه مسائل ضرورية إذا كنا نريد النجاة.
يا ليت الأبواب مفتحة بغير دعاة يدعون إليها، لهان الخطب إذَاً؛ لكن في بعض فترات الحياة قد يكون داعي البدعة أشد لساناً وأبسط وأقوى حجة من داعي الحق. يعني: من عدة سنوات كان صوت العلمانيين قوياً جداً، أما اليوم فرءوس العلمانيين يتساقطون الآن ويموتون، أما في سنة (1960م) وقبلها وبعدها، كان هذا العصر الذهبي لدعاة العلمانية ، قمة الذروة بالنسبة لهم، أما الآن فبدءوا يتساقطون.
لكن... لماذا برز هؤلاء وظهروا؟
لضعف لسان أهل الحق في ذلك الزمان، مع قوة لسان أهل البدع.
وأعظم بلية تبتلى بها الجماهير، أنه لا يوجد علماء يدلونهم على الطريق، كم من الذين ماتوا وهم يعتقدون أن العلمانية هي الدين الحق، ماتوا قبل أن يصل إليهم -أو يصلوا إلى- دعاة الهدى.
فمحنة عدم وجود العالِم تعم الجماهير، إذ قد يموت الرجل ضالاً لا يعرف الهدى؛ لأنه لم ينتصب له رجل يقول: الطريق من هنا.
إذاً: حاجة الجماهير إلى العالِم أعظم من حاجتهم إلى الطبيب، وأعظم من حاجتهم إلى لقمة الخبز.
هذه الأبواب الثلاثة والسبعون، مرةًَ تجد على باب البدعة شخصاً ضعيفاً لا يستطيع أن يضبط الحجة، ومرةً تجده رجلاً قوياً، وباب الحق عليه رجل ضعيف، لا يضبط الحجة.
فلو أن هذه الأبواب فارغة ليس عليها أحد لهان الخطب، فإذا تزامن أن يكون داعي البدعة في غاية القوة وحجتُه قوية، وقابَلَه ضعف علماء السنة فالخطب حينئذ يكون أشد.
ومن السمت الذي يخطف به المبتدعةُ القلوبَ -كما قلتُ- التجافي عن دار الغرور، والسمت يسبق الكلام -كما قلنا قبل ذلك- سمت الإنسان وشكله يسبق لسانه، أحياناً ترى إنساناً فتعجبك هيئته، وترى عليه أمارات الصلاح ولما تسمع منه شيئاً، وقد يكون كما ظننت وقد يكون على خلاف ما ظنننت.
وأنتم تعرفون طائفة السيخ الذين هم أذل الخلق، عباد العجول، الذين أخذوا المسجد وحولوه إلى معبد، ونحن ألف مليون لم تتقدم دولة باحتجاج رسمي إلى الهند: كيف حولتم المسجد إلى معبد؟ هؤلاء السيخ من علاماتهم طول اللحية وإعفائها، تلقى الواحد منهم لحيته ثلاث أو أربع قبضات، ويلبسون عمامةً، فلو رأيتَه وليس مكتوباً تحت صورته شيئاً ستقول: سبحان الله! كأنه واحد من الصحابة، شكله جميل وفيه رجولة.
وهذا الرجل السيخي -إذا جازت النسبة- لو جاء ووقف أمام المسجد ورأيت عليه عمامة، ولفت نظرك لحية عظيمة، فلو وقف وجعل يفرك في يده، فإنك تظنه يسبح مثلاً، فصورته تخطف القلب، فتأتي فتقول -فأنت تريد أن تتعرف على هذا الإنسان-: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالِم من أين؟ لكن... ما الذي جعلك تقبل عليه؟ شكله وسمته، قبل أن ينطق لسانه وتصور لو أنك ذهبت معه ووجدتما شخصاً يقود عجلاً فأول ما يرى العجل يخر راكعاً! ماذا يكون رد فعلك؟! صدمة لا توصف.
ولذلك التربية تكون قبل التعليم؛ من أجل هذا نحن نوصي أنفسنا وإخواننا في الله تبارك وتعالى المتصدرين لتعليم الجماهير أن لا يتدنى ولا يتبسط مع الجماهير، والشيء المباح الذي قد يفعله في خلوته لا يفعله في جلوته، لماذا؟ لأن السمت والشكل يُعلِّم.
قال بعض العلماء لابنه: (يا بني! اذهب إلى جعفر الصادق ، وتعلم من سمته وشكله كما تتعلم من علمه)، فكان الواحد إذا ذهب يتعلم من شيخ ينظر إليه كيف يضحك! كيف يبكي! إذا نزل عليه خبر كالصاعقة ماذا يقول! إذا جاءه خبر مفرح، ماذا يقول! ينظر إلى علامات وجهه، ويتعلم منه.
فالسمت سباق، وهذا السمت هو الذي غر الخليفة المنصور في رجل من رءوس البدعة، جمع بين الاعتزال والتجهم ، أعوذ بالله من الضلال البعيد، وكان اسمه عمرو بن عبيد ، فكان المنصور يخضع لفرط زهده وتجافيه عن الدنيا، فكان إذا رآه يقول:
كلكم يمشي رويـد كلكم طالب صيـد
غير عمرو بن عبيد
فقد كان زاهداً في أموال السلاطين، وزاهداً في القرب من السلاطين، والمنصور يبعث إليه ولا يأتي، يهرب منه، فأعجبه هذا الزهد والسمت، فقد يكون على باب البدعة من هذه الأبواب عمرو بن عبيد ، أو خليفة عمرو بن عبيد ، رجل قوي اللسان، عنده حسن عرض للشبهات، والشبهة السقيمة في زمان الجهل تكون عملاقة، مثل الإنسان الغير كفء، في غياب الأكابر يصير عملاقاً، فكذلك الشبهة التافهة في زمان الجهل تكون دليلاً.
أي: لو أن شخصاً سرق مائة وخمسين جنيهاً تقطع يده.
إذا دخل الرجل مع آخر في عراك فأخذ أحدهما السكين وقطع يد الآخر، فإنه يغرم الدية، فكل إصبع ديتها عشر جمال، وسيدفع ألوفاً مؤلفة. أما أبو العلاء المعري فقد اصطاد هذه النقطة، وقال:
يد بخمسين مئينٍ عسجد وُديَـت ما بالها قطعت في ربع دينار
أي: يد غالية. عندما يعتدي عليها أحدٌ تكون ديتها ألوفاً مؤلفة، وإذا سرقت مائةً وخمسين جنيهاً يقطعونها، ما هذا التناقض؟!
يد بخمس مئين عسجدٍ وُدِيَتْ ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقض ما لنا إلا السكوتُ له وأن نعوذ بمولانا من النـار
أي: يريد أن يقول: هذا تناقض ولكن الله هكذا أنزلها فسلم بذلك، فرد عليه الفقهاء لما بلغتهم المقالة وطلبوه ليقتلوه فهرب، ومن ضمن ما رُد به عليه مقولة جميلة للقاضي عبد الوهاب المالكي ، وكان من أعيان المالكية ومن فحول العلماء المحققين، قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. انظر: سطر أو نصف سطر، كلمة ونصف. وهذه الشبهة لو ألقيت اليوم لكتب عليها مقالات في الجرائد والمجلات، وتصير هذه الشبهة دليلاً من الأدلة وتصير عملاقةً في زمان الجهل.
وكأنها تظن أن الجنة والنار داخلة ضمن صلاحيات المرأة، وأنها تتدخل في حرية المرأة.
وهي معترضة على حديث البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي النساء في يوم عيد فوعظهن وقال: (يا معشر النساء! تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة من وسط النساء. فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير) يعني: تظل تلعن في زوجها وتشتم فيه، وتكفر بجميله، يطعمها ويسقيها ويحسن إليها، ومع ذلك أول ما تزعل منه تقول له: ما رأيت منك خيراً قط، وبذلك تدخل جهنم والعياذ بالله.
فالمرأة كَبُر عليها قوله: (رأيتكن أكثر أهل النار) فقامت تعترض، تقول: أكثر أهل النار لماذا؟ هن قاعدات مع البصل والثوم في المطبخ، وتربية الأولاد. وتقول: من هم الذين صنعوا القنبلة الذرية؟! الرجال أم النساء؟ من هم الذين صنعوا الصواريخ عابرات القارات، يكون أحدهم جالساً يشرب فيضغط على زر، فيدمر مدينةً؟! أهم الرجال أم النساء؟ من هم الذين صنعوا أسلحة الدمار الشامل؟ من هم الذين ظلوا يخططون للحرب الشاملة الضروس في كل مكان في العالم؟ هم الرجال، إذاً: هم الذين يدخلون جهنم وليس نحن.
هذا خلاصة اعتراض تلكم المرأة، وهي لكي تضع الصبغة العلمية على الكلام قالت أيضاً: لكي نبين أننا لا نتكلم من منطلق العاطفة، سنجيء بكلام علماء الحديث، فـابن الجوزي يقول: إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن، وهذا ليس معناه أن كل ما في صحيح البخاري يكون صحيحاً، فمن الممكن أن يكون في صحيح البخاري وهو موضوع وكذب، وأمارة الكذب في الحديث -حسب زعمها- أن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم الرءوف يجيء إليهن في يوم عيد ويقول لهن: أنتن في جهنم وبئس المصير، بدلاً من أن يفرحهن ينكد عليهن، ويقول لهن: أنتن أكثر أهل النار! فهل هذا يليق بذوقه عليه الصلاة والسلام؟!
فتقول: المتن منكر، وإن كان السند من رواية: مالك عن نافع عن ابن عمر ، لكن المتن منكر، لا يمكن أن نقبله!
أيضاً تقول تلكم المرأة: رجم الزاني المحصن -هو حكم الله عز وجل-.
وتقول: هل الحيوان أغلى على الله من المسلم الموحد؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) أي: لا تجيء بسكين مثلوم وتظل تذبح الخروف، حرام عليك، بل لابد أن يكون السكين حاداً ماضياً لتنتهي من ذبحه بسرعة لماذا؟ لكي لا تعذب الحيوان.
فتأتي هذه المرأة وتقول: هذا في الحيوان فكيف يرجم الزاني، ويظل يعذب ويتألم من الحجارة؟!
إذ كان الحيوان يقول الرسول فيه: (فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)، فلماذا تأخذون في تعذيب ابن آدم هذا؟!
أتكون البهيمة العجماء أقرب إلى أن ترحم من الإنسان الموحد؟!
ولكنه ورغم أنفها حكم لله عز وجل -ولكن- في زمان الجهل تصير هذه الشبهة عملاقة، وتصير دليلاً. لماذا؟ لأن أصحاب الحق أضاعوا صوتهم وأقلامهم.
لكن في زمان العلم كل الشبهات تتضاءل، بل الأحكام التي لا تقوم على فهم صحيح تتساقط أيضاً، مهما كان حجم قائلها.
ونحن نجيب على هذا الاعتراض ونقول:
إن الله عز وجل شرع الأحكام للمصالح، ولذلك الإنسان إذا عرض له حكم لا يفهم له معنى يقول: الله له حكمة في ذلك، وأفعال الله عز وجل لا تخلو من الحكمة أبداً، فكل فعل له حكمة سواء جلَّت عن أفهام العباد أو عرفوها.
حسناً! الحيوان الأعجم -وربنا سبحانه وتعالى خلق حيواناً أعجم لك لتأكله- ما الحكمة في تعذيبه؟! ما هي الحكمة من تعذيب الحيوان، وأنت ستذبحه لتأكله؟! إذاً: لا حكمة على الإطلاق، فيتنزه حكم الله عز وجل أن يثبت العذاب للحيوان الذي يذبح، إذ أنه يخلو تماماً من الحكمة.
أما الزاني الذي يضرب بالحجارة! وربنا سبحانه وتعالى قال في الحد: ![]() وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ![]() [النور:2]، مع أن الأصل الستر على المسلم، وعلى أصحاب العصيان، هذا هو الأصل في الشريعة: (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)، وقال صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين، قالوا: ومَن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذين عصوا الله عز وجل فسترهم؛ فأصبحوا يهتكون ستر الله)، فيكون بهذا مستحقاً للتعذيب؛ لأنه كشف الستر، والذي كان من المفروض أنه يتركه مُغَطًّى.
[النور:2]، مع أن الأصل الستر على المسلم، وعلى أصحاب العصيان، هذا هو الأصل في الشريعة: (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)، وقال صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين، قالوا: ومَن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذين عصوا الله عز وجل فسترهم؛ فأصبحوا يهتكون ستر الله)، فيكون بهذا مستحقاً للتعذيب؛ لأنه كشف الستر، والذي كان من المفروض أنه يتركه مُغَطًّى.
الأدلة متكاثرة على أن الأصل أن تستر على أصحاب العصيان، إلا إذا أنضاف إلى ذلك شيءٌ آخر يوجب عليك أن تظهر هذه المعصية.
فإذا كان هذا هو الأصل وهو الستر، فربنا سبحانه وتعالى أمر بالفضيحة التي هي خلاف الأصل!
لماذا؟
حتى إذا نظر الرجلُ ورأى الزاني يُجلد أو يرجم فهذه فضيحة ويقول: كنا نظنه مُتَّزِناً ومستقيماً، فظهر بخلاف ذلك فيسقط من أعين الناس، والذين يشهدون هذا العذاب يعتبرونه بهذه الفضيحة وهذا العقاب فيكون رادعاً لهم عن اقتراف المحرمات.
قال الله عز وجل: ![]() وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ![]() [النور:2].
[النور:2].
ففضيحة المرأة الزانية جزءٌ أراده الشارع، ولا تقل: أنا أستر عليها، فإنه لا يجوز الستر هنا، كما قال الله عز وجل: ![]() وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ![]() [النور:2]، لا تنقل أحاديث الستر إلى أهل العصيان، ثم لا تقل: إن الإجهاض جائز أيضاً. لماذا؟
[النور:2]، لا تنقل أحاديث الستر إلى أهل العصيان، ثم لا تقل: إن الإجهاض جائز أيضاً. لماذا؟
لأن العلماء يقولون: إن الرخص لا تُناط بالمعاصي، والأصل بقاء الحمل -الجنين- حتى تلد.
إذاً: المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا حملت فقال أهل الطب: إن في حملها خطراً عليها، وعملوا بذلك تقريراً؛ تقف مقالة أهل الطب عند هذا الحد، ولا يجوز للطبيب أن يقول لها: أسقطي الحمل، فالطبيب يرفع التقرير إلى المفتي فقط، وليس شرطاً أن يكون مفتي الديار، بل إلى من له حق في الإفتاء، فالمفتي يقرأ هذا التقرير، ثم يقول: جائز شرعاً أن تُسْقِط، وإلا فلا يحل للطبيب أن يقول: جائز شرعاً أن تسقط.
إذاً: الطبيب يعمل تقريراً ويرفعه للجهات المختصة صاحبة القرار، وهو الفقيه الذي يقول: جائز شرعاً أن تُسْقِط.
فلما كانت المرأة حملت حملاً حلالاً جاز لها أن تستمتع بالرخصة؛ إذ الرخص لا تناط بالمعاصي؛ لأن الرخصة معناها توسعة وتسهيل، فكيف نسهل على أصحاب العصيان معاصيهم، يعني: لو أن شخصاً مثلاً مسافر لكي يذهب إلى المصيف، فيقول ماذا؟ هيا لنقصر الصلاة. فنقول له: لا. يا أخي! قصر الصلاة تكون في سفر المباح أو المشروع، وسفرك سفر معصية، فلا يحل لك أن تستمتع بالرخص، والرخصة هذه لعباد الله الطائعين؛ بينما أهل المعصية لا يستمتعون بالرخص.
فالرخصة تناط بالطاعات ولا تناط بالمعاصي، وقد تفرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا القاعدة وهي أنه لا يجوز للمسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصُر الصلاة، وأفتى أن شد الرحل إلى القبر معصية، إنما السنة والمستحب أن تشد الرحل إلى المسجد وليس إلى القبر، كما هو نص الحديث، وقال للذين عارضوه وقاموا عليه: أمهلتُ كلَّ مَن خالَفَني سَنَةً أن يأتيَني بحرف عن الصحابة والتابعين يخالف ما أقول.
وكان رحمه الله إماماً متضلعاً كالبحر الهادر إذا تكلم. ومعاصرونا من المبتدعة شنعوا وقالوا: السلفيون يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل لهم لماذا؟ قالوا: لأن هؤلاء يقولون: لا تزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
لا. والله، بل هذا كان مذهب القرون الفاضلة، كان الواحد منهم إذا أراد أن يشد الرحل شده إلى المسجد ومِن ثَمَّ يزور، فزيارة القبر متحققة بزيارة المسجد؛ لكن نيتُك الأولى لا تكون إلا لشد الرحل إلى المسجد؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) ونفي الاستثناء من أقوى صيغ الحظر.
إذاً: فضيحة المرأة الزانية بجلدها أو رجمها جزءٌ أراده الشارع.
وبهذا ذَهَبَ قولُ تلك المرأة واعتراضُها كضرطة عير في فلاة، لا قيمة لها.
فهذه المحنة -محنة الأبواب الثلاثة والسبعين باباً، والموجودة أمامنا جميعاً- محنة عظيمة جسيمة، والخلاص منها طريق: (ما أنا عليه اليوم وأصحابي).
إذاً: لابد من دراسة زمن النبوة، لنعرف كيف كانوا يفقهون ويختلفون؟ وكيف كانوا يتسامرون؟
ونحن نمثل مثالاً لذلك، وربما الكثير يعرفونه:
فنقول: إن العلاقة بين الواقع والمثال مثل الهرم أو مثل المثلث حاد الزاوية.
الواقع: الذي هو واقع المسلمين وتطبيقهم لدينهم.
المثال: الذي هو النص: قرآناً وسنةً.
الضلع الأول: الواقع.
والضلع الثاني: المثال.
طيب! النقطة التي هي رأس المثلث لا أبعاد فيها، ليس فيها طول ولا عرض، ولا مسافات، وإذا سلَّمنا أن لها مسافات فهي مسافات لا تكاد تذكر في عالم الأرقام.
نبدأ نلاحظ المسافة بين الضلعين النازلين من النقطة، فنجد أنه كلما تنزل تزداد المسافة بُعداً بين الضلعين.
فما هو المطلوب منك؟ الطلوع أم النزول؟
إذا نزلت سترى المنكر معروفاً والمعروف منكراً، وسترى الناس يدورون بين بدعة ورِدَّة.
مثلاً: رجل لا يصلي، فلما تنصحه يقول لك: يا أخي! أنا رضي الله عني! يوجد من الناس من يزني، وفلان يسرق، وفلان يرتشي، وفلان يأكل الربا... إلخ.
أو أن تجد شخصاً يسبح -مثلاً- على المسبحة فتقول له: يا أخي! التسبيح بالأنامل أولى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (اعقدن التسبيح بالأنامل؛ فإنهن مسئولات مستنطقات)، فيقول لك: رضي الله عني، فالناس غافلون عن هذا وهم سادرون في غيهم؛ في الملاهي والمقاهي!
مع أن المسبحة كانت منكرة عند السلف رضوان الله عليهم.
كلما نزلت إلى تحت ترى تدنياً، فأصبح من هذا حالهم يتأسون بالشر، مع أنه لا أسوة في الشر، يعني: الموظف الذي اختلس مائة ألف، ومسكوه أمام المحكمة وحاكموه، يقول: وما هي المائة ألف هذه؟ هناك شخص أخذ أربعة ملايين.
فانظر: المقارنة.. هل تقبل منه؟!
لكن.. الصحابة لم يكونوا هكذا، والصحابة مثالهم عالٍ رفيع، وإنما يحصل نوع من التدني في الأسوة كلما نزلت إلى تحت.
إذاً: حتى تنجو أنتَ وينجو أولادك اطلع إلى فوق، وماذا يعني تطلع إلى فوق؟
فلنضرب لهذا مثلاً: وهو المثلث فهذه النقطة التي في الأعلى هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبعاد فيها، ولا اختلافات.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة) جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نظروا إلى الخطاب، وقالوا: هناك مفهوم ومنطوق، فالمنطوق وهو ظاهر الكلام: (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة) إذاً: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، حتى ولو لم ندخل إلا بعد العشاء، وجماعة أخرى قالوا: لا. نحن عندنا الأصل: ![]() إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً
إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ![]() [النساء:103]، فلا يحل إخراج الصلاة عن وقتها، وإلا ضيعنا الآية، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقصد أننا نجد ونجتهد، وليس معناه أننا نؤخر الصلاة، وإنما المقصود المبادرة، وكلا الفَهمين سائغ على المنطوق والمفهوم.
[النساء:103]، فلا يحل إخراج الصلاة عن وقتها، وإلا ضيعنا الآية، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقصد أننا نجد ونجتهد، وليس معناه أننا نؤخر الصلاة، وإنما المقصود المبادرة، وكلا الفَهمين سائغ على المنطوق والمفهوم.
ولكنهم رضي الله عنهم -عندما اختلفوا- لم يتنازعوا ولم يكفر بعضهم بعضاً، ولم يتفرقوا.
ثم مضت الغزوة ودخلوا بني قريظة، والذي صلى في الطريق صلى، والذي أجَّل الصلاة أجَّل.
وبعد ذلك لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حَكَوا له الخلاف، قال الراوي: (فلم يعِبْ على أحد).
ورُبَّ شخص يقول: معنى ذلك أن الحق يتعدد، أي: لا يكون طرف منهم قد أخطأ.
ويقول آخر: لا يمكن أن يكون الحق شيئاً وضدَّه أبداً، فالذين صلوا إما محقون أو مخطئون، والذين تركوا الصلاة وأجَّلوها إما مخطئون وإما محقون، والحق لا يكون إلا واحداً، ولا يكون ضدين أبداً.
فنقول: إن كَوْن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعِبْ ليس معناه أن كليهما حق في نفس الأمر؛ لكن معناه أن المخطئ اجتهد، وأفرغ الوُسْع في طلب الحق، فكيف يُلامُ مَن أفرغ الوسع في طلب الحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد)، أَيُذَمُّ مَن أصاب أجراً؟! لا يَذُمُّ مَن أصاب أجراً واحداً؛ لأن الحق واحد فقط، فالذي أصاب الحق أصابه، والذي لم يصب الحق أصاب أجراً واحداً، فليس من اللائق أن يُعَنَّف مَن أصاب أجراً واحداً.
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنِّف، وليس معنى هذا أن كلا القولين حق.
وقد ورد الحديث برواية أخرى فيه: (إن سيد الحي سليم)، وسليم بمعنى لديغ، وهي في الأصل لا تعني اللدغ، ولكن العرب يقولون (سليم) تفاؤلاً بالسلامة.
كما أن القافلة هي التي قَفَلَت أي: رجعت؛ أما التي غادرت لا يقال لها: قافلة، إنما يقال: قَفَل إذا رجع، فَهُم يقولون: خَرَجَت القافلة مع أنه في الأصل لا يقال قافلاً إلا لمن كان راجعاً، فسميت قافلة؛ رجاء رجوعها.
والصحراء سميت مفازة تيمناً بالفوز منها؛ لأن الذي يضل فيها يموت.
والرواية التي عند البخاري ومسلم لم توضح مَن الراقي؛ لكن وقع في سنن النسائي وأبي داود أن أبا سعيد قال: (فانطلقت إليه فجعلت أبصق وأقرأ: الحمد لله رب العالمين).
فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم القطيع من الغنم وانطلقوا إلى رسول الله ليسألوه أيحل لهم أم لا؟ -هذا هو الجيل الذي نريدكم أن تتأسوا به، فال يحركون ساكناً ولا يسكنون متحركاً إلا إذا كان مأذوناً لهم، هذا هو معنى العبودية: أنك قبل أن تفعل الشيء اسأل فيه؛ ما حكم الله ورسوله؟ هذا هو حق الإسلام عليك، حق الالتزام- قال: لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا وجاءوا بالغنم، وحدثوا النبي بما جرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: (وما أدراك أنها رُقْية؟ -ما الذي عرَّفك؟ هو لا يعرف شيئاً عنها، وهذه كانت أول مرة له يرقي فيها- قال: يا رسول الله! شيءٌ أُلْقِي في روعي).
من أجل هذا تجد أحياناً شخصاً يدعوك ويقول لك: تعال ارقِ، فتقول له: أنا ما جربت هذه المسألة، وما عملتها قبل هذا!
يا أخي! قد يجعل ربُّنا سبحانه وتعالى على يدك الشفاء. فهذا أبو سعيد الخدري لم يكن يعرف شيئاً، ولم يجربها قبل هذا في عمره، ولما اختار الفاتحة اختارها هكذا من أجل شيء وقع في صدره. (قال: شيءٌ أُلْقِي في روعي، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- حتى يبين لهم أنها حلال قال: اضربوا لي معكم بسهم)، وما قال له: حلال. وسكت؛ لأن هذه أقوى من مجرد القول فالرسول عليه الصلاة والسلام قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالاً لأصحابه، لكن أنه يأكل هذا من أقوى أدلة الجواز والإباحة.
فهذه الخلافات كانت موجودة.
أعني مثلاً: لو أن هذا حصل في زماننا، فمن الممكن أن واحداً منهم يقول: انظروا إلى الأَثَرَة! انظروا إلى الأنانية! أنا كنتُ أظنه (أَخَاً في الله)، فظَهَرَ (فَخَّا ليس في الله)! فهذه أَثَرَةٌ وأنانية، وأخذ الغنم عنده، ولا يريد أن يعطينا منها.
فيحصل الحقد.
لكنهم قالوا: (ليس قبل أن نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفتينا في المسألة).
فهناك خلافات فرقت بين الإخوان أدنى من هذا مائة مرة، وإذا اختلف مع أخيه تجده لا يصلي في المسجد الذي يصلي فيه، ولا يقابله في الشارع وإذا لقيه تجده يجري؛ من أجل خلاف تافه حقير لا قيمة له ولا واقع.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
 البث المباشر
البث المباشر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
12815
قراءة متن الشاطبية
مشاري راشد العفاسي -
10874
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
4730
قصص الأنبياء - قصة ابراهيم في فلسطين وبناء الكعبة - قصة اسماعيل واسحاق- قصة قوم لوط
طارق السويدان -
4328
منظومة عشرة الإخوان
توفيق سعيد الصائغ -
2788
قصة آدم عليه السلام
نبيل العوضي -
2678
سلسلة السيرة النبوية من الظلمات إلى النور
راغب السرجاني -
2318
الرقية الشرعية - مشاري راشد العفاسي
-
2248
متن الدرة المضية__عثمان المسيمي
عثمان المسيمي -
2047
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي -
2040
عمر بن الخطاب
بدر بن نادر المشاري

عدد مرات الاستماع
3086718663

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك