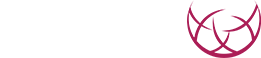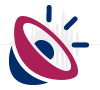 الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- عبد الله بن محمد الغنيمان
- سلسلة شرح كتاب التوحيد
- شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد [66]
[ باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ].
المراد بجناب التوحيد جوانبه التي قد يدخل منها الشرك، أو شيء من أنواع الشرك، والحماية هي الصيانة والاعتناء، بأن يمنع كل وسيلة قد تكون موصلة إلى ما لا يجوز، وهذا شيء كثر ذكره في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بعضه، ولكن أراد المؤلف أن يبين في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك اعتناء تاماً، واستدل على هذا بأمور متعددة:
منها ما ذكره الله عنه من رأفته ورحمته وحرصه على هداية الناس، ومنها نصوص تدل على أنه صلى الله عليه وسلم صان توحيد عبادة الله جل وعلا أن يتلبس به بعض أمراض القلوب أو أمراض الشكوك، فأصبح الأمر واضحاً جلياً، ولا عذر لمن وقع في خلاف ذلك.
والمقصود من هذا أن يبين ما عليه كثير من الناس ممن يزعم مشروعية التعلق بالأموات ، والتبرك بالقبور والبقع، والتوسل بالأحياء أو الأموات؛ التوسل الذي يعرفه المتأخرون ويصطلحون عليه، لا التوسل الذي ذكره جل وعلا في كتابه، وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سننه فإنه نوع آخر غير التوسل الذي اصطلح عليه المتأخرون، فهذا الذي اصطلح عليه المتأخرون هو أن يجعل المخلوق وسيلة بذاته إلى الله، بأن يجعل جاهه وعمله الزاكي عند الله ينفع به هذا المتوسل، أو يقسم به على الله، وما أشبه ذلك من معاني المتأخرين الذين ما عرفوا حقيقة التوسل الذي جاء في الكتاب والسنة، فلا عذر لهم في ذلك؛ لأنهم تركوا ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، واتبعوا أهواءهم في ذلك؛ ولهذا تجد كثيراً من الناس يترك النصوص الواضحة الظاهرة ويتعلق بشبه، أو يتعلق بأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتعلق بمنامات ومرائي رآها في النوم أو رؤيت، أو يتعلق بأمور يزعم أنها مجربة، يقول: إن فلاناً دعا بكذا، وإنه ذهب إلى كذا، وحصل له كذا وكذا، وهذه كلها لا تغني شيئاً، وإنما الذي يعتمد عليه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله آمراً به أمته أو ناهياً لها أن تفعله.
هذا الذي يجب أن يؤخذ ويجب أن يعتنى به، أما ما عليه هؤلاء من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الاعتماد على الرؤى، أو الاعتماد على أقوال بعض الذين يزعمون أنهم حصل لهم ما حصل، فهذا كله لو تعلق به الإنسان فإنه غير معذور، والله سائله عما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن المرائي ولا عن فعل الناس ولا عن شيء عدا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي سيسأل عنه الإنسان، فإن الله سيسأل المتقدمين والمتأخرين: ماذا أجبتم المرسلين؟ والسؤال للتهديد، والتعذيب بعد ذلك.
فإذا كان الإنسان لم يقدم عملاً وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متبعاً قوله، منتهياً عن نهيه وإلا فهو هالك، فالحماية في هذا يقصد بها أمر زائد على الأوامر التي تأمر بالتوحيد، وتنهى عن الشرك، فهي أمور زائدة على ذلك، كالنهي عن الوسائل التي تقرب من الشرك، كالنهي عن أمور قد يفعلها الإنسان وهي جائزة ولكن قد يدخل منها إلى أمور لا تجوز، وهي التي تسمى بالوسائل والذرائع، وهذا موجود في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم بكثرة، وسيذكر الشارح شيئاً من ذلك.
هذه الآية استدل بها على صيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أن يدخل عليه شرك سواء كان دقيقاً أو صغيراً، خفياً أو جلياً.
![]() لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ![]() [التوبة:128] (رسول) علم على من أرسله الله جل وعلا برسالة، وكل أمة لها رسول، ولا يصلح الناس إلا برسول؛ ولهذا تتابعت الرسل من أول الخلق إلى آخرهم، ولكن الله ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعله رسولاً لأهل الأرض كلهم، فإذا كان رسولاً لأهل الأرض جميعاً فالخطاب هنا (لقد جاءكم) هل يكون عاماً أو يكون خاصاً لقوم معينين؟ الواقع أنه عام، ولكن الخطاب فيه للعرب؛ لأنهم أخص الناس بذلك، وهذا يقتضي أن يشكروا الله ويحمدوه على هذه النعمة العظيمة؛ لأنهم أخص من غيرهم، وإلا فغيرهم من الناس كلهم يدخل في هذا الخطاب؛ لأن الخطاب للأمة إلى يوم القيامة، والأمة التي أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا العرب فقط، بل العرب والعجم بأنواعهم والجن والإنس، كلهم مخاطبون بذلك، ولكن من كان الرسول منهم بالنسب واللغة ومعرفة المولد والمنشأ والمخرج والمدخل؛ فالنعمة عليهم أتم، والمنة عليهم أعظم، فيجب أن يشكروا الله جل وعلا أكثر من غيرهم.
[التوبة:128] (رسول) علم على من أرسله الله جل وعلا برسالة، وكل أمة لها رسول، ولا يصلح الناس إلا برسول؛ ولهذا تتابعت الرسل من أول الخلق إلى آخرهم، ولكن الله ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعله رسولاً لأهل الأرض كلهم، فإذا كان رسولاً لأهل الأرض جميعاً فالخطاب هنا (لقد جاءكم) هل يكون عاماً أو يكون خاصاً لقوم معينين؟ الواقع أنه عام، ولكن الخطاب فيه للعرب؛ لأنهم أخص الناس بذلك، وهذا يقتضي أن يشكروا الله ويحمدوه على هذه النعمة العظيمة؛ لأنهم أخص من غيرهم، وإلا فغيرهم من الناس كلهم يدخل في هذا الخطاب؛ لأن الخطاب للأمة إلى يوم القيامة، والأمة التي أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا العرب فقط، بل العرب والعجم بأنواعهم والجن والإنس، كلهم مخاطبون بذلك، ولكن من كان الرسول منهم بالنسب واللغة ومعرفة المولد والمنشأ والمخرج والمدخل؛ فالنعمة عليهم أتم، والمنة عليهم أعظم، فيجب أن يشكروا الله جل وعلا أكثر من غيرهم.
![]() مِنْ أَنفُسِكُمْ
مِنْ أَنفُسِكُمْ ![]() يعني: من جنسكم، يخاطبكم بلغتكم، تعرفون نسبه، وترجعون أنتم وهو إلى أب واحد وهو إسماعيل عليه السلام، وهذا استجابة من الله لدعاء إبراهيم عليه السلام:
يعني: من جنسكم، يخاطبكم بلغتكم، تعرفون نسبه، وترجعون أنتم وهو إلى أب واحد وهو إسماعيل عليه السلام، وهذا استجابة من الله لدعاء إبراهيم عليه السلام: ![]() رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ![]() [البقرة:129] فبعث منهم الرسول، فامتن الله جل وعلا عليهم بذلك، (من أنفسكم) يعني: أنه من جنسكم تعرفون لغته، وتعرفون أمانته وصدقه، فمن كان كذلك كانت المنة عليه أعظم، فيجب أن يشكر الله، أما إذا انعكست القضية وقابلوا هذه المنة العظيمة بالرد والنفور عنها، والتكذيب والكفران لها؛ فإن العذاب عليهم يكون أشد من غيرهم ممن لا يعرف هذه الأمور.
[البقرة:129] فبعث منهم الرسول، فامتن الله جل وعلا عليهم بذلك، (من أنفسكم) يعني: أنه من جنسكم تعرفون لغته، وتعرفون أمانته وصدقه، فمن كان كذلك كانت المنة عليه أعظم، فيجب أن يشكر الله، أما إذا انعكست القضية وقابلوا هذه المنة العظيمة بالرد والنفور عنها، والتكذيب والكفران لها؛ فإن العذاب عليهم يكون أشد من غيرهم ممن لا يعرف هذه الأمور.
ومن المعلوم أن الله جل وعلا عذب الأمم التي كذبت الرسل، وقص الله جل وعلا ذلك علينا، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه فضل بعض الرسل على بعض، وقد علم أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل الرسل، ومن المعلوم أن من كذب أفضل الرسل يكون عذابه أشد ممن كذب من هو دونه؛ لأن الفضل لا بد أن يأتي بزيادة بيان وزيادة إيضاح وزيادة حجة، بحيث يصبح الإنسان لا عذر له بوجه من الوجوه، فيكون مصادماً تمام المصادمة لما جاء به، فيكون عذابه أشد.
وقوله: (حريص عليكم) يعني: حريص على إيمانكم، وعلى طاعتكم، وعلى ما ينفعكم؛ ولهذا نهاه الله جل وعلا أن يحزن وأن يأسف الأسف الذي يعود عليه بالضرر، فقد كاد يهلك نفسه حرصاً على إيمانهم، فنهاه ربه جل وعلا عن شدة حرصه عليهم، وتأسفه على عدم إيمانهم، وأخبره جل وعلا أن ما عليه إلا البلاغ المبين، وهذا يكفي.
معنى قوله: (عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم)
( حريص عليكم ) أي: حريص على هدايتكم ( بالمؤمنين رءوف رحيم ) ورأفته ورحمته بهم أن ينالهم عذاب الله أشد وأعظم من رأفته ورحمته بهم أن ينالهم شيء من أمور الدنيا المؤذية، فتضاعف رأفته ورحمته بأن يبين لهم الطريق الذي يسلكونه ويسلمون به من عذاب الله الأخروي، ومن مقتضى ذلك أن ينهاهم عن كل طريق يوصل بهم إلى ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه.
والرأفة شدة الرحمة، فهي أبلغ من الرحمة، (رءوف) يعني: أنه وصل الغاية في رحمتهم، رءوف بالمؤمنين ورحيم بهم، وتقديم المعمول يدل على الاختصاص، أي: أن رأفته ورحمته بالمؤمنين فقط، وأما الكافرون فهو غليظ وشديد عليهم كما وصفه الله جل وعلا في قوله: ![]() مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ![]() [الفتح:29]، وقال جل وعلا في أمره بذلك:
[الفتح:29]، وقال جل وعلا في أمره بذلك: ![]() يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ![]() [التوبة:73] أمره أن يغلظ عليهم؛ ولهذا كان ممتثلاً لذلك، فرأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه هي بالمؤمنين فقط، أما الكافرون فهو قتّال لهم، وشديد عليهم؛ ولهذا جاء في صفته في الكتب السابقة ( الضّحاك القتّال ) صلوات الله وسلامه عليه، يعني: ضحاك للمؤمنين، قتّال للكافرين، والمؤمن يجب أن يكون متحلياً بحلته، ومتصفاً بصفته، فإنه قدوته صلوات الله وسلامه عليه.
[التوبة:73] أمره أن يغلظ عليهم؛ ولهذا كان ممتثلاً لذلك، فرأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه هي بالمؤمنين فقط، أما الكافرون فهو قتّال لهم، وشديد عليهم؛ ولهذا جاء في صفته في الكتب السابقة ( الضّحاك القتّال ) صلوات الله وسلامه عليه، يعني: ضحاك للمؤمنين، قتّال للكافرين، والمؤمن يجب أن يكون متحلياً بحلته، ومتصفاً بصفته، فإنه قدوته صلوات الله وسلامه عليه.
معنى قوله: (فإن تولوا فقل حسبي الله)
وجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، وهو أن الله جل وعلا وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفعنا، فهو حريص على إيماننا، ويشق عليه الشيء الذي يعنتنا ويشق علينا؛ فلا بد أن يبين البيان الذي يكون فيه حمايتنا من الوقوع في المخالفات، ولا بد أن يحضنا الحض الذي يكفي في كون الإنسان يعبد ربه، ولا تكون العبادة لغيره بوجه من الوجوه.
النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رءوف رحيم
فهل يعقل أنه يبين هذه الأمور التي لو تركها الإنسان ما يقتضي تركه أن يعذب، ويترك الأمر الذي لو فعله الإنسان ترتب على فعله عذاب؟ هذا لا يعقل، لا بد أنه صلوات الله وسلامه عليه اعتنى بذلك، أما الذين فتنوا بعبادة نظرائهم وأمثالهم من الخلق، وصارت قلوبهم فارغة من تعظيم الله وتقديره؛ فإنهم يتلمسون ما يكون دليلاً على الشرك، ويبحثون عنه، ومن المعلوم أن الإنسان إذا فتن فإنه يعمى عن الحق، ويفتح عينيه على الباطل، ويصبح قابلاً لما يهواه، ومبغضاً لمن ينهاه عما هو فيه، غير قابل له؛ ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أننا إذا رأينا الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أن نحذرهم، وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه أنزل ![]() آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ![]() [آل عمران:7] وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها- أنه قال: (إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم) مع أن القرآن ليس فيه شيء يدل على الباطل، ولكن فيه شيء مجمل قد يحتمل أمراً باطلاً ولو من بعيد، فيتعلق به من كان مفتوناً.
[آل عمران:7] وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها- أنه قال: (إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم) مع أن القرآن ليس فيه شيء يدل على الباطل، ولكن فيه شيء مجمل قد يحتمل أمراً باطلاً ولو من بعيد، فيتعلق به من كان مفتوناً.
كما أنه جل وعلا أخبرنا أن الذي في قلبه مرض الشبهات فإن الحق لا يزيده إلا ضلالاً ويتمادى في الباطل ![]() فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ![]() [البقرة:10]،
[البقرة:10]، ![]() وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ![]() [التوبة:124-125].
[التوبة:124-125].
إذاً: من كان عنده مرض شبهة فإنه يزداد ببيان الحق وإيضاحه ضلالاً وتمادياً في باطله، وذلك أن الحجة تزداد قياماً عليه، فيستحق من العذاب أكثر؛ ولهذا تجدهم يتعلقون بأمور تافهة، وأمور واهية، بل بأحاديث مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بها إذا وجدوها، وقد يجرؤ بعضهم على تصحيحها ويقول: إنها صحيحة، وقد يجرؤ بعضهم على وضع الأسانيد لها كذباً وزوراً، فكيف مقامه أمام الله جل وعلا؟ كل ذلك لما زين في قلبه ونظره من عبادة غير الله، نسأل الله العافية! ومثل هؤلاء ليس البيان والإيضاح لهم، البيان والإيضاح يكون لمن يريد الحق، فالذي يلتبس عليه الحق وهو يريد الحق ينتفع بالإيضاح والتبيين، أما من كان قلبه ملبساً بالفتنة وقابلاً لها فإنه لا يزداد بذلك إلا غياً وتمادياً في الباطل.
الجناب: هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه.
قوله: وقول الله تعالى: ![]() لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ![]() [التوبة:128-129]
[التوبة:128-129]
قال ابن كثير رحمه الله : يقول الله تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم، أي: من جنسهم وعلى لغتهم كما قال إبراهيم عليه السلام : ![]() رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ![]() [البقرة:129]، وقال تعالى :
[البقرة:129]، وقال تعالى : ![]() لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ![]() [آل عمران:164]، وقال:
[آل عمران:164]، وقال: ![]() لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ![]() [التوبة:128] أي: منكم كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث، قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى:
[التوبة:128] أي: منكم كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث، قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: ![]() لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ![]() [التوبة:128] أي: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية ].
[التوبة:128] أي: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية ].
ليس هذا مما نصت عليه الآية، ولكن هذا من مفهومها البعيد، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه ينتهي إلى معد بن عدنان ، وهذا متفق عليه ولا خلاف في ذلك بين أهل النسب، وكذلك نسب أمه ينتهي إليه، أما ما بعد معد بن عدنان فهذا فيه خلاف لأنه بعيد، والمؤرخون اختلفوا في ذلك إلى إسماعيل بن إبراهيم، ولكن هو من ذرية إسماعيل يقيناً؛ لأن بعض العرب من ذريته.
قسم يعود إلى يعرب بن يشجب الذي ينتهي نسبه إلى هود عليه السلام، وهؤلاء هم الذين يسمون العرب العاربة. وقسم آخر ينتهي نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم، وهو أكبر ولده، وهو ابن جاريته التي وهبتها له زوجه سارة ، واسمها هاجر ، وقد وهبها لها الطاغية الذي أمر أن تدخل عليه لما قيل له: إن رجلاً دخل بلادك معه امرأة ما تصلح إلا أن تكون لك لجمالها، فأخذ إبراهيم وقال: من هذه التي معك؟ فقال: هي أختي، وعلم أنه إذا قال: هي أختي لا يتسلط عليها، لسبب لا ندري ما هو، ولو قال: إنها زوجتي لأخذها، فقال: إنها أختي، وهذه إحدى الكذبات التي يعتذر بها إبراهيم عليه السلام حين تطلب منه الشفاعة، فقال لها بعد ما رجع من عند هذا الطاغية: إنه سألني عنك، وقلت: إنك أختي، فلا تكذبيني، فإنك أختي في الإسلام، فليس اليوم مسلم غيري وغيرك.
فذهبت إليه فسألها فقالت: أنا أخته، ومع ذلك مد يده إليها، فأمُسكت يده مسكة شديدة، وكان إبراهيم يصلي ويدعو ربه ألا يسلط هذا الظالم على زوجته، فلما أمسكت يده عرف أنه بسبب ذلك، فقال لها: ادع الله أن يفك يدي ولا أنالك بأذى، فدعت الله جل وعلا ففكت يده، ثم رجع مرة ثانية ليتناولها، فأمسكت أشد من الأولى حتى صار يركض برجله الأرض من شدة ما أصابه، فقالت: اللهم إن يمت يقولون: قتلته، فدعت ألا يموت من هذا الشيء، ثم انتبه وقال: ادع الله أن يفك يدي ولا أنالك بأذى، فدعت الله جل وعلا ففك يده، فأراد مرة ثالثة فأصابه أشد من تلك، ثم بعد ذلك قال: ادع الله أن يفكني ولن أنالك بشيء، فدعت الله فدعا قومه، وقال: أخرجوها عني فإنكم جئتوني بشيطان، لم تأتوني بآدمي، وأمر أن تخدم بجارية.
ثم بعد ذلك وهبت سارة هذه الجارية لإبراهيم، وقد أعلمنا الله جل وعلا أنه بلغه الكبر ولم يولد له مولود، ثم جاءته الملائكة تبشره بغلام، ثم إن هذه الجارية حملت، فلما ولدت غارت عليها سارة زوجته، كيف تحمل وهي لم تحمل؟! فأمره الله جل وعلا أن يهاجر بها إلى مكة مع ولدها وهو صغير يرضع، فذهب بها ووضعها عند مكان البيت، ولم يكن هناك بيت؛ لأنه هو الذي بناه هو وهذا الغلام، ثم ولى راجعاً إلى الشام، ووضعها في ذلك المكان الخالي القفر، الذي ليس فيه ماء ولا أنيس ولا حسيس، ثم ولى راجعاً، وكان معها قليل من الماء وقليل من الطعام، فلما ولى راجعاً صارت تناديه: يا إبراهيم! إلى من تتركنا؟ ولا يجيبها بشيء، ولا يلتفت إليها، ولما رأت ذلك قالت له: آلله أمرك؟ فقال: نعم، عند ذلك وقفت ورجعت، وقالت: إذن لن يضيعنا الله جل وعلا.
ورجعت إلى ابنها، وصارت ترضعه حتى نفد الماء، وانتهى الطعام، فنشف ضرعها، فجاع الصبي وظمأ ثم أدركه الموت، فكرهت أن تجلس تنظر إليه وهو يموت، فنظرت فإذا أقرب مرتفع إليها هو الصفا، فذهبت وصعدت تتطلع لعلها ترى أحداً، فلما لم تر أحداً نزلت متجهة إلى المروة تبحث لعلها ترى أحداً، فعلت ذلك سبع مرات، وفي السابعة سمعت صوتاً فقالت لنفسها: صه؛ لأنها سمعته ولم تتأكد، ثم سمعته مرة أخرى فقالت: لقد أسمعت إن كان عندك غوث فأغث، فنظرت فإذا برجل واقف عند إسماعيل ابنها، فذهبت إليه فإذا هو جبريل عليه السلام، فحفر الأرض بطرف جناحه فنبع الماء من زمزم فصارت تحجر على الماء حتى لا يذهب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً) يعني: لصارت عيناً كثيرة الماء تسير، وصارت تشرب منها وترضع ابنها.
ثم جاء قوم من اليمن من جرهم، ونزلوا في أسفل الوادي، فرأوا الطير تحوم على الماء، وقالوا: عهدنا بهذا الوادي وليس فيه ماء، والطير لا بد أنها تحوم على ماء، فأرسوا واردهم يختبر لهم ذلك، فوجد الماء ووجد المرأة عنده، فاستأذنها بأن يأتوا إلى الماء، وأصابوا منها أنها تحب الأنيس، فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم فيه، يعني: تشربوا منه وليس لكم حق في أصله، فرضوا بذلك.
فكبر الصبي، وتعلم العربية منهم، ثم تزوج منهم، وكان إبراهيم يأتي كل فترة يبحث ويطالع ابنه، وماتت أم إسماعيل، وتزوج إسماعيل، فجاء مرة ولم يجده، فسأل زوجته: أين بعلك؟ فقالت: ذهب يطلب لنا الطعام، فقال: ما حالكم؟ قالت: نحن في شر، ما عندنا طعام، ولا عندنا كذا وكذا، فقال: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له: غير عتبة بابك، فلما جاء إسماعيل كأنه أحس فقال: هل أتاكم أحد؟ قالت زوجته: نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا، قال: هل أوصاكم بشيء؟ قالت: نعم، يقرؤك السلام، ويقول لك: غير عتبة بابك، فقال: أنت عتبة بابي، وذاك والدي، اذهبي إلى أهلك، ثم تزوج أخرى، فجاء إبراهيم مرة أخرى ولم يجده، ووجد الزوجة، فسألها عن حالتهم فقالت: نحن بخير، فقال: ما طعامكم؟ فقالت: اللحم، قال: وما شرابكم؟ قالت: الماء، قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، ويقولون: إن الإنسان لا يعيش على الشيئين إلا في مكة بدعوة إبراهيم عليه السلام، فقال لها: إذا جاء بعلك فاقرئيه السلام، وقولي له: أمسك عتبة بابك، فلما جاء أحس فسأل: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم، شيخ صفته كذا وكذا، فقال: هل أوصاكم بشيء؟ فقالت: نعم. يقرؤك السلام ويقول لك : أمسك عتبة بابك، فقال: ذاك أبي وأنت عتبة بابي، ثم جاء مرة أخرى فوجده تحت شجرة يبري له نبلاً، فاعتنقه وصنع معه ما يصنع الوالد مع ولده إذا لقيه بعد غيبة ، ثم قال له: إن الله أمرني أن أبني هنا بيتاً، فهل أنت مساعدي؟ قال: نعم، فبدأ ببناء البيت، كما قال الله جل وعلا: ![]() وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ..
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ.. ![]() [البقرة:127-128] إلى آخر القصة.
[البقرة:127-128] إلى آخر القصة.
أما قضية الذبح فإنها كانت قبل هذا، وكانت بمكة، وسارة لم تأت إلى مكة، كان مقرها الشام؛ ولهذا كان القول بأن الذبيح إسحاق قول باطل بعيد عن الصواب، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن الكبش الذي فدي به إسماعيل موجود في الكعبة معلق فيها، وهذا شيء يعرفه المؤرخون.
قصة دخول بني إسرائيل مصر
ثم بعد ذلك مكنه الله جل وعلا، وجعله وزيراً للمالية على ما نتعارف عليه اليوم، وصارت أمور مصر تحت يده بعدما أصابهم ما أصابهم من القحط، وجاء إخوته يبحثون عن الطعام، فعرفهم وهم له منكرون، فسألهم عن حالهم وعن أبيهم وقال: هل لكم من أخ؟ قالوا: نعم، وذكروا عنه ما لا يرضى، وهو أخوه من أمه وأبيه، ولكن أم هؤلاء غير أم يوسف وأم أخيه، فقال لهم: ائتوني بأخيكم من أبيكم حتى أوفي لكم الكيل وأزيدكم، وإن لم تأتوني به فلن يحصل لكم كيل، ثم أمر غلمانه أن يجعلوا الأثمان التي اشتروا بها الطعام في رحالهم، حتى إذا رجعوا وعرفوها لزمهم الرجوع لأداء الحق؛ لأنهم لم يتركوا ذلك.
ثم لما جاءوا جعل المكيال الذي يكيل به في رحل أخيه، ثم أمر مؤذن أن يؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا: ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فقال: ما جزاؤه إذا تبين لنا كذبه؟ قالوا: جزاؤه من وجدت معه السرقة هو لك، فأمر أن يبدأ بتفتيش رحالهم أولاً، ثم استخرجها من رحل أخيه، عند ذلك أصبحوا مستسلمين لهذا الأمر.
ثم بعد هذا لما رجعوا إلى أبيهم قالوا: ![]() إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا
إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ![]() [يوسف:81] فقال لهم: لم يسرق ولكن
[يوسف:81] فقال لهم: لم يسرق ولكن ![]() سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا
سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ![]() [يوسف:18]؛ لأنه ظن أنهم فعلوا به كما فعلوا بيوسف لما جاءوا إليه يبكون وقالوا: إن الذئب أكله ولم يصدقهم بذلك وقال:
[يوسف:18]؛ لأنه ظن أنهم فعلوا به كما فعلوا بيوسف لما جاءوا إليه يبكون وقالوا: إن الذئب أكله ولم يصدقهم بذلك وقال: ![]() وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ![]() [يوسف:18] يعني: أنه أمر دبرتموه على غير ما قلتموه، ويعقوب عليه السلام نبي كريم، وهو ابن إسحاق، ثم أمرهم أن يعودوا ويبحثوا عن يوسف وأخيه، وقال: لا تيأسوا من رحمة الله، فذهبوا ودخلوا على يوسف وهم لا يعرفونه فقالوا:
[يوسف:18] يعني: أنه أمر دبرتموه على غير ما قلتموه، ويعقوب عليه السلام نبي كريم، وهو ابن إسحاق، ثم أمرهم أن يعودوا ويبحثوا عن يوسف وأخيه، وقال: لا تيأسوا من رحمة الله، فذهبوا ودخلوا على يوسف وهم لا يعرفونه فقالوا: ![]() أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ
أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ![]() [يوسف:88]، فهنا جاءت الفرصة
[يوسف:88]، فهنا جاءت الفرصة ![]() قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ
قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ![]() [يوسف:89] عند ذلك تنبهوا
[يوسف:89] عند ذلك تنبهوا ![]() قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ![]() [يوسف:90] .
[يوسف:90] .
عند ذلك ![]() قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ
قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ![]() [يوسف:91] ماذا قال؟
[يوسف:91] ماذا قال؟ ![]() قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ![]() [يوسف:92] يعني: لن أعاتبكم، ولن آخذ بثأري، بل أعفو عنكم، وأسأل الله أن يغفر لكم، وهذا هو الكرم والعفو المتناهي، ثم أمرهم أن يذهبوا بقميصه إلى أبيه، فإنهم إذا ألقوه عليه رجع إليه بصره، وقد كف بصره من الحزن، وأمرهم أن يأتوا بأهلهم جميعاً، فجاءوا وسكنوا مصر.
[يوسف:92] يعني: لن أعاتبكم، ولن آخذ بثأري، بل أعفو عنكم، وأسأل الله أن يغفر لكم، وهذا هو الكرم والعفو المتناهي، ثم أمرهم أن يذهبوا بقميصه إلى أبيه، فإنهم إذا ألقوه عليه رجع إليه بصره، وقد كف بصره من الحزن، وأمرهم أن يأتوا بأهلهم جميعاً، فجاءوا وسكنوا مصر.
ثم لما جاء فرعون تسلط عليهم، وصار يقتل أبناءهم، ويترك نساءهم.
كان أولاً يقتل كل مولود سواء كان ذكراً أو أنثى من بني إسرائيل، والسبب في هذا أنه قال له الكهنة والسحرة أو غيرهم: إن زوال ملكك سيكون على يد مولود من بني إسرائيل، عند ذلك قال: لن ندع مولوداً يعيش، فصار يقتل، فقالوا له: سيفنى بنو إسرائيل وتتعطل أعمالنا؛ لأنهم كانوا يسخرونهم في الأعمال، في البناء وغيرها مثل ما هو مشاهد الآن من الأهرام وغيرها من آثار فرعون، يعملون تحت السياط، حملهم على العمل بالتعسف والظلم، كحمل الصخور حتى يبنوا بالقهر والقوة، فعند ذلك قال له أعوانه الظلمة: تتعطل أعمالنا، قال: ما الحيلة؟ فقالوا: تقتلهم سنة، وتبقيهم سنة، حتى نستطيع أن نشغلهم في الأعمال، فولد موسى عليه السلام في السنة التي فيها القتل، أما هارون فولد في السنة التي لا يقتل فيها المواليد.
والمقصود أن كل رسل بني إسرائيل من أولاد يعقوب بن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل الذي ذكر في القرآن كثيراً: ![]() يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ![]() [البقرة:40]، ويعقوب أولاده إثنا عشر ثم كثر نسلهم وانتشروا، قيل: إنهم لما خرجوا من مصر كانوا سبعين ألفاً، والواقع أنهم أكثر من سبعين ألفاً، وكلهم أولاد يعقوب، وهو إسرائيل النبي الكريم.
[البقرة:40]، ويعقوب أولاده إثنا عشر ثم كثر نسلهم وانتشروا، قيل: إنهم لما خرجوا من مصر كانوا سبعين ألفاً، والواقع أنهم أكثر من سبعين ألفاً، وكلهم أولاد يعقوب، وهو إسرائيل النبي الكريم.
لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: (من أكرم الناس؟ قال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم -يعني يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم- فقيل له: ليس عن هذا نسألك، فقال: تسألوني عن معادن العرب، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا) .
فالمقصود: أن إسرائيل نبي كريم؛ ولهذا ما يجوز أن نسمي شذاذ الخلق وخبثاءهم اليوم من اليهود إسرائيل، الناس اليوم يسمونهم دولة إسرائيل، والواجب أن يسموا اليهود؛ لأن إسرائيل نبي، والنبي بريء من كل من خالف نهجه وطريقته، وإن كان من أولاده، وإن كان من أبنائه، فالنسب لا يفيد شيئاً، وإنما يفيد العمل.
والمقصود: أن نسب رسولنا صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إبراهيم بلا إشكال، وهذا أمر يجب القطع به، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه صلوات الله وسلامه عليه ابن إسماعيل، وإسماعيل لم يبعث نبي من ذريته إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف إسحاق فإن جميع الأنبياء من أولاده.
أما ما ذكر أن خالد بن سنان نبي من العرب، وأن قومه هم أصحاب الرس؛ فهذا لم يثبت، وجاءت فيه أحاديث الله أعلم بها، وجاء أنه نبي ضيعه قومه، وإذا صحت الأحاديث وجب اعتقاد ذلك، ولكن لم تثبت الأحاديث.
وكلمة حنيف معناها مبتعد عن الشرك، مبتعد عنه قصداً مع العلم والقوة، ولهذا قالوا: إن هذا الدين الذي جاء به الرسول هو أشد الأديان وأعظمها في مسألة الشرك، ولكن في الشرع وأعمال الفروع هو أسمح الأديان وأسهلها، أما في العقيدة فهو أشدها وأعظمها، يبعد عن الشرك ووسائله، فالحنيف غير السمح السهل.
إبراهيم عليه السلام كان حنيفاً يعني: بعيداً عن أن يقع في شيء من الشرك، تاركاً للشرك قصداً، مائلاً إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له وحده، فهكذا هذه الأمة على هذا النهج، أما في الشرائع فإنها سهلة وسمحة، فهي أيسر الشرائع كلها، وعرف من الأمثلة الشيء الكثير، فإن بني إسرائيل كانت عليهم آصار وأغلال في شرائعهم، كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، وإذا خرج الإنسان من ذلك المكان فلابد أن يرجع إليه ويصلي فيه، وكان أحدهم إذا أصاب ثوبه نجاسة ما يكفي أن يغسله، لا بد أن يقرضه بالمقراض ويلقيه، وهذا من الآصار، وحرمت عليهم أشياء من الأطعمة، وحرم عليهم أشياء كثيرة أحلت لهذه الأمة تسهيلاً وسماحة من الله جل وعلا، ومن القواعد التي يذكرها العلماء وتؤخذ من كليات الشرع: المشقة تجلب التيسير، كل شيء يشق على الناس فلا بد أن يكون الدين جاء بتيسيره وتسهيله، وهذه قاعدة جعلوها أصلاً يرجعون إليها.
رحمة الرسول بالمؤمنين
وقوله : ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) كما قال تعالى : ![]() وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ![]() [الشعراء:217] .
[الشعراء:217] .
وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله : (فإن تولوا) أي: عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة ![]() فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ![]() [التوبة:129] ]
[التوبة:129] ]
هذا يدل على اختصاص رأفته ورحمته بالمؤمنين، أما الكافرون فهو لايرحمهم، بل هو شديد عليهم، كما قال الله جل وعلا: ![]() يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ![]() [التوبة:73] ، وقوله تعالى:
[التوبة:73] ، وقوله تعالى: ![]() مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ![]() [الفتح:29]، بينهم رحماء، ولكن على الكفار أشداء، وهذا وصفه على ضوء أمر الله له، حينما قال له:
[الفتح:29]، بينهم رحماء، ولكن على الكفار أشداء، وهذا وصفه على ضوء أمر الله له، حينما قال له: ![]() جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ![]() [التوبة:73]، فرأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
[التوبة:73]، فرأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
[قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها، والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب ].
يعني أنه بين هذا ووضحه، ومن ذلك النهي عن الصلاة عند القبور.
 البث المباشر
البث المباشر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
12199
قراءة متن الشاطبية
مشاري راشد العفاسي -
10516
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
4621
قصص الأنبياء - قصة ابراهيم في فلسطين وبناء الكعبة - قصة اسماعيل واسحاق- قصة قوم لوط
طارق السويدان -
3956
منظومة عشرة الإخوان
توفيق سعيد الصائغ -
2714
قصة آدم عليه السلام
نبيل العوضي -
2589
سلسلة السيرة النبوية من الظلمات إلى النور
راغب السرجاني -
2210
الرقية الشرعية - مشاري راشد العفاسي
-
2204
متن الدرة المضية__عثمان المسيمي
عثمان المسيمي -
1993
عمر بن الخطاب
بدر بن نادر المشاري -
1971
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي

عدد مرات الاستماع
3086718663

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك