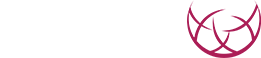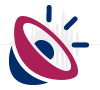 الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- عبد الله بن محمد الغنيمان
- شرح العقيدة الواسطية
- شرح العقيدة الواسطية [16]
قوله: ( ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ).
هذه مسألة الكلام التي هي صفة لله، وهي مسألة كبيرة عظيمة، تفرق فيها الناس فرقاً كثيرة، ولها فروع كثيرة، وقد قيل: إن كتب الكلام أطلق عليها ذلك من أجل أن مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي ذكرت فيها فسميت بذلك، وكذلك أهل الكلام سموا أهل الكلام؛ لكثرة ما خاضوا فيه في هذه المسألة.
ومعلوم أن الذي لا يكون له دليل من كتاب الله أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يضل؛ لأن العقل لا يستطيع أن يستقل بمعرفة الهدى، إنها أمور غيبية وأمور مخالفة للمحسوسات المشاهدة فكيف يهتدي العقل؟! هذا لا يمكن! وإنما الطريق في ذلك ترسم ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في هذه المسألة خاصة، وفي جميع المسائل التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالله جل وعلا وأوصافه وأفعاله، أو تتعلق بأمور الغيب من أمور الآخرة وما يكون بعد الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وما يكون في الجنة وما يكون في النار، هذا شيء لا يدرك بالنظر ولا بالعقل، بل لابد أن يكون متوقفاً على الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا لأنبيائه الذين يرشدون الناس إلى طريق الهدى، وقد قال الله جل وعلا: ![]() وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً
وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً ![]() [الإسراء:82] الظالم الذي ترك الاهتداء به تزيده آيات الله وبيناته بعداً وعناداً وتكبراً وإباءً، فيزداد بذلك ضلالاً على ضلاله، وقد قال جل وعلا في صفة هؤلاء
[الإسراء:82] الظالم الذي ترك الاهتداء به تزيده آيات الله وبيناته بعداً وعناداً وتكبراً وإباءً، فيزداد بذلك ضلالاً على ضلاله، وقد قال جل وعلا في صفة هؤلاء ![]() سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ
سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ![]() [الأعراف:146]، يعني: أن الدلائل وإن كبرت وعظمت إذا لم يجعل الله للإنسان عوناً مساعداً منه فإنه لا يستطيع الاهتداء بها، فالقرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو الوحيد في أنه يجب أن يوصف بأنه كلام الله بل التوارة والإنجيل والزبور، وجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، يجب الإيمان بأنها كلامه جل وعلا، وأن فيها الهدى لمن اهتدى بها، وأن من سلك طريقاً غير الطريق التي أرشدت إليه فإنه يكون ضالاً.
[الأعراف:146]، يعني: أن الدلائل وإن كبرت وعظمت إذا لم يجعل الله للإنسان عوناً مساعداً منه فإنه لا يستطيع الاهتداء بها، فالقرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو الوحيد في أنه يجب أن يوصف بأنه كلام الله بل التوارة والإنجيل والزبور، وجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، يجب الإيمان بأنها كلامه جل وعلا، وأن فيها الهدى لمن اهتدى بها، وأن من سلك طريقاً غير الطريق التي أرشدت إليه فإنه يكون ضالاً.
يتكلم الله بكلام حقيقي بحرف وصوت يليق بجلاله
وسبق أن التنزيل جاء على ثلاثة أقسام:
قسم: مقيد بأنه من الله، وهذا للقرآن خاصة ولم يأت في غيره.
وقسم: مقيد بأنه من السماء، وهذا يكون للمطر ويكون للملائكة ويكون لغير ذلك مما يشاء الله جل وعلا.
وقسم: مطلق، كقوله: ![]() وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ![]() [الزمر:6] ، وقوله:
[الزمر:6] ، وقوله: ![]() وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ![]() [الحديد:25] فهذا أيضاً كالقسمين الذين قبله في لغة العرب، فالنزول لا يعقل إلا أن يكون من العلو إلى السفل، ولكن نزول الأزواج كما قال العلماء: يجوز أن يكون من ظهور الفحول أو من بطون الإناث، أو يُقصد الأمران معاً، ونزول الحديد يجوز أن يكون من الجبال المرتفعات، أو من حيث خلقه الله جل وعلا فيها، أما أن يكون من السفل ويسمى نزولاً فهذا لا يعرف، وأما القسمان الأولان: المقيد بأنه من الله فهو يدل على علوه ويدل على أنه صدر منه تعالى وتقدس، وأما كونه من السماء فيكون حسب السياق والتقييد الذي جاء به.
[الحديد:25] فهذا أيضاً كالقسمين الذين قبله في لغة العرب، فالنزول لا يعقل إلا أن يكون من العلو إلى السفل، ولكن نزول الأزواج كما قال العلماء: يجوز أن يكون من ظهور الفحول أو من بطون الإناث، أو يُقصد الأمران معاً، ونزول الحديد يجوز أن يكون من الجبال المرتفعات، أو من حيث خلقه الله جل وعلا فيها، أما أن يكون من السفل ويسمى نزولاً فهذا لا يعرف، وأما القسمان الأولان: المقيد بأنه من الله فهو يدل على علوه ويدل على أنه صدر منه تعالى وتقدس، وأما كونه من السماء فيكون حسب السياق والتقييد الذي جاء به.
وكذلك في الكتابة: فالورق والحبر شيء مخلوق، ولكن المكتوب المودع في المصحف هو كلام الله، ولهذا يجب احترامه، ولا يجوز للجنب أو الحائض أن تقرأه؛ لأنه كلام الله، فكلام الله سواءً حفظ أو كتب في المصاحف لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله، ومعلوم أن الكلام له وضع غير وضع الأجسام؛ لأن الكلام صفة وهو لا يقوم إلا بالموصوف، فإذا تكلم به ثم حفظ عنه أو سجل أو كتب فإنه يبقى كلامه، وهذا شيء معقول حتى في كلام المخلوقين، فلو أن إنساناً مثلاً قال:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل .. ألخ لقيل: هذا قول امرئ القيس ، ولو أن إنساناً ذكر هذا الكلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) لقيل: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سُمع قارئ يقرأ: ![]() الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ![]() [الفاتحة:2-4] لقيل: هذا كلام رب العالمين.. هذا كلام الله، فالقول والكلام يضاف لمن قاله مبتدئاً وليس للمؤدي أو الراوي أو الناقل فليس لهؤلاء إلا الرواية والنقل.
[الفاتحة:2-4] لقيل: هذا كلام رب العالمين.. هذا كلام الله، فالقول والكلام يضاف لمن قاله مبتدئاً وليس للمؤدي أو الراوي أو الناقل فليس لهؤلاء إلا الرواية والنقل.
وقد اختلف المتكلمون في هذا خلافاً كبيراً جداً، ولكن هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده، ومعلوم أن الجهمية يقولون: إن القرآن مخلوق وكذلك المعتزلة، ولكن ينبغي أن يعلم أن المعتزلة يصفون الله جل وعلا بأنه متكلم ويقولون: إن الله يتكلم ومقصودهم: أنه يخلق الكلام في مكان، ويكون متكلماً بمعنى: أنه يخلق الكلام، وهذا من أبطل الباطل أن يوصف بشيء ليس من صفاته، ولو كان الأمر هكذا لاقتضى أن يوصف بأنه الآكل الشارب تعالى الله وتقدس؛ لأنه يخلق الأكل والشرب في الآكلين والشاربين، وإنما الصفة تكون لمن صدرت منه ولمن لزمته.
والكلام صفة فعل وقد يكون صفة ذات، وصفات الأفعال تتعلق بالمشيئة بحيث أنه إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ فعلها لم يفعلها، فهي متعلقة بمشيئته، وهذا من الكمال، فالكلام والنزول والاستواء والخلق والرزق وغير ذلك من أفعاله يسميها المتكلمون حوادث ثم ينفونها عن الله، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.
سبب ضلال المتكلمين
فالجوهر: هو الشيء الذي يقوم بنفسه أو الشيء الذي يشغل مكاناً أو يرى ويلمس ويحس ويشاهد هذا قسم.
القسم الثاني: العرَض، والعرض هو اللون أو الصفة أو الكلام وما أشبه ذلك، والعرض لا يقوم إلا بغيره، فلا يمكن أن تجد كلاماً بدون متكلم، ولا علماً بلا عالم، ولا جهلاً بلا جاهل يقوم به، ولا لوناً من غير من يقوم به اللون وهكذا، فالأمور -عندهم- لا تخلوا عن هذه الأشياء، فهذا في كل المشاهدات وفي كل المخلوقات، ثم لما ذهبوا إلى الله جل وعلا والنظر فيه فقالوا: لا يجوز أن يكون مماثلاً للمخلوقات فلا يجوز أن يكون جوهراً ولا عرضاً فصاروا ينفون الصفات على هذا الأساس.. على أساس التشبيه أولاً ثم التعطيل ثانياً، ومعلوم أن هذا رأي وأفكار لا تجدي من الحق شيئاً، وإنما يجب إن يرجع إلى الوحي الذي أنزله الله جل وعلا واصفاً به نفسه، وكذلك أنزله على رسله يخبر ويعرف عباد الله بالله جل وعلا.
ثم قوله: ( منه بدأ وإليه يعود ) معناه: أنه ظهر من الله يعني: قاله قولاً حقيقياً سمعه جبريل عليه السلام وجاء به وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه، ثم الصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمة تلقته بعضها عن بعض.
معنى قوله في القرآن: (وإليه يعود)
الأول: أنه يعود إليه في آخر الزمان، كما جاءت الآثار في ذلك بأنه يرفع من الأرض فلا يبقى في الأرض منه حرف واحد، وهذا من علامات قيام الساعة الكبار؛ وذلك إذا ترك العمل به وعطل، واعتاظ الناس عنه بالقوانين الوضعية والآراء الفاسدة، فإنه يسرى عليه في ليلة واحدة فيسحب من المصاحف، فتبقى بيضاء ليس فيها شيء، وليس فيها حرف واحد، ويسحب من صدور الرجال الذين يحفظونه، فيصبح أهل الأرض لا يعرفون حرفاً واحداً من القرآن، وهذا إيذان بهلاك الناس؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم : (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) وفي رواية: (حتى لا يقال في الأرض الله الله) يعني: أنهم لا يعبدون الله ولا يذكرونه.
المعنى الثاني: أنه إليه يعود صفة، فخرج منه قولاً وإليه يعود صفةً يعني: يوصف به فهو من صفاته، وكلا المعنيين صحيح، وسواءً قلنا هذا أو هذا فكليهما صحيح.
قوله: (وأن الله تكلم به حقيقة) يعني: على ظاهر ما يعرف من لغة العرب، ومعلوم الكلام لا يعقل إلا إذا كان كلاماً يتكلم به وينطق ويسمع، وقد تكاثرت النصوص على هذا حتى جاء النداء فيخبر الله جل وعلا أنه نادى الأبوين آدم وزوجه لما عصيا واقترفا المعصية: ![]() وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ![]() [الأعراف:22] وبإجماع أهل اللغة بل أهل اللغات: أن النداء لا بد أن يكون بحروف وصوت يسمع؛ لأن النداء لمن بعد -كما سبق- بخلاف المناجاة فإنها لمن قرب، وجاء في القرآن ذكر النداء وأن الله ينادي، في أحدى عشر موضعاً، في سورة القصص أربعة مواضع منها.
[الأعراف:22] وبإجماع أهل اللغة بل أهل اللغات: أن النداء لا بد أن يكون بحروف وصوت يسمع؛ لأن النداء لمن بعد -كما سبق- بخلاف المناجاة فإنها لمن قرب، وجاء في القرآن ذكر النداء وأن الله ينادي، في أحدى عشر موضعاً، في سورة القصص أربعة مواضع منها.
الرد على من قال: إن القرآن كلام الرسول
هذا معنى قوله: (وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره).
لا يجوز أن يقال: القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله
القسم الثاني: كلام نفسي يعني: يكون مستكناً في النفس، وهذا الذي يصفون الله جل وعلا به، ويقولون: هو معنىً واحد لا يتجزأ يقوم بذات الله جل وعلا، وهذا المعنى الواحد سواءً كان توراة، أو إنجيلاً، أو قرآناً، أو زبوراً، أو غير ذلك، فإذا جاء المعبر الذي يعبر عن هذا المعنى الواحد فإن عبر عنه باللغة العربية سمي قرآناً! وإن عبر عنه بالعبرية سمي توراة! وإن عبر بالسريانية سمي إنجيلاً! وهكذا، فهو معنى واحد، فقوله تعالى: ![]() قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ![]() [الإخلاص:1] هو عين قوله تعالى:
[الإخلاص:1] هو عين قوله تعالى: ![]() تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ![]() [المسد:1]، وكذلك آية الكرسي، وما أشبه ذلك، وهذا من أمحل المحال، وأبطل الباطل، وتصور ذلك يكفي عن تكلف رده؛ لظهور بطلانه، فكل أحد يدرك بطلانه إذا سلم من الانحراف ومن التقليد الأعمى.
[المسد:1]، وكذلك آية الكرسي، وما أشبه ذلك، وهذا من أمحل المحال، وأبطل الباطل، وتصور ذلك يكفي عن تكلف رده؛ لظهور بطلانه، فكل أحد يدرك بطلانه إذا سلم من الانحراف ومن التقليد الأعمى.
ثم إنه لا فرق بين كتاب الله وكلام الله، فإن بعض أهل البدع يفرق بين هذا، فكلام الله يجعلونه صفة وهو ما قام بالنفس، أما كتاب الله يجعلونه مخلوقاً تعالى الله وتقدس، فإذا قيل: كتاب الله وكلام الله فالمعنى واحد عند أهل الحق وهو الذي دلت عليه النصوص.
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلاً
وهل يكون هذا دليلاً؟! مع أن النصارى قد ضلوا في مسألة الكلام، والمقصود أن هؤلاء المبطلين خالفوا كتاب الله وخالفوا العقل والفطر. والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الأشاعرة ليسوا من أهل السنة
الجواب: الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ولا يجوز الانتساب إلى الأشعري، فالانتساب إليه بدعة من البدع، ومن انتسب إليه واعتز بذلك فهو قد اعتز ببدع، ولكنهم من أقرب أهل البدع إلى السنة في كثير من المسائل، وليس كل المسائل بل في كثير منها، إلا أنهم في مقابل الشيعة يدخلون في أهل السنة، إذا قيل الشيعة والسنة؛ بل يدخل في ذلك حتى المعتزلة، ولكن هذا بالنظر إلى اصطلاحهم هم. ثم إن أبا الحسن الأشعري ما رجع إلى أهل السنة الرجوع الكامل، بل بقي عنده من مسائل الكلام الشيء الكثير الذي خالف فيه أهل السنة، ولهذا من نظر في كتبه تبين له ذلك، مثل: رسالته إلى أهل الثغر، ويقال: إن هذه من آخر ما كتب، وفيها مخالفات كثيرة لمذهب أهل السنة وغير ذلك.
معنى قولهم: كلام الله قديم النوع حادث الآحاد
الجواب: معنى هذا: أنه صفة ذات وصفة فعل -وكثير من الصفات كذلك- والمراد: أن نوع الكلام أزلي يعني: أن الله لم يزل متكلماً، وآحاده: التي يكلم بها رسله وعباده، وكذلك يكلم خلقه يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الملائكة فكل كلام كلم به نبياً أو ملكاً أو تكلم به فأنزله فهو آحاد من آحاد الكلام، يعني: بعض الكلام، ومعنى ذلك أنه يتجدد، وليس معنى ذلك أنه تكلم -كما قال الكلابية- في الأزل ثم أصبح لا يتكلم! تعالى الله وتقدس؛ ولذلك قال أهل السنة: كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، وبعضهم تحاشى أن يقول: حادث، لئلا يفهم الحدوث وهو الخلق، مع أن هذا جاء ذكره في القرآن: ![]() مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ![]() [الأنبياء:2]، فيقول جل وعلا:
[الأنبياء:2]، فيقول جل وعلا: ![]() لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ![]() [الطلاق:1]، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة) .
[الطلاق:1]، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة) .
حكم من أنكر الصفات
الجواب: لا يلزم ذلك، فالمنكر قد يكون مجتهداً، وقد يكون تلقى هذا عن مشايخه بنية طيبة وحسن قصد، ويرى أن هذا هو الصواب، كطريقة أكثر الأشاعرة وغيرهم، فمثل هذا لا يجوز تضليله فضلاً عن تكفيره، بل نقول: إنه مجتهد مخطئ والله يثيبه على اجتهاده ويغفر خطأه، وقد وقع في مثل هذا كثير من العلماء: مثل النووي رحمه الله والبيهقي والخطابي رحم الله الجميع، وغيرهم من العلماء الكبار وأئمة المسلمين، فيجب أن يترحم عليهم ويترضى عنهم، ويعلم أنهم قالوا هذا القول مجتهدين؛ لأن البيئة التي نشئوا فيها والعلماء الذين أخذوا عنهم هم الذين وجهوهم هذا التوجه، وذكروا لهم أن هذه هي معاني الكلام، واستبعدوا أن يكون هذا خطأ، فاجتهدوا وأخطئوا، فهم مجتهدون مخطئون.
معنى (جعل) في القرآن الكريم
الجواب: جعل إذا جاءت بمعنى خلق فهي تتعدى إلى مفعول واحد، كقوله جل وعلا: ![]() وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ![]() [الأنعام:1] أما إذا كانت بمعنى قال، أو اعتقد، أو علم فإنها تكون متعدية إلى مفعولين، فورودها في القرآن ليس على نمط واحد، فقد قال الله جل وعلا:
[الأنعام:1] أما إذا كانت بمعنى قال، أو اعتقد، أو علم فإنها تكون متعدية إلى مفعولين، فورودها في القرآن ليس على نمط واحد، فقد قال الله جل وعلا: ![]() وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً
وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ![]() [النحل:91] فهل يجوز أن نقول: وقد خلقتم الله؟! وقد جاء في آيات كثيرة أن الجعل يكون من الإنسان ويكون من الله:
[النحل:91] فهل يجوز أن نقول: وقد خلقتم الله؟! وقد جاء في آيات كثيرة أن الجعل يكون من الإنسان ويكون من الله: ![]() إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً
إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً ![]() [الزخرف:3] فهذا تعدى إلى مفعولين، يعني: أنه أنزله قرآناً عربياً أو قاله قولاً عربياً.
[الزخرف:3] فهذا تعدى إلى مفعولين، يعني: أنه أنزله قرآناً عربياً أو قاله قولاً عربياً.
هل الجلوس من صفات الله؟
الجواب: لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، هذه القاعدة يجب أن تكون عند الإنسان دائماً فكل وصف أو فعل لم يصح به نص لا يجوز إثباته وهذا ما صح به شيء.
كلام الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج
الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والقول الصواب: أنه سمع كلام الله، فقد فرض عليه خمسين صلاة، وكان يكلمه في ذلك، وصار يتردد من السماء السابعة إلى المكان الذي كلمه الله فيه: ![]() عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ![]() [النجم:14] بين موسى وبين هذا المكان، يرجع إلى هذا المكان فيكلمه الله ويسأله التخفيف عدة مرات، والشيء الذي فرض عليه هو الصلاة.
[النجم:14] بين موسى وبين هذا المكان، يرجع إلى هذا المكان فيكلمه الله ويسأله التخفيف عدة مرات، والشيء الذي فرض عليه هو الصلاة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 البث المباشر
البث المباشر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
15171
قراءة متن الشاطبية
مشاري راشد العفاسي -
11984
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
5145
قصص الأنبياء - قصة ابراهيم في فلسطين وبناء الكعبة - قصة اسماعيل واسحاق- قصة قوم لوط
طارق السويدان -
4932
منظومة عشرة الإخوان
توفيق سعيد الصائغ -
3028
قصة آدم عليه السلام
نبيل العوضي -
2862
سلسلة السيرة النبوية من الظلمات إلى النور
راغب السرجاني -
2756
الرقية الشرعية - مشاري راشد العفاسي
-
2656
متن الدرة المضية__عثمان المسيمي
عثمان المسيمي -
2297
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي -
2167
عمر بن الخطاب
بدر بن نادر المشاري

عدد مرات الاستماع
3086718663

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك