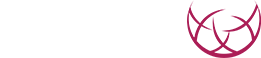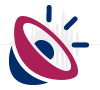 الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- مصطفى العدوي
- تفسير جزء الذاريات
- تفسير سورة الحديد[1]
وبعد:
فسورة الحديد أطلق عليها هذا الاسم لورود ذكر الحديد فيها، كما أطلقت الأسماء على غيرها من السور لورود الاسم فيها، فسورة البقرة سميت بذلك لورود ذكر البقرة فيها، وآل عمران سميت بذلك لذكر آل عمران فيها، وكذلك النساء والمائدة والأعراف والأنعام، كما سميت بعض السور بمطالعها، أو بالحروف المقطعة التي بُدئت بها.
قوله تعالى: ![]() سبح
سبح ![]() أي: نزه. فالمعنى: نزه الله سبحانه وتعالى كل من في السماوات ومن في الأرض عن كل عيب وعن كل نقص، وعن الشريك، وعن الولد، وعن الصاحبة.
أي: نزه. فالمعنى: نزه الله سبحانه وتعالى كل من في السماوات ومن في الأرض عن كل عيب وعن كل نقص، وعن الشريك، وعن الولد، وعن الصاحبة.
وهذا يفيد أن الجمادات أيضاً تسبح، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ![]() وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ![]() [الإسراء:44]، فدلت هذه الآية الكريمة على أن الجمادات تسبح، وقال تعالى في كتابه الكريم:
[الإسراء:44]، فدلت هذه الآية الكريمة على أن الجمادات تسبح، وقال تعالى في كتابه الكريم: ![]() لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ![]() [الحشر:21]، وقال سبحانه:
[الحشر:21]، وقال سبحانه: ![]() وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ![]() [البقرة:74]، وقال سبحانه:
[البقرة:74]، وقال سبحانه: ![]() إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ![]() [الأحزاب:72].
[الأحزاب:72].
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ)، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يثبت لأعرابي نبوته قال له: (اذهب إلى هذه الفسيلة فادعها)، فذهب إليها فدعاها فأتت تشق طريقها حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعت، وثبت أن الجذع حنّ لما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسُمع له صوت كصوت العشار إلى أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر فاحتضنه، والأدلة في هذا كثيرة، وكلها تثبت أن للجمادات أنواعاً من الإدراكات، وأنواعاً من التسبيحات والسجود، ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى، كما قال تعالى: ![]() وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ![]() [الإسراء:44]، وقال في شأن نبي الله داود عليه السلام:
[الإسراء:44]، وقال في شأن نبي الله داود عليه السلام: ![]() يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ
يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ![]() [سبأ:10]، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ( كنا نسمع للطعام تسبيحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤكل )، والحديث ثابت صحيح.
[سبأ:10]، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ( كنا نسمع للطعام تسبيحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤكل )، والحديث ثابت صحيح.
قال تعالى: ![]() لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ![]() [الحديد:2].
[الحديد:2].
أحسن ما فسرت به هذه الآية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء).
وقد كثرت أقوال المفسرين في تأويل قوله تعالى: ![]() هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ![]() .
.
إلا أن تفسير ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق، هو الأولى، فقوله: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء)، ويفسر المراد بـ(الأول)، وقوله: (وأنت الآخر فليس بعدك شيء) يفسر المراد بـ(الآخر)، وقوله: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) يفسر المراد بـ(الظاهر)، وقوله: (وأنت الباطن فليس دونك شيء) يفسر المراد بـ(الباطن).
ومما فسرت به قول بعض العلماء: (الباطن): العالم ببواطن الأمور وما خفي وما غاب منها.
و(الظاهر): القاهر الذي يَغلب ولا يُغلب، ويعلو سبحانه وتعالى ولا يعلى عليه، وعلى بعض هذه الألفاظ بعض المآخذ.
قوله تعالى: ![]() وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ![]() .
.
الآيات التي تثبت علم الله سبحانه وتعالى تتكرر مراراً في سور الكتاب العزيز، وكل معنىً تكرر في الكتاب العزيز يدل تكراره على أهمية عظمى له، فإذا فهم العبد ذلك وأيقن به، ولازمه هذا الشعور وهذا العلم بأن الله تعالى عليم استقامت أموره، وحسنت سرائره، ومن ثم صلحت له دنياه وصلحت له أخراه، فكم من آية ختمت بقوله تعالى: (والله عليم حكيم)، وبقوله تعالى: (والله عليم خبير)، وبقوله تعالى: (إنه عليم بذات الصدور)، وكم من آية سيقت لإثبات هذا المعنى، كقوله تعالى: ![]() الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ
الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ![]() [الشعراء:218-219]، وقوله تعالى:
[الشعراء:218-219]، وقوله تعالى: ![]() أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ![]() [هود:5]، وقوله تعالى:
[هود:5]، وقوله تعالى: ![]() وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ![]() [يونس:61]، وقد تكاثرت الآيات المثبتة لهذا المعنى غاية الكثرة، وكلها لتأسيس شيء في الأذهان وتثبيته وترسيخه، ألا وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى، والعلم بأنه يراك ويطلع على أحوالك، ويعلم سرك ونجواك، قال تعالى:
[يونس:61]، وقد تكاثرت الآيات المثبتة لهذا المعنى غاية الكثرة، وكلها لتأسيس شيء في الأذهان وتثبيته وترسيخه، ألا وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى، والعلم بأنه يراك ويطلع على أحوالك، ويعلم سرك ونجواك، قال تعالى: ![]() وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ![]() [الطلاق:12].
[الطلاق:12].
قوله تعالى: ![]() يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ![]() أي: يدخل الليل في النهار، وقوله تعالى:
أي: يدخل الليل في النهار، وقوله تعالى: ![]() وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ![]() أي: يدخل النهار في الليل، فهذا يأخذ من طول ذاك، وهذا يأخذ من طول ذاك، فالليل يطول في بعض أيام السنة ويأخذ من النهار، والنهار يطول في بعض أيام السنة ويأخذ من الليل.
أي: يدخل النهار في الليل، فهذا يأخذ من طول ذاك، وهذا يأخذ من طول ذاك، فالليل يطول في بعض أيام السنة ويأخذ من النهار، والنهار يطول في بعض أيام السنة ويأخذ من الليل.
قوله تعالى: ![]() وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ![]() في هذا تكرار الإخبار بعلم الله سبحانه.
في هذا تكرار الإخبار بعلم الله سبحانه.
فالآيات السابقة تتضمن الإخبار بأن الله سبحانه عليم يعلم الظاهر كما يعلم الباطن، ولكن تصرف الآيات وتتنوع وتتعدد أساليبها، فمن لم يفهم من هذا السياق فهم من السياق الآخر، ومن لم يتذكر بهذه الآية فليتذكر بتلك، ومن لم يدرك هذه الفقرة فليدرك تلك، وكلها -كما سلف- لتأسيس شيء وترسيخه، ألا وهو العلم بأن الله تعالى عليم، كما قال تعالى: ![]() ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ![]() [الأنعام:60].
[الأنعام:60].
قوله تعالى: ![]() آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ![]() الخطاب هنا موجه لأهل الإيمان على قول بعض أهل العلم، فيرد على هذا القول إشكال فحواه: كيف يوجه لهم الأمر بالإيمان وهم في الأصل مؤمنون؟!
الخطاب هنا موجه لأهل الإيمان على قول بعض أهل العلم، فيرد على هذا القول إشكال فحواه: كيف يوجه لهم الأمر بالإيمان وهم في الأصل مؤمنون؟!
فمن العلماء من أجاز ذلك على أن المراد: زيدوا في إيمانكم بالله ورسوله، وزيدوا تصديقاً لله تعالى، وزيدوا تصديقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: ![]() يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ ![]() [النساء:136]، فالمعنى إذاً: ليزدد إيمانكم بالله ورسوله.
[النساء:136]، فالمعنى إذاً: ليزدد إيمانكم بالله ورسوله.
وعليه فيكون في هذا الدليل دليلٌ لأهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على هذا متعددة، كقوله تعالى: ![]() لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ![]() [الفتح:4]، وقوله تعالى:
[الفتح:4]، وقوله تعالى: ![]() وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ![]() [التوبة:124]، وقوله تعالى:
[التوبة:124]، وقوله تعالى: ![]() إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ![]() [الأنفال:2]، وقال تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم:
[الأنفال:2]، وقال تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ![]() قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ![]() [البقرة:260].
[البقرة:260].
قوله تعالى: ![]() وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ![]() ذكر بعض أهل العلم أن بينها وبين قوله تعالى:
ذكر بعض أهل العلم أن بينها وبين قوله تعالى: ![]() آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ![]() رابطاً قوياً، وهو أن قوله تعالى:
رابطاً قوياً، وهو أن قوله تعالى: ![]() آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ![]() أي: صدقوا الله ورسوله وأنفقوا. فنصدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الإنفاق أيضاً، فقد قال لنا ربنا سبحانه وتعالى:
أي: صدقوا الله ورسوله وأنفقوا. فنصدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الإنفاق أيضاً، فقد قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ![]() إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ![]() [التغابن:17]، وقال سبحانه وتعالى:
[التغابن:17]، وقال سبحانه وتعالى: ![]() وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ![]() [سبأ:39].
[سبأ:39].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم تطلع فيه الشمس وإلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا)، فإذا كنت موقناً بأن الله تعالى يخلف على المتصدق، وبأن الملك يدعو للمتصدق بأن يخلف الله تعالى عليه، وازداد بذاك يقينك وإيمانك حملك ذلك على استقبال قوله تعالى: ![]() وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ![]() ، بالأنفاق السريع، وبالامتثال السريع.
، بالأنفاق السريع، وبالامتثال السريع.
وهذا يفيد في مسائل من الدعوة إلى الله تعالى، وفي مسائل التعامل مع الخلق.
فيمهد للتعامل مع الخلق بالتذكير بالله تعالى بالإيمان به، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في معاملته مع الناس، ومعاملته مع أهل الإيمان، وأحكامه في القضايا، فكان دائم التذكير بالإيمان بالله تعالى قبل أن يفصل في القضايا، فمن ذلك قوله الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين قبل أن يقضي بينهما، وقبل أن يبدأ اللعان: (الله أعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟).
وفي سائر قضاياه يقول للمتخاصمين قبل الحكم: (إنكم تختصمون لدي ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار، فإن شاء قبلها وإن شاء ردها)، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بالله تعالى، ويذكر الخصوم بالله تعالى قبل أن يبدأ في فضّ النزاع والقضاء بينهم.
فلهذا يشرع التذكير بالله تعالى قبل إبداء الأوامر، وقبل إبداء النصائح، حتى مع العدو الصائل، أو مع من يخشى معه الشر، فيشرع تذكيره كذلك بالله تعالى، فقد حكى الله تعالى عن مريم عليها السلام لما تمثل لها الملك بشراً سوياً قولها: ![]() إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِيًّا
إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِيًّا ![]() [مريم:18] أي: ألجأ وأستجير بالرحمن منك. وفي حديث صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي جلس بين رجليها ابن عمها ليرتكب معها المحرم قالت مذكرة له بالله تعالى: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه.
[مريم:18] أي: ألجأ وأستجير بالرحمن منك. وفي حديث صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي جلس بين رجليها ابن عمها ليرتكب معها المحرم قالت مذكرة له بالله تعالى: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه.
فقوله تعالى: ![]() آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ![]() أي: صدقوا الله ورسوله فيما أخبراكم به على وجه العموم، وصدقوا الله ورسوله فيما أخبراكم به من أن المنفق يخلف الله سبحانه وتعالى عليه.
أي: صدقوا الله ورسوله فيما أخبراكم به على وجه العموم، وصدقوا الله ورسوله فيما أخبراكم به من أن المنفق يخلف الله سبحانه وتعالى عليه.
ثم جاء الأمر بالإنفاق فقال تعالى: ![]() وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ![]() ، وفي هذه الآية تجريد لك من المال الذي بين يديك، فليس لك الحق في المال الذي بين يديك تعبث فيه كما تشاء، وتتصرف فيه كما تريد، فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الإسراف فقال تعالى:
، وفي هذه الآية تجريد لك من المال الذي بين يديك، فليس لك الحق في المال الذي بين يديك تعبث فيه كما تشاء، وتتصرف فيه كما تريد، فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الإسراف فقال تعالى: ![]() إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ![]() [الأنعام:141]، ونهانا عن التبذير فقال تعالى:
[الأنعام:141]، ونهانا عن التبذير فقال تعالى: ![]() إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ![]() [الإسراء:27]، وقال سبحانه:
[الإسراء:27]، وقال سبحانه: ![]() وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ![]() [الإسراء:26].
[الإسراء:26].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الاقتصاد والسمت الحسن جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)، فليس لك أن تتصرف بالمال الذي بين يديك يمنةً ويسره كما تشاء، فأنت مسئولٌ عن الاستخلاف في هذا المال وبما عملت فيه، ومسئولٌ عن طريق اكتسابه، ومسئولٌ عن موضع إنفاقه.
والذين ينفقون الأموال في الإضرار بالمسلمين والإضرار بمن استرعاهم الله تعالى إياهم كلهم مسئولون أمام الله تعالى عن خيانة هذه الأمانة التي حملهم الله تعالى إياها.
قوله تعالى: ![]() فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ![]() في الآية إيماء بالرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان كبيرة، ولا ينفع كذلك -عند بعضهم- مع الإيمان كبير عمل.
في الآية إيماء بالرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان كبيرة، ولا ينفع كذلك -عند بعضهم- مع الإيمان كبير عمل.
كما أن فيها أن الإنفاق بدون إيمان لا ينفع صاحبه، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله: ![]() وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ![]() [الفرقان:23]، ويقول تعالى:
[الفرقان:23]، ويقول تعالى: ![]() مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ
مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ![]() [إبراهيم:18]، ويقول سبحانه في الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه).
[إبراهيم:18]، ويقول سبحانه في الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه).
تعددت أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بالميثاق، ومتى أخذ، ومن الذي أخذه.
فقال بعضهم: إن الذي أخذ الميثاق على الإيمان هو ربنا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة الأعراف: ![]() وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ![]() [الأعراف:172-173].
[الأعراف:172-173].
وفي معناه وتفسيره قال فريق من أهل العلم: إن الميثاق هو الميثاق المأخوذ على ذرية آدم وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام، فأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالله تعالى وأن يوحدوه؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لما خلق الله آدم مسح على ظهره فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها، ثم نثرهم بين يديه كالذر، ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين).
وخالف في هذا المعتزلة فقالوا: ما الذي أدرانا أن هذا الميثاق قد أخذ ولا يذكره أحد من الخلق؟!
وهذا ضرب من التأويل باطل؛ إذ يصح أن يقال -بناءً على هذا الزعم الباطل-: وما الذي أدرانا أن آدم عليه السلام خلق من تراب؟ وهذا كله من أنواع الباطل.
فمنهج أهل السنة في ذلك أن الله تعالى أخذ من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام الميثاق على الإيمان وعلى التوحيد.
ومما يؤسف له أن بعض مفسري أهل السنة والجماعة المشهود لهم بالتوفيق في تفسيرهم سلك في هذه الآية مسلك المعتزلة في تأويلها، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، في تفسيره (تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن)، فلينبه على هذه الزلة في هذا التفسير الذي هو في عمومه طيبٌ ومبارك.
وثمّ قولٌ آخر في الميثاق أنه الميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار ليلة العقبة،
وقال بعض أهل العلم: إن قوله تعالى: ![]() وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ
وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ ![]() [الحديد:8] خطاب موجهٌ لأهل الكتاب، والميثاق هو المذكور في قوله تعالى:
[الحديد:8] خطاب موجهٌ لأهل الكتاب، والميثاق هو المذكور في قوله تعالى: ![]() وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ![]() [آل عمران:81].
[آل عمران:81].
فأخبر الأنبياء أممهم بهذا الميثاق، وأخذوا على أممهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بُعث، فكان يهود يستفتحون على الذين كفروا من الأوس والخزرج، ويقولون: سيخرج نبيٌ عن قريب نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم.
قال تعالى: ![]() هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ![]() [الحديد:9].
[الحديد:9].
قوله تعالى: ![]() هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ![]() أي: واضحات ظاهرات جليات، وقوله تعالى:
أي: واضحات ظاهرات جليات، وقوله تعالى: ![]() لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ![]() أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان ونور الطاعات.
أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان ونور الطاعات.
هذا أيضاً تذكيرٌ بأن المال زائلٌ عنك، وأن الله سبحانه يرث السماوات والأرض، وتكرر هذا المعنى كثيراً حتى تزهد فيما هو في يديك، ومن هذا قوله تعالى ![]() إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ![]() [مريم:40].
[مريم:40].
فلماذا تتخلف عن الإنفاق والوارث للسماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ![]() لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا
لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ![]() [الحديد:10] هذه الآية تدلنا على أصل، وتؤدبنا بأدب، ألا وهو احترام أصحاب السوابق في الخير، فمن أفنى عمره في طاعة الله تعالى، ومن أفنى عمره في الدعوة إلى الله تعالى، ومن أفنى عمره في الصلاة والصيام، على الناس أن يوقروه، ويقيلوا عثرته إذا زلت قدمه، وعلى الناس أن ينزلوا الناس منازلهم، فالرجل الكبير الطاعن في السن الذي ابيض شعره واشتعلت لحيته شيباً كم سجد لله من سجدة، وكم صام لله تعالى من شهر، وكم سبح لله من تسبيحة، وكم حج، وكم اعتمر، فلا ينبغي أن يُساوى مع الأحداث الذين قلّ ذكرهم وطاعتهم لله تعالى، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا)، وكان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الصغير منهم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كبر كبر)، وقال صلوات الله وسلامه عليه: (أراني أتسوك الليلة فأتاني رجلان فدفعت السواك إلى الأصغر منهما فقيل لي: كبر) أي: أعط الأكبر.
[الحديد:10] هذه الآية تدلنا على أصل، وتؤدبنا بأدب، ألا وهو احترام أصحاب السوابق في الخير، فمن أفنى عمره في طاعة الله تعالى، ومن أفنى عمره في الدعوة إلى الله تعالى، ومن أفنى عمره في الصلاة والصيام، على الناس أن يوقروه، ويقيلوا عثرته إذا زلت قدمه، وعلى الناس أن ينزلوا الناس منازلهم، فالرجل الكبير الطاعن في السن الذي ابيض شعره واشتعلت لحيته شيباً كم سجد لله من سجدة، وكم صام لله تعالى من شهر، وكم سبح لله من تسبيحة، وكم حج، وكم اعتمر، فلا ينبغي أن يُساوى مع الأحداث الذين قلّ ذكرهم وطاعتهم لله تعالى، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا)، وكان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الصغير منهم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كبر كبر)، وقال صلوات الله وسلامه عليه: (أراني أتسوك الليلة فأتاني رجلان فدفعت السواك إلى الأصغر منهما فقيل لي: كبر) أي: أعط الأكبر.
وفي هذه الآية ردٌ على الشيعة البغضاء البعداء -قاتلهم الله عز وجل وانتقم منهم- في انتقاصهم لـأبي بكر، ولـعمر رضي الله تعالى عنهما، فمن الذي نال الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من هذه الآية الكريمة سوى الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد كان -كما حكى الله تعالى عنه-: ![]() ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ![]() [التوبة:40]، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له -كما حكى الله عنه-:
[التوبة:40]، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له -كما حكى الله عنه-: ![]() لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ![]() [التوبة:40]، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما نفعني مالٌ قط ما نفعني مال
[التوبة:40]، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما نفعني مالٌ قط ما نفعني مال
والجهل حين ينتشر يقبل قول كل ناعق، والذي يؤسف غاية الأسف أن يكون في الجامعات من يتشدق بالنيل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من ذوي المراكز هنالك، ولا يوجد من ينكر عليه ذلك من الزملاء الأفاضل، والإخوة الأتقياء الأبرياء البررة.
فجديرٌ بكل مسلم أن يكون ذابا دائماً عن صحابة النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم؛ ليكون له نصيب من قوله تعالى: ![]() وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ![]() [الحشر:10].
[الحشر:10].
فإذا كان رب العزة يقول: ![]() وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ![]() [التوبة:100]، فهل الصديق رضي الله عنه منهم أم لا؟ أليس منهم الخليفة البار الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أم لا؟
[التوبة:100]، فهل الصديق رضي الله عنه منهم أم لا؟ أليس منهم الخليفة البار الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أم لا؟
ويأتي شيعي بغيض مقيت -قاتله الله عز وجل وقاتل أتباعه وأشياعه- يصف هذين الكريمين سيدي شيوخ أهل الجنة بما لا يليق بهما، ويقول: إنهما الجبت والطاغوت، فقاتل الله عز وجل أهل الظلم وأهل العدوان، وكل من شايعهم، وكل من سايرهم.
ولو كان مثل هذا الزنديق موجوداً على عهد السلف الصالح رحمهم الله تعالى لنكلوا به، ولكنها دولة الفوضى ينعق فيها كل ملحد بما يريد، وينعق كل نصراني بما يريد، وكل شيعي بما يريد، ولا أحد يوقف هذه الهمجية وهذا العبث في النيل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وهذا خالد بن الوليد رضي لله تعالى عنه سيف من سيوف الله تعالى المسلولة سله الله تعالى على المشركين، كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه شيء، وعبد الرحمن أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال خالد لـعبد الرحمن بن عوف : أتعيروننا بأيام سبقتمونا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونال من عبد الرحمن ، فبلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه)، ولكن شاء الله تعالى أن يأتي قوم رعاع ينالون من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أفضلهم بالإجماع، وشارك هذا الناعق اللئيم اليهود في نيلهم من أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم.
في هذا تسلية وتعزية لمن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وهذه التسلية والتعزية تأتي في جملة من مواطن الكتاب العزيز، ومن ذلك قوله سبحانه في شأن داود وسليمان عليهما السلام: ![]() وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ![]() [الأنبياء:78-79]، ثم أثنى على داود عليه السلام بقوله تعالى:
[الأنبياء:78-79]، ثم أثنى على داود عليه السلام بقوله تعالى: ![]() وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ![]() [الأنبياء:79].
[الأنبياء:79].
فهذه الأخلاق تستفيد منها في التعامل مع الناس، فإن مايزت بين اثنين فينبغي عليك أن تثني على الطرفين بما يسري على النفوس، وقد جاء معاذ ومعوذ ابني عفراء رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتلهما لـأبي جهل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمسحا سيوفكما. ثم نظر إلى السيفين فقال: كلاكما قتله)، ثم أعطى سلبه لأحدهما مع قوله صلى الله عليه وسلم: (كلاكما قتله)، فهذا أدبٌ يتأدب به مع الناس الذين هم دون في الفضل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
معنى ورود جهنم المذكور في سورة مريم
الجواب: قال فريق من أهل العلم -ويكاد ينعقد قول الجمهور على ذلك-: إن المراد بالورود: المرور على الصراط، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أذان الفجر ولقمة الصائم في فمه
الجواب: يأكله ولا حرج.
إحباط العمل بترك صلاة العصر ومعناه
الجواب: نعم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله).
السؤال: ما معنى إحباط عمل تارك صلاة العصر؟
الجواب: إحباط عمل تاركها ينبني على أشياء.
فإن كان ترك صلاة العصر جحوداً لها فتحبط جميع الأعمال ويكفر بذلك، وإن كان ترك صلاة العصر تكاسلاً فقد قال فريق من أهل العلم: يحبط عمل يومه ذلك. والقواعد الكلية لأهل السنة والجماعة تفيد عدم التكفير إلا عند الجحود، وهذا رأي الجمهور.
صلاة سنة الفجر بعد الفريضة
الجواب: نعم. يجوز ذلك؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها).
إيثار الدعاء بين الأذان والإقامة على السنة القبلية
الجواب: لا يشرع ذلك، بل يكره كراهية شديدة.
الجمع بين ملك النخل وقوله تعالى: (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير)
الجواب: السائل بعيد، فالإنسان لا يملك شيئاً، بل يموت ويترك كل شيء لله سبحانه وتعالى.
مدى صحة النهي عن صيام يوم السبت، وما ورد مما يخالفه
الجواب: الحديث ضعيف حكم عليه خمسة من الأئمة الأولين بالضعف، فقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه: هذا حديث كذب، وقال أبو داود رحمه الله تعالى: هذا حديث مضطرب. فضعفه خمسة من الأوائل، وإن كانت له أسانيد يُحكم عليها في الظاهر بالحسن إلا أن هؤلاء الخمسة الأئمة على تضعيف هذا الحديث.
وأما من ناحية المعنى فإن المعنى ضعيف كذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوماً قبله أو يوماً بعده)، واليوم الذي بعده هو السبت يقيناً، وقال صلوات الله وسلامه عليه: (إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوما)، فمن حافظ على هذا فسيصوم السبت يقينا، وقال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالثلاث البيض من كل شهر)، وبالمحافظة عليها يأتي فيها السبت يقيناً على مدار العام.
أما أن يفهم من هذا الحديث أنه لا يصام السبت حتى وإن كان يوم عرفة فهذا فهم خاطئ، ولم يقل به السلف، بل جماهير السلف رحمهم الله تعالى على خلافه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فإن صح الخبر فهو منزلٌ على من يخصص يوم السبت لاعتقاد منه على أن في ذلك خيراً، فسيكون قد خصص السبت وشابه اليهود في تخصيصهم السبت من دون الأيام؛ إذ اليهود يسبتون يوم السبت، ويؤخرون الأعمال فيه، ويعتقدون أن في السبت فضيلة، فإن فعلت وأنت تعتقد هذا الاعتقاد اليهودي فلا شك أنك مذموم.
قبض تعويضات حرب الخليج
الجواب: خذها واستمتع بها.
الزيادات الواردة في أحاديث افتراق الأمم
الجواب: كل الزيادات التي وردت في هذا الحديث بعد قوله صلى الله عليه وسلم: (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة) فيها نظر، فالحديث: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة) إلى هذا القدر حسنٌ، وكل زيادة بعد ذلك، كزيادة (وكلها في النار)، و(الجماعة)، و(السواد)، متكلمٌ فيها، ليست متكلماً فيها من المعاصرين، بل من الأوائل رحمهم الله تعالى، وقد أفردت رسائل لبعض إخواننا في بيان ذلك كله، فليراجعها من شاء.
عورة المرأة المسلمة عند النصرانية وحدودها
الجواب: فيه قولان لأهل العلم، والذي يترجح أن المراد جنس النساء؛ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخلت عليها يهودية فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (كذبت يهود)، ثم أوحيَ إليه أن هذه الأمة تبتلى في قبورها.
ففي هذا الحديث كانت اليهودية تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها.
فالحاصل أن عورة المسلمة بالنسبة لغير المسلمة على هذا التأويل الثاني تكون كعورتها بالنسبة لسائر النساء، وهو ما يظهر غالباً من المرأة للمرأة، والله أعلم.
السنة في لبس العمائم
الجواب: لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، إلا أن هناك حديثاً أورده ابن القيم في زاد المعاد من طريق مجاهد عن أم هانئ قالت: (دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وله عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه له أربع غدائر)، إلا أن مجاهداً لم يسمع من أم هانئ ، فالبس العمامة كما تيسر لك، إلا أن ما يتعمم به جماعة التبليغ كأنه الأقرب إلى السنة، والله تعالى أعلم.
الصغار وخواتيم الذهب
الجواب: يجوز إهداء الطفل الصغير خاتماً من ذهب؛ لما جاء في الحديث (أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه خاتم من عند
لكن هل يلبس الصغير ما يحرم على الكبار؟
الجواب: ورد في الصحيح: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لـ
مدى صحة حديث الأوعال
الجواب: حديث الأوعال ليس بصحيح.
الشطرنج وأقوال العلماء فيه
الجواب: لم يرد في مسألة الشطرنج حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت أو غير ثابت فيما علمت، وورد عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد فيه ضعف: أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
ولكن بنى العلماء قولهم في الشطرنج على أنه نوع من أنواع اللهو المضيع للأوقات، والمذهب للصحة والأذهان، فذهب الجمهور إلى منعه لهذه الأسباب؛ للعمومات الشرعية، ثم منهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
سلس الريح وحكمه
الجواب: إذا كانت مصاباً بسلس الريح فلك حكم، وإذا كان خروج الريح منك وقتياً فلك حكم آخر، فإذا كنت تكثر إخراج الريح كما لو كان في كل دقيقة يخرج الريح، ويأس الأطباء من علاجك، فستكون مصاباً بما أطلقوا عليه (سلس الريح)، وحينئذٍ من العلماء من سيسلك معك مسلك من به سلس البول، وسلس البول ليس فيه دليل أصلاً، وإنما سلكوا بمن به سلس البول مسلك المستحاضة، ويقول: تتوضأ وتسد الدبر بشيء أثناء الصلاة حتى لا يخرج منك شيء، وإن خرج بعد السد بالقطن شيء، فلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
مسائل متعلقة بكفارة اليمين
الجواب: إما إخراج القيمة في كفارة اليمين فجمهور العلماء على أن القيمة لا تجزئ؛ لأن الله تعالى قال: ![]() فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ![]() [المائدة:89].
[المائدة:89].
أما الأحناف فذهبوا إلى أن القيمة تجزئ، لكن هناك تعليل يطرح في هذه المسألة لتقرير رأي، ولا لترجيح رأي على آخر، وهو أن الجمهور الذين قالوا بإخراج الطعام قد يكون من توجيهاتهم أن المال قد يكون متوفراً عندك، بخلاف الطعام، فرأى الجمهور إخراج الطعام لهذه العلة، فإذا توفر المال ولم يتوفر الطعام ![]() فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ![]() [المائدة:89]، والآية صريحة في إخراج الطعام دون المال.
[المائدة:89]، والآية صريحة في إخراج الطعام دون المال.
أما إن كان المال متوفراً والطعام متوفراً، فإن حدة القول بأن القيمة لا تجوز ستخف قليلاً وهذا رأي له وجاهته من ناحية المعنى، وقد قال به الأحناف، فنكون بهذا وقرنا قول الأئمة الثلاثة بقولنا: كفارته إطعام عشرة مساكين في حالة عدم توفر الطعام.
فإذا كان الطعام متوفراً والأموال متوفرة، ومن الممكن أن الفقير يختار مكان الطعام الذي سيأتي إليه أي نوع هو يشتهيه، فهل سيصبح في فسحه أم في غير فسحة؟
وهذا كله لا يقاوم النص: (فكفارته إطعام عشرة مساكين)، ولكن القضية في فهم هذا النص، وهو الإطعام عند عدم الاستفادة من العملة.
يوضح هذا: أنك تكون أمام الحرم لتخرج زكاة الفطر، وتخرجها في الغالب أرزاً، فتجد أمام الحرم من يبيع أكياس أرز، والكيس بثمانية ريال، فتأخذ الكيس منه ثم تسلمه لواحد من الفقراء، فيعود الفقير إلى البائع ويبيعه منه بستة ريال، ثم يذهب لمتصدق آخر؛ إذ يجوز للفقير أن يبيع زكاة الفطر ويستفيد منها، فلقائل أن يقول: لو أنا أخذنا برأي الأحناف وسلمنا الرجل ثمانية ريال كاملة لكان لذلك وجهه!
وخلاصة المقال أن الجمهور على أن الكفارة إطعام فحسب، ولكن نحن نورد أن مخرج كلام الجمهور في أزمنة قد تكون الأطعمة فيها أقل من الأموال، كما نقول: إن حالة وجود المال والطعام الجمهور فيها على أن الكفارة كذلك لا تكون إلا طعاماً.
وأما مقدارها فهي وجبة واحدة لكل فرد أي: عشر وجبات.
وأما صفتها فقد قال تعالى: ![]() مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ![]() [المائدة:89].
[المائدة:89].
وأما تقديم الصيام على الإطعام فلا يجوز ما دمت تستطيع الإطعام.
استحلال قتل النفس
الجواب: المستحل يكفر، ولكن ما أدراك أنه مستحل أو غير مستحل؟!
حلول للتائب عن المعصية المجاهد لنفسه
الجواب: يبحث عن زوجةٍ يتزوجها بكراً كانت أم ثيباً على قدر سعته، وعليه أن يكثر من الصيام، ويعتقد تمام الاعتقاد أن تعالى الله رقيب عليه .
مدى صحة حديث: (زمزم لما شرب له)، وحديث: (الدال على الخير كفاعله)، والأحاديث الواردة في ليلة نصف شعبان
الجواب: حديث: (زمزم لما شرب له) لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وله شاهد من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه موقوفاً عليه، وبعض أهل العلم يجعل الموقوف شاهداً للضعيف، ويرقيه به إلى الحسن، وبعض العلماء يرى أن الضعيف يبقى ضعيفاً، ونحن نقول: الصحيح أنه موقوف على معاوية رضي الله تعالى عنه، ونحن مع الرأي الأخير.
السؤال: ما صحة حديث: (الدال على الخير كفاعله) ؟
الجواب: حديث صححه بعض أهل العلم.
السؤال: ما صحة الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان؟
الجواب: الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان كلها ضعيفة، وقد تكلم صاحب (سنن المبتدعات) عليها كلاماً جيداً، فليراجعه من شاء.
كلمة حول كثرة الجماعات واختلافها
الجواب: لا تدخل لتتحير بين جماعة من الجماعات، بل تعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واحضر مجالس العلم ومجالس الفقه في الدين، وآخ كل المسلمين فيما تستطيعه وتطيقه، وفيما يقره الشرع، أما أن تلزم نفسك بجماعة وأمير فهذه بدعة أصبحت بالية والحمد لله تعالى، فقد استنار المسلمون، ولنتعاون مع المسلمين على البر والتقوى فيما يقره الشرع، وفيما تطيقه وتتحمله.
الصلاة عند القبر
الجواب: القبر إذا نُبش جازت الصلاة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجده على نخيلٍ قد سوي وقبور نُبشت، فإذا نبش القبر جازت الصلاة، أما إذا لم ينبش القبر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)، وقال: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)، وقال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)، وقال: (لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها)، إلى غير ذلك من النصوص، وأقوال العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على القبور دائرة بين التحريم والكراهة.
تأويل الحديث: (إن الله خلق آدم على صورته)
الجواب: من أهل العلم من يقول (على صورته)، أي: على صورة المضروب؛ لأن لفظ الحديث: (إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمنّ الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته).
أي: خلق آدم على صورة هذا الذي ضربته؛ لأنك ضربت هذا فكأنك ضربت آدم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التأويل شيء، وإثبات أسماء وصفات الرب سبحانه وتعالى من نواح وأدلةٍ أخر.
قبض تعويض شركات التأمين
الجواب: اقبضه. ونسأل الله تعالى أن يتم شفاءك.
الزواج من المشركة أو الكتابية
الجواب: الزواج من مشركة لا يجوز، ولكن الزواج من يهودية أو نصرانية عفيفة جائز؛ لقوله تعالى: ![]() الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ![]() [المائدة:5].
[المائدة:5].
فإن قيل: إن الله سبحانه وتعالى وصف النصرانية أو اليهودية بأنها مشركة، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: ![]() اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ![]() [التوبة:31].
[التوبة:31].
فأفادت هذه الآية أنهم أهل شرك، وكذلك قال تعالى: ![]() لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ![]() [المائدة:73]، وقال تعالى:
[المائدة:73]، وقال تعالى: ![]() لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ![]() [المائدة:17] .
[المائدة:17] .
قلنا: إن كل عام في الشرع تأتيه تخصيصات.
فقول الله سبحانه وتعالى: ![]() الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ![]() [النور:2]، ليس على عمومه؛ فهناك زناة لا يجلدون في الأصل وهم المجانين، وهناك زناه يرجمون، وهناك زناه يجلدون خمسين جلدة وهم العبيد والإماء، فكل عام له استثناءاته.
[النور:2]، ليس على عمومه؛ فهناك زناة لا يجلدون في الأصل وهم المجانين، وهناك زناه يرجمون، وهناك زناه يجلدون خمسين جلدة وهم العبيد والإماء، فكل عام له استثناءاته.
فعلى وجه الإجمال لا يجوز لك أن تتزوج بمشركة، لكن استثني من أهل الشرك النصارى واليهود بقوله تعالى: ![]() الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ![]() [المائدة:5] أي: العفيفات.
[المائدة:5] أي: العفيفات.
وفهم ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بيهودية، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فكأنه نهى عن ذلك، فلما بلغ حذيفة أن عمر يشير إلى النهي ولم يأت صريح النهي قال له: أحرامٌ هو يا ابن الخطاب ؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، أي: خشيت أن تتزوجوا الزواني.
كما أن آية المائدة: ![]() الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ![]() [المائدة:5] بعد آية البقرة:
[المائدة:5] بعد آية البقرة: ![]() وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ![]() [البقرة:221].
[البقرة:221].
فمن أحب نصرانية، وكانت تريد الزواج به، ويريد الزواج بها وواجهتهما مشكلة إشهار الإسلام لخوف المرأة، فممكن أن يتزوجها على حالها هذه وهي نصرانية، ولكن يتأكد من عفتها؛ لأن الله تعالى لما أباح نكاح الكتابية قال: ![]() وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ![]() [المائدة:5] أي:: العفيفات من الذين أتوا الكتاب.
[المائدة:5] أي:: العفيفات من الذين أتوا الكتاب.
فإن ذكرها بالإسلام فإنه يؤجر على إسلامها.
وأما مقولة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فقد بناها على أنه كان هناك من بعض السلف من يقول: إني آكل ذبائح كل النصارى إلا ذبائح بني تغلب.
وقول الشيخ أحمد شاكر ليس بصحيح، بل مصادم للآية الكريمة، فهل أهل الكتاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين؟ والله تعالى يقول: ![]() الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ![]() [المائدة:5].
[المائدة:5].
فالذين أوتوا الكتاب كانوا كفاراً على عهد رسول الله، كما قال تعالى: ![]() لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ![]() [البينة:1]، فمقولة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى التي بثها في كتبه، وتلقفها الشباب الذين عندهم شدة في المسألة ليست بصحيحة، وإن كان قد صح أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما المنع، إلا أنه ورد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه الزواج فعلا بيهودية.
[البينة:1]، فمقولة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى التي بثها في كتبه، وتلقفها الشباب الذين عندهم شدة في المسألة ليست بصحيحة، وإن كان قد صح أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما المنع، إلا أنه ورد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه الزواج فعلا بيهودية.
كما أن التفريق في قوله تعالى: ![]() لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ![]() [البينة:1]، يفيد أن أهل الكتاب شيء وأهل الشرك شيء آخر، ولكن لا يمنع هذا من دخول أهل الكتاب في ضمن المشركين بنص آية براءة، إلا أن الذي يحسم مثل هذه القضية هو أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[البينة:1]، يفيد أن أهل الكتاب شيء وأهل الشرك شيء آخر، ولكن لا يمنع هذا من دخول أهل الكتاب في ضمن المشركين بنص آية براءة، إلا أن الذي يحسم مثل هذه القضية هو أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لفظ النكاح الوارد في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة...) والمراد به
الجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن النكاح هنا المراد به: الزواج.
لكن يرد عليه أن نقول: كيف تقول -رحمة الله عليك-: إن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة؟! فأنت بهذا تحل للزاني المسلم أن يتزوج بمشركة، وتحل للزانية المسلمة أن تتزوج بمشرك، وهذا لا يقره الشرع، فالزانية ما زالت مسلمة، فإذا قلت: إن المعنى أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة اختل عليك المعنى؛ لأن الله تعالى قال: ![]() وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ![]() [الممتحنة:10]، وقال:
[الممتحنة:10]، وقال: ![]() وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ![]() [البقرة:221].
[البقرة:221].
فالذي عليه الجمهور وهو رأي الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى- أن الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية ترضى بالزنا، أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا أصلاً، والزانية لا يطاوعها على الزنا إلا زانٍ أو مشرك.
تصفيق النساء وزغردتهن في الأعراس
الجواب: لا، فالتصفيق للنساء في العرس مباح، بل يستحب لهن، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نصٍ عام -وإن كان ورد في الصلاة-: (إنما التصفيق للنساء)، وقال صلى الله عليه وسلم لـعائشة رضي الله تعالى عنها: (ماذا عندكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو).
السؤال: هل الزغاريد حرامٌ في العرس؟
الجواب: الزغاريد لا أعلم في منعها حديثاً صحيحاً، وحديث: (صوتان ملعونان)، فيه نظر من ناحية الإسناد، وإن صح فدخول الزغاريد ليس واضحاً فيه، والكلام في الزغاريد مبني على المفسدة والمصلحة، فإن كانت النساء فيما بينهن فليزغردن وليصفقن كما شئن، وأما إذا كنّ سيفتن الرجال فهذا نوع من أنواع الفساد، والله لا يحب الفساد.
عقوبة الأمة المحصنة عند زناها
الجواب: الرجم لا يتنصف، والجمهور على أن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإذا زنت فليجلدها، فإذا زنت فليجلدها، فإذا زنت فليبعها ولو بحبل من ظفير ولا يثرب) أي: لا يوبخها ويعيبها.
والحكمة في الأمر ببيعها إذا زنت في الرابعة هي أنَّ سيدها قد يكون ضعيفاً لا يستطيع إعفافها، فيشتريها من يستطيع إعفافها، أو ربما كان ضعيف الشخصية لا تهابه، فيبيعها من شخص مهاب لا تستطيع عنده أن تلتفت يمنه أو يسرة.
الزواج بواسطة التلفونات
الجواب: يجوز بالمرئي وبغير المرئي إذا كان التلفون له سماعة يسمعها الشهود كذلك، فيجوز الزواج بهذه الطريقة.
حال حديث: (يا علي! لا تنم إلا على خمسة...)
الجواب: حديث ضعيف.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
 البث المباشر
البث المباشر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
12044
قراءة متن الشاطبية
مشاري راشد العفاسي -
10428
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
4600
قصص الأنبياء - قصة ابراهيم في فلسطين وبناء الكعبة - قصة اسماعيل واسحاق- قصة قوم لوط
طارق السويدان -
3894
منظومة عشرة الإخوان
توفيق سعيد الصائغ -
2692
قصة آدم عليه السلام
نبيل العوضي -
2582
سلسلة السيرة النبوية من الظلمات إلى النور
راغب السرجاني -
2191
الرقية الشرعية - مشاري راشد العفاسي
-
2150
متن الدرة المضية__عثمان المسيمي
عثمان المسيمي -
1985
عمر بن الخطاب
بدر بن نادر المشاري -
1950
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي

عدد مرات الاستماع
3086718663

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك