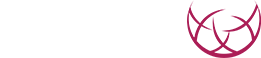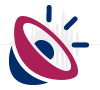 الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- مصطفى العدوي
- تفسير جزء تبارك
- تفسير سورة المزمل [2] وسورة المدثر [1]
يقول الله: ![]() فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ![]() [المزمل:17]، فكيف تدفعون وتتقون -إن كفرتم- يوماً يجعل الولدان شيباً لما فيه من الأهوال؟!
[المزمل:17]، فكيف تدفعون وتتقون -إن كفرتم- يوماً يجعل الولدان شيباً لما فيه من الأهوال؟!
أخرج البخاري ومسلم حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله سبحانه وتعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم! أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا رب! وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، فحينئذ يشيب الصغير، ![]() وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ![]() [الحج:2] ، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله! وأينا ذلك الواحد؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون، ومنكم واحد، أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: والذي نفسي بيده! إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة).
[الحج:2] ، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله! وأينا ذلك الواحد؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون، ومنكم واحد، أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: والذي نفسي بيده! إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة).
فإن قال قائل: لِم لم يقل: السماء منفطرة به، على التأنيث؟
قال بعض العلماء: إن هذا جرى على النسب، فالمعنى: والسماء ذات انفطار به، كما يقال في المرأة: المرأة حائض، ولا يقال: المرأة حائضة، وكما يقال: امرأة مرضع، ولا يقال: امرأة مرضعة.
وقال بعضهم: إن معناها: والسماء ذات انفطار بهذا اليوم، أي: أنها تنفطر أي: تتشقق، كما في الحديث: (قام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه) أي: تشققت قدماه، فمن شدة أهوال يوم القيامة تكون الجبال كثيباً مهيلاً، فتتحول الجبال مع شدتها وتماسكها إلى الكثيب المنهال، أي: الرمل المهال، والسماء كذلك مع شدتها وشدة حبكها تتقطع من شدة الأهوال، ![]() السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ![]() [المزمل:18] كان وعد الله كائناً.
[المزمل:18] كان وعد الله كائناً.
قال الله: ![]() إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا
إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ![]() [المزمل:19] أي: طريقاً يقربه من الله سبحانه وتعالى.
[المزمل:19] أي: طريقاً يقربه من الله سبحانه وتعالى.
ومن هذا الباب قول أبي بكر ، للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار : (يا رسول الله! لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا! قال له: يا ![]() وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ![]() [الشورى:27].
[الشورى:27].
قال تعالى: ![]() إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ
إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ![]() [المزمل:20] أي: طائفة من الذين آمنوا بك يقومون معك هذا القيام، أو يقومون مثل قيامك في بيوتهم،
[المزمل:20] أي: طائفة من الذين آمنوا بك يقومون معك هذا القيام، أو يقومون مثل قيامك في بيوتهم، ![]() وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ![]() [المزمل:20]، يعلم مقادير الليل ويعلم مقادير النهار، والتقدير أحياناً يطلق على الحساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال: (إن يوماً من أيامه كسنه، وإن يوماً من أيامه كشهر، وإن يوماً من أيامه كجمعة ..) الحديث، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا اليوم -يا رسول الله- الذي هو كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدره)، فالتقدير يطلق أحياناً على الحساب، وله معان أخر.
[المزمل:20]، يعلم مقادير الليل ويعلم مقادير النهار، والتقدير أحياناً يطلق على الحساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال: (إن يوماً من أيامه كسنه، وإن يوماً من أيامه كشهر، وإن يوماً من أيامه كجمعة ..) الحديث، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا اليوم -يا رسول الله- الذي هو كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدره)، فالتقدير يطلق أحياناً على الحساب، وله معان أخر.
![]() وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ![]() [المزمل:20] أي: يعلم مقادير الليل ومقادير النهار، وأوقات الليل وأوقات النهار.
[المزمل:20] أي: يعلم مقادير الليل ومقادير النهار، وأوقات الليل وأوقات النهار.
معنى قوله تعالى: (علم أن لن تحصوه..)
فالتوبة من معانيها: الرجوع، تاب فلان من ذنبه أي: رجع فلان من ذنبه، تاب الله عليك: عاد عليك بالرحمة بعد أن حجبت عليك الرحمة بسبب الذنب.
![]() عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ![]() [المزمل:20] أي: رجع عليكم بالتخفيف وإزالة هذا التكليف الذي كلفكم، به فتاب عليكم وعفا عنكم، كما في قوله تعالى في خواتيم سورة البقرة:
[المزمل:20] أي: رجع عليكم بالتخفيف وإزالة هذا التكليف الذي كلفكم، به فتاب عليكم وعفا عنكم، كما في قوله تعالى في خواتيم سورة البقرة: ![]() رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ![]() [البقرة:286]، هناك معنى للعفو، ومعنى للمغفرة، ومعنى للرحمة، العفو: المحو والإزالة، والمغفرة: التغطية وستر الذنب، وقولهم في الجاهلية: (إذا برئ الدبر، وعفا الأثر -أي: محي أثر البعير- ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر) أما المغفرة من: المغفر الذي يغطي الرأس، فقد يكون الشيء موجوداً لكنه غطي عليه، لكن العفو محوه وإزالته، وهنا يقول الله سبحانه وتعالى:
[البقرة:286]، هناك معنى للعفو، ومعنى للمغفرة، ومعنى للرحمة، العفو: المحو والإزالة، والمغفرة: التغطية وستر الذنب، وقولهم في الجاهلية: (إذا برئ الدبر، وعفا الأثر -أي: محي أثر البعير- ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر) أما المغفرة من: المغفر الذي يغطي الرأس، فقد يكون الشيء موجوداً لكنه غطي عليه، لكن العفو محوه وإزالته، وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ![]() عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا
عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا ![]() [المزمل:20].
[المزمل:20].
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
ومنها أحاديث استنبط منها الحكم استنباطاً كما في قصة إدراك أبي بكرة للركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاء متأخراً ودخل في الصلاة والنبي راكع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام -بعد أن انصرف من الصلاة- (زادك الله حرصاً! ولا تعد)، قالوا: لم يأمره النبي بالإتيان بركعة جديدة فعلى ذلك يكتفي المؤتم بقراءة الإمام، وإذا أدرك الإمام وهو راكع كتبت له ركعة، وهذا رأي الجمهور، ومن العلماء من قال: إن قوله تعالى: ![]() فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ![]() [المزمل:20] يفيد: التخيير، وقد ذهب طائفة من الأحناف إلى أنه: إذا قرأ العبد أي شيء من القرآن في صلاته جازت الصلاة وصحت الصلاة لعموم قوله تعالى: ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن )، ولما ورد في بعض طرق حديث: المسيء صلاته : (فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)، وفي بعض طرق هذا الحديث: (اقرأ بفاتحة الكتاب ثم بما تيسر)، وفي طرق أخر: (فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن).
[المزمل:20] يفيد: التخيير، وقد ذهب طائفة من الأحناف إلى أنه: إذا قرأ العبد أي شيء من القرآن في صلاته جازت الصلاة وصحت الصلاة لعموم قوله تعالى: ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن )، ولما ورد في بعض طرق حديث: المسيء صلاته : (فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)، وفي بعض طرق هذا الحديث: (اقرأ بفاتحة الكتاب ثم بما تيسر)، وفي طرق أخر: (فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن).
معنى الضرب في الأرض
قال الله سبحانه وتعالى: ![]() وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ![]() [المزمل:20]، ففيها بيان مشروعية التجارة والاكتساب والسفر طلباً للرزق الحلال.
[المزمل:20]، ففيها بيان مشروعية التجارة والاكتساب والسفر طلباً للرزق الحلال.
وقوله تعالى: ![]() وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ![]() [المزمل:20]، أي: كل في تخصصه: التاجر في تجارته، والمجاهد في جهاده، والمصلي في صلاته، والقارئ في قراءته،
[المزمل:20]، أي: كل في تخصصه: التاجر في تجارته، والمجاهد في جهاده، والمصلي في صلاته، والقارئ في قراءته، ![]() وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ![]() [المزمل:20]، ( اقرءوا ما تيسر منه ) أي: من القرآن في صلاة الليل أو بصفة عامة، فعلى هذا أصبحت هذه الآية ناسخة لقوله تعالى -على رأي الجمهور-:
[المزمل:20]، ( اقرءوا ما تيسر منه ) أي: من القرآن في صلاة الليل أو بصفة عامة، فعلى هذا أصبحت هذه الآية ناسخة لقوله تعالى -على رأي الجمهور-: ![]() يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا
يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ![]() [المزمل:1-2]، وقد قدمنا أن قيام الليل كان واجباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم نسخ بهذه الآية:
[المزمل:1-2]، وقد قدمنا أن قيام الليل كان واجباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم نسخ بهذه الآية: ![]() فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ * وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ * وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ![]() [المزمل:19-20] أي: حافظوا على أدائها وركوعها وسجودها
[المزمل:19-20] أي: حافظوا على أدائها وركوعها وسجودها ![]() وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ![]() [المزمل:20].
[المزمل:20].
تفسير القرض الحسن
![]() وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ![]() [المزمل:20]، كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذها بيمينه، فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه، حتى تكون التمرة كالجبل العظيم)، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
[المزمل:20]، كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذها بيمينه، فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه، حتى تكون التمرة كالجبل العظيم)، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ![]() وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ![]() [المزمل:20]، أي: أكثروا من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب في محو الخطايا ورفع الدرجات وسبب في استجلاب الأرزاق،
[المزمل:20]، أي: أكثروا من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب في محو الخطايا ورفع الدرجات وسبب في استجلاب الأرزاق، ![]() اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ![]() [هود:52]، وسبب في دفع المصائب عن العبد،
[هود:52]، وسبب في دفع المصائب عن العبد، ![]() وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ![]() [المزمل:20].
[المزمل:20].
أقوال العلماء في أول الآيات نزولاً
فالجمهور على أن أول سورة نزلت من كتاب الله هي العلق، ومن العلماء من قال: إن أول سورة نزلت من كتاب الله هي: سورة المدثر ، ومنهم جابر بن عبد الله الصحابي، وجمع فريق من العلماء بين القولين بأن قال: إن أول ما نزل على رسول الله هي سورة العلق، ثم فتر الوحي، فبعد مدة نزل على رسول الله سورة المدثر، فالصحابي الذي قال: إن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هي سورة المدثر، قال ذلك باعتبار النزول الثاني، أي: أول ما نزل على رسول الله بعد الانقطاع سورة المدثر، أو قال ذلك بحسب علمه، والله أعلم.
الخلاصة: إما أن يقال: إن الصحابي أراد بقوله: إن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام سورة المدثر: أي بعد انقطاع وفتور الوحي مدة، أو يقال: إن الصحابي قال هذا بحسب علمه رضي الله تعالى عنه.
أما المدثر فمعناها أيضاً: المزمل، فالمدثر: هو الذي تدثر بثيابه، أي: التف في ثيابه، وكما أسلفنا أن العرب كانوا إذا أرادوا أن يتلطفوا مع شخص في الخطاب ينادونه بصفة هي ملابسة له، كأن يقولون: (قم يا نومان!)، أو (قم يا
قال الله سبحانه وتعالى: ![]() يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ![]() [المدثر:1] أي: يا أيها الذي تدثر بثيابه وتلفف فيها وتغطى، قم من نومك واترك غطاءك وفراشك، (قُمْ فَأَنذِرْ).
[المدثر:1] أي: يا أيها الذي تدثر بثيابه وتلفف فيها وتغطى، قم من نومك واترك غطاءك وفراشك، (قُمْ فَأَنذِرْ).
سبب الاقتصار على الإنذار في قوله تعالى: (قم فأنذر)
![]() وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ![]() [المدثر:1-3] أي: عظم ربك سبحانه وتعالى، ولا تخش إلا هو سبحانه وتعالى، ومن العلماء من قال: قل: الله أكبر، على ظاهر الآية، ومنهم من قال: إن معنى قوله: ( وربك فكبر ) أي: وربك فعظم، وربك فمجد.
[المدثر:1-3] أي: عظم ربك سبحانه وتعالى، ولا تخش إلا هو سبحانه وتعالى، ومن العلماء من قال: قل: الله أكبر، على ظاهر الآية، ومنهم من قال: إن معنى قوله: ( وربك فكبر ) أي: وربك فعظم، وربك فمجد.
من أهل العلم من حملها على ظاهرها وقال: هذا أمر بطهارة الثياب.
وقيل: المقام مقام حثٍ على الدعوة، فلابد في مستهلها من طهارة القلب من الشرك، وطهارة النفس من الخبث، وكانت العرب تقول على الرجل الوفي في تعاملاته: نظيف الثياب، كما قال الشاعر:
فإني بحمد الله لا ثوب غازل لبست ولا من غبرة أتقنع
فمراده بقوله: فإني بحمد الله لا ثوب غازل لبست؛ أي: لا ثوب فاجر لبست، ولا من غبرة أتقنع، أي: أنه نظيف لم يغدر بأحد ولم يفجر.
فطهارة الثياب فسرت هنا بمعنيين: بمعنى طهارة الثياب حقيقة، وبمعنى تزكية النفس وطهارتها والبعد عن الرذائل.
وهنا مسألة: هل يشترط لصحة الصلاة طهارة الثوب؟
طهارة الثوب على التحقيق واجب مستقل من الواجبات، فإذا صلى شخص بثوب عليه نجاسة، هل الصلاة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ فالتحقيق في المسألة -والله أعلم-: أن الصلاة صحيحة ويأثم على عدم تطهير الثوب إن كان لم يطهره عمداً، وإن كان لم يطهره سهواً فلا شيء عليه، والصلاة أيضاً صحيحة، ومما يدل على ذلك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، فخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة، سألهم النبي: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذىً)، ولم يعد الرسول التكبيرة التي كبرها والركعات التي ركعها وهو مرتدياً لذلك النعل الذي فيه أذى، فدل ذلك على صحة التكبيرة، ولو كانت الصلاة باطلة لخرج النبي وكبر للصلاة من جديد، فلما لم يفعل ذلك دل على أن من دخل في الصلاة وعلى ثوبه نجاسة وهو لا يشعر، وصلى أن الصلاة صحيحة ولا تعاد، أما من دخل الصلاة وفي ثوبه نجاسة وهو يعلم، فهذا آثم بمخالفته لقول الله تعالى: ![]() وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ![]() [المدثر:4]، لكن الصلاة صحيحة، وإثم المخالفة مستقل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وهذه مسائل لا تخلو من نزاع، كمسائل الأرض المغصوبة وغيرها من المسائل ومسألة الأرض المغصوبة هي: مثلاً شخص اغتصب أرضاً، فجاء قوم وصلوا في هذه الأرض وهم يعلمون أنها مغصوبة، هل الصلاة باطلة أم صحيحة؟ فيها نزاع قائم بين العلماء، والذي يظهر -والله أعلم- أن الصلاة صحيحة، وإثم اغتصاب الأرض والمساعدة على الإثم والعدوان فيها إثم قائم مستقل، والله أعلم.
[المدثر:4]، لكن الصلاة صحيحة، وإثم المخالفة مستقل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وهذه مسائل لا تخلو من نزاع، كمسائل الأرض المغصوبة وغيرها من المسائل ومسألة الأرض المغصوبة هي: مثلاً شخص اغتصب أرضاً، فجاء قوم وصلوا في هذه الأرض وهم يعلمون أنها مغصوبة، هل الصلاة باطلة أم صحيحة؟ فيها نزاع قائم بين العلماء، والذي يظهر -والله أعلم- أن الصلاة صحيحة، وإثم اغتصاب الأرض والمساعدة على الإثم والعدوان فيها إثم قائم مستقل، والله أعلم.
وقوله تعالى: ![]() وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ![]() [المدثر:6]، ما المراد بالمن هنا؟ فيه أقوال:
[المدثر:6]، ما المراد بالمن هنا؟ فيه أقوال:
القول الأول: إن المراد بالمن هنا: الإعطاء، فقوله سبحانه: ![]() وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ![]() [المدثر:6] أي: لا تعط أحداً عطية وتطلب أكثر من هذه العطية، كالذي يفعل مع الأمراء، كشخص يأخذ هدية مثلاً بألف جنية ويهديها للمحافظ أو للرئيس من أجل أن يعطيه المحافظ أو الرئيس قطعة أرض بمائة ألف مثلاً.
[المدثر:6] أي: لا تعط أحداً عطية وتطلب أكثر من هذه العطية، كالذي يفعل مع الأمراء، كشخص يأخذ هدية مثلاً بألف جنية ويهديها للمحافظ أو للرئيس من أجل أن يعطيه المحافظ أو الرئيس قطعة أرض بمائة ألف مثلاً.
فالمعنى على هذا يكون: لا تعط عطية كي تحصل على أكثر منها، ففسر المن بالإعطاء كما تقول: شخص من علي بكذا، أي: أعطاني كذا، وتقول: أمنن علي مَنَّ الله عليك! أي: أعطني أعطاك الله! وكما قال ثمامة بن أثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمنن تمنن على شاكر، يعني: إن تعط تعط رجلاً شاكراً،
وكما قال الله في آية أخرى: ![]() وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ![]() [الروم:39].
[الروم:39].
القول الثاني: لا تستكثر بأعمالك، فإن أهل الكرم يفعلون كبير الفعال الخيرة ولا يلتفتون إليها ولا يستكثرونها، بل يفعلون كبار الأفعال وعظائم الأفعال النبيلة وهم يرون أنهم لم يصنعوا شيئاً، هذا فعل أهل الفضل، وأهل الخير يقدمون ما قدموه ويرون أنهم ما صنعوا شيئاً، كما قال القائل: وتصغر في عين العظيم العظائم، يعني: يفعل الشيء العظيم ولا يبالي به كأنه صغير، وغيره يفعل الفعلة الصغيرة ويعظمها تعظيماً زائداً.
فمعنى قوله: ( ولا تمنن تستكثر ) أي: لا تعط العطية وتتباهى بها، بل أهمل ما صنعت من معروف، ولا تذكره أمام الناس.
القول الثالث: أي: لا تعط العطية وتمن بها على الناس، وتكثر من منّك على الناس.
وقوله تعالى: ![]() وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ![]() [المدثر:7] من العلماء من قال: ( ولربك ) أي: ولعبادة ربك فاصبر كما قال:
[المدثر:7] من العلماء من قال: ( ولربك ) أي: ولعبادة ربك فاصبر كما قال: ![]() فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ![]() [مريم:65]، فالمعنى: لطاعة ربك ولعبادة ربك فاصبر.
[مريم:65]، فالمعنى: لطاعة ربك ولعبادة ربك فاصبر.
ومنهم من قال: إن معنى قوله: ( ولربك فاصبر ) أي: تحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل إعلاء كلمته المشاق والصعاب، واصبر من أجل نصرة دين الله.
![]() فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ
فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ![]() [المدثر:8-10].
[المدثر:8-10].
هل ذلك اليوم يسير على المؤمنين؟ وهل ينال المؤمن يوم القيامة من الكرب والهم والبلاء شيء أو أن يوم القيامة لا أثر فيه على المؤمن؟
هذه المسألة للعلماء فيها شيء من النزاع، فمنهم من يقول: إن المؤمن لا يناله شيء من الخوف ولا من الفزع، ودليل هذا القول قوله تعالى: ![]() لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ![]() [الأنبياء:103]، إلى غير ذلك من الآيات.
[الأنبياء:103]، إلى غير ذلك من الآيات.
ومنهم من قال: إن أهل الإيمان ينالهم شيء من الفزع وشيء من الخوف وشيء من الهم والكرب، لكن مآلهم إلى الخير وهذا القول الأخير، تدل عليه جملة أدلة:
منها حديث الشفاعة الطويل وفيه أن: (آدم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، ونوح يقول: نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، وإبراهيم يقول: نفسي نفسي، إني كذبت ثلاث كذبات، وموسى يقول: نفسي نفسي، إني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها)، فالخلق كلهم يبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ودعوى المرسلين على جنباته -أي الصراط-: ربي! سلم سلم)، وفي الحديث : (تدنو الشمس من رءوس الخلائق يوم القيامة)، فكل هذه أهوال، والوقوف على الميزان: وقت من أوقات الأهوال، والمرور على الصراط: وقت من أوقات الأهوال، ودنو الشمس من الخلائق: وقت من أوقات الأهوال، وتناول الكتب بالشمال أو باليمين: وقت من أوقات الأهوال، قال تعالى: ![]() يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ![]() [عبس:34-35]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة : (إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً، قالت: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من ذلك يا
[عبس:34-35]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة : (إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً، قالت: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من ذلك يا
وقوله: ![]() وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ![]() [المدثر:12] الممدود: الواسع.
[المدثر:12] الممدود: الواسع.
حكم المظاهرات؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالظاهر لي -والله أعلم- أن المظاهرات وسيلة محدثة، ما درج عليها سلفنا الصالح -من الصحابة- في القرون المفضلة، بل حتى بعد القرون المفضلة، فلم نعهد الإمام الشافعي قام بمظاهرة ولا الإمام مالك ولا الصحابة ولا التابعون، أما القصة المشار إليها ألا وهي قصة خروج حمزة على صف وعمر على صف، فالذي يحضرني الآن أن إسنادها ضعيف، ثم هي لا تصلح أن تكون دليلاً على التظاهرات المزعومة، والله أعلم.
حكم قراءة القرآن بدون مراعاة أحكام التجويد
الجواب: إذا كان للتعلم ولسرعة الحفظ فالظاهر أن هذا جائز، والله أعلم.
حكم قراءة القرآن بدون وضوء
الجواب: قراءة القرآن بدون وضوء جائز مع الكراهة، فالأفضل أن يتوضأ الشخص لقراءة القرآن، لكن إن قرأ بدون وضوء فالقراءة جائزة، لحديث عائشة : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه).
أما بالنسبة لمسألة: هل يجوز للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر أن يمس المصحف؟
الجواب: مسألة مس المصحف لغير المتوضئ مسألة خلافية، لكن العبرة بالدليل، فلا أعلم دليلاً صحيحاً صريحاً يمنع غير المتوضئ من مس المصحف، أما الآية الكريمة: ![]() لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ![]() [الواقعة:79]، فالجمهور على أن الضمير يعود على الملائكة.
[الواقعة:79]، فالجمهور على أن الضمير يعود على الملائكة.
أما قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، فالصواب أنه ضعيف، فعلى ذلك فرغ الباب من دليل يمنع من مس المصحف، والعبرة بالدليل، أما أقوال العلماء فهي كثيرة، ولا دليل صحيح صريح يمنع من مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر.
حكم الاجتماع للتعزية في بيت الميت
الجواب: هذه المسألة جاء فيها قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة)، كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت أو عند أهل الميت أو الأكل عند أهل الميت من النياحة، فهذا الحديث عليه مأخذ حديثي ومأخذ فقهي. أما بالنسبة للناحية الحديثية فهذا الحديث مروي من طريق: هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ، أخرجه ابن ماجة في سننه، وأيضاً أخرجه الإمام أحمد من طريق راوٍ يقال له: نصر بن باب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ، فـنصر بن باب اتهم بالكذب قال البخاري: يرمونه بالكذب، وهذا من مشايخ الإمام أحمد القلائل جداً الذين تكلم فيهم بالضعف بل بالكذب، مشايخ الإمام أحمد الذين رموا بالكذب قلة جداً، ومنهم هذا الشيخ، فمتابعة نصر بن باب لـهشيم لا تعويل عليها من الأصل فاطرحها جانباً، فلا تعويل على رواية نصر بن باب .
بقيت رواية هشيم بن بشير عن إسماعيل عن قيس عن جرير ، هشيم مدلس، وتدليسه في الحقيقة مؤثر، وخاصة إذا تفرد بإخراج الحديث ابن ماجة في سننه من بين أصحاب الكتب الستة، فتفرد ابن ماجة بإخراج الحديث بهذا السند مشعر بشيء من الضعف، لكن التعويل في التضعيف على أنه معنعن الإسناد، والحديث أورده الدارقطني في كتاب العلل الجزء المخطوط، وقال: رواه شريج بن يونس والحسن بن عرفة عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد ، ورواه خالد المدائني فذكر إسناداً لـخالد، لكن خالداً -أصلاً- متروك وكذاب، ثم قال الدارقطني في خواتيم مقالته: وخرجوه عن هشيم عن شريك عن إسماعيل ، فكأن هناك واسطة بين هشيم وبين إسماعيل ، ومن الذين خرجوه؟ الله أعلم ، لكن الآن الإسناد الموجود أمامنا: هشيم عن إسماعيل وهشيم عنعن، وعنعنته مؤثرة مضرة، فتدليسه من النوع الشديد، فالحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه بعض العلماء الأفاضل المعاصرين، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حسنه يلزم بأن يأتينا بتصريح لـهشيم بالسماع؛ لأن هشيم مدلس، هذا شيء.
الناحية الفقهية للحديث: الحديث في حالة ثبوته حمل فقرتين، كانوا يعدون الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت، كما يفعل في بعض القرى عندما يموت ميت، يأتي المعزون للتعزية ويصنعون لهم طعاماً أشبه ما يكون بالوليمة، فالحديث اجتمع فيه فقرتان، فهل الواو في قوله: (كانوا يعدون الاجتماع وصنعة الطعام)، للتشريك، أي: كانوا يعدون الاجتماع مع الأكل أو الواو بمعنى: أو؟ الظاهر الأول، والله أعلم، وعلى هذا درج الفقهاء، لكن إسناد الحديث -أصلاً- فيه نظر، وأقوال الفقهاء ينصب كثير منها على الاقتران بين الجلوس وبين الأكل، أما إذا مات ميت فتعزية من مات له ميت مشروعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام عزى أصحابه، وأرسلت له ابنة من بناته تقول: إن ابنها نفسه تقعقع، وتطلب منه أن يأتي إليها، فأرسل التعزية، (وأخبرها أن لله ما أخذ، وأن له ما أعطى ... الحديث)، فأقمست عليه أن يأتيها، فأتاها مع طائفة من أصحابه، فأتاها للتعزية مع طائفة من أصحابه فوجد الولد نفسه تقعقع.
الشاهد: أن الرسول أتاها للتعزية، وجلس ورُفع إليه الطفل، وذرفت عيناه بالدمع، فسأله سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟! قال: (هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادة)، فالرسول جلس وجلس معه سعد بن عبادة، وجلس معه على ما يحضرني أبي بن كعب، أو طائفة من أصحابه، فهم جلسوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
أيضاً ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام للتعزية عندما استشهد جعفر رضي الله عنه، فبعد ثلاثة أيام ذهب إلى بيت جعفر، فعزى آل جعفر على موت جعفر، وأتي له بأولاده فدعا لهم عليه الصلاة والسلام.
أيضاً في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت، وانصرف الناس وبقي أهل الميت، أمرت بالتلبينة فصنعت وقالت: إنها مذهبة للحزن، مجمة لفؤاد المريض، فكانت تأمر لهم بنوع من الطعام ليأكلوه، فالشاهد: أن أصل التعزية مشروع، والتعزية في حقيقتها نوع من أنواع المواساة وجبر الخاطر التي أتى بها ديننا.
فالظاهر -والله أعلم- أن أصل التعزية مشروع، فإن جاء المعزي إلى البيت وجلس خمس دقائق أو عشر دقائق فهذا جائز، لكن التكاليف التي تحدث في السرادقات والإحداثات والبدع هي المذمومة، لما فيها من تباهي، ولما فيها من أخذ أموال من تركة الميت، وفيها حق للأيتام، وتعطي للمقرئين المبتدعين وغير ذلك.
أما حديث: (اصنعوا لآل
ثم إن حديث الرسول: (اصنعوا لأهل
فالخلاصة: إذا كان يشق على أهل الميت صنع الطعام ترفع عنهم هذه المشقة، لحديث جعفر عند من صححوه، ونحن نحترم من صححه، وقد قال بمقتضاه الجمهور، والله أعلم.
أما حديث: (لا عزاء بعد ثلاث)، فضعيف، وحديث جعفر : (أمهل الرسول ثلاثاً ثم ذهب إلى آل جعفر)، صحيح، فتخصيص التعزية بثلاثة أيام لا أعلم عليه دليلاً.
حكم مصافحة النساء من غير المحارم
الجواب: المحرمة حرمة مؤقتة لا تصافح ولا يسافر معها، مثل أخت الزوجة، فهي محرمة حرمة مؤقتة، فعندما تصافحها وتجلس معها قد يقع في قلبك حبها فتطلق أختها وتتزوجها، فمن كانت محرمة حرمة مؤقتة، لا يسافر معها، ولا تجوز مصافحتها، ولا الخلوة بها.
حكم زواج الرجل من ابنة امرأة زنى بأمها
الجواب: السؤال يحتاج إلى شيء من التوضيح، رجل زنا بامرأة، والمرأة لها بنت، فهل هذه البنت هي بنته من الزنا أو هي بنت المرأة من رجل آخر؟
فإن كانت بنتاً للمرأة من زوج آخر، فيجوز له الزواج بها، لأن الحرام -كما يقولون- لا يحرم الحلال، لكن منع من ذلك بعض العلماء حتى لا يصل إلى أمها بالفاحشة.
أما بنت الزنا: أي: البنت التي خلقت من مائه نفسه، فالجمهور على أنه لا يجوز له أبداً أن يتزوجها، وهذه من المسائل التي أخذت على الإمام الشافعي رحمه الله، حتى أنشد الشاعر البيت القائل:
وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم
فقد نقل عن الإمام الشافعي : أنه يبيح نكاح المخلوقة من ماء الزاني، ويقول: إنها ليست بنتاً شرعية، فكما أنها لا ترث يجوز لك أن تتزوجها، وتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأتى بإيرادات حسنة على من قال بهذا القول بصفة عامة، وقال: إن كنتم تعتبرون المقياس هو الإرث، فأختي من الرضاع حرام علي وهي لا ترثني ولا أرثها، ومع ذلك هي محرمة علي.
حكم الصلاة في الثوب الواحد
الجواب: أولاً: لعل الأخ السائل فهم أن الثوب الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل الثوب الذي في زماننا، لا، ليس كذلك، إنما كانوا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعنون بالثوب الواحد القطعة الواحدة، مثل الإحرام، فكان الشخص يرتديه، فيلف جزءاً منه على فخذه وعورته والجزء الآخر على كتفه.
فالرسول نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لأنه ممكن ينزل أثناء الركوع فتنكشف العورة، ولذا لابد أن يكون الثوب الواحد على العاتق منه شيء، ويكون وساتراً للعورة، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: (أوكلكم له ثوبان؟)، فيختلف الحكم بحسب الثوب، فما المراد بالثوب الواحد؟ هل هو القطعة التي يأتزر بها الشخص، ويأخذ شيئاً منها ويضعه على الكتف أو المراد بالثوب الواحد: القميص الذي نلبسه الآن (الجلبية)؟ يختلف الحكم، وهل الجلبية شفافة أو غير شفافة؟ لم تدخل في الحكم.
حديث: الشريد الثقفي: (استنشدني النبي عليه الصلاة والسلام شعر أمية بن أبي الصلت...)؟
الجواب: الحديث في صحيح مسلم.
هل عدم محبة الأنصار ينفي الإيمان
الجواب: المراد بالحب والبغض: الحب الشرعي والبغض الشرعي، فالذي يبغض الأنصار لكونهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منافق، والذي يحب الأنصار لكونهم ناصروا رسول الله فهو مؤمن، أما إذا دبت بينك وبين أنصاري مشكلة، فكرهت الأنصاري من أجل هذه المشكلة المادية فلا شيء عليك، فإن الزبير قد اختلف مع أنصاري في شراج الحرة، ونزل قوله تعالى في الأنصاري: ![]() فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ![]() [النساء:65]، والزبير مؤمن من العشرة المبشرين بالجنة.
[النساء:65]، والزبير مؤمن من العشرة المبشرين بالجنة.
حكم إزالة الشعر أثناء الدورة الشهرية
الجواب: لا بأس به، ولا دليل يمنع من إزالة الشعر في أثناء الدورة الشهرية، ولا من قص الأظفار، ولا من نتف الإبط.
حكم إلقاء الشعر المزال في دورة المياه أو سلة المهملات
الجواب: لا يلزم أن يدفن في التراب، وليس في هذا فيما علمت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يوضع في مكان لا أذية فيه على أحد من المسلمين.
حكم مصافحة أم الزوجة وخالتها
الجواز: بالنسبة لأم الزوجة تجوز، فأم الزوجة محرمة تحريماً مؤبداً، دخل الزوج بالزوجة أم لم يدخل، فإن الله قال: ![]() وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ![]() [النساء:23]، قال العلماء: هي مبهمة، يعني لم تقيد بالدخول من عدمه، فبمجرد العقد على الزوجة حرمت أمها عليك على التأبيد، فإذا عقدت على البنت حرمت الأم عليك على التأبيد، لكن إذا عقدت على الأم لم تحرم عليك البنت إلا بعد الدخول.
[النساء:23]، قال العلماء: هي مبهمة، يعني لم تقيد بالدخول من عدمه، فبمجرد العقد على الزوجة حرمت أمها عليك على التأبيد، فإذا عقدت على البنت حرمت الأم عليك على التأبيد، لكن إذا عقدت على الأم لم تحرم عليك البنت إلا بعد الدخول.
أما بالنسبة لخالة الزوجة فتحريمها مؤقت، فتحرم خالة الزوجة تحريماً مؤقتاً، فلا يجوز لك الزواج بها إلا إذا حصلت الفرقة بينك وبين زوجتك.
 البث المباشر
البث المباشر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
11989
قراءة متن الشاطبية
مشاري راشد العفاسي -
10374
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
4584
قصص الأنبياء - قصة ابراهيم في فلسطين وبناء الكعبة - قصة اسماعيل واسحاق- قصة قوم لوط
طارق السويدان -
3874
منظومة عشرة الإخوان
توفيق سعيد الصائغ -
2686
قصة آدم عليه السلام
نبيل العوضي -
2575
سلسلة السيرة النبوية من الظلمات إلى النور
راغب السرجاني -
2182
الرقية الشرعية - مشاري راشد العفاسي
-
2124
متن الدرة المضية__عثمان المسيمي
عثمان المسيمي -
1975
عمر بن الخطاب
بدر بن نادر المشاري -
1944
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي

عدد مرات الاستماع
3086718663

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك