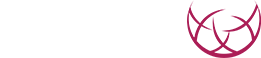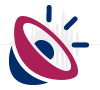 الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- حسن أبو الأشبال الزهيري
- كتاب الحج
- شرح صحيح مسلم - كتاب الحج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة.
إن الحاج إذا لم يجد ما يشتري به شاة فالواجب في حقه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكذلك إذا كان معه المال الذي يشتري به الشاة ولكنه لم يجد شاة ليشتريها فالواجب عليه أن يصوم.
أما قول من قال: يقيم الشاة ويتصدق بثمنها على فقراء الحرم فهذا ليس بصحيح، والصحيح: أن من لم يجد عين الشاة وجب عليه الصيام، سواء أكان لا يملك ما يشتري به الشاة، أو يملك المال ولكنه لم يجد الشاة نفسها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله].
قال: [عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج)].
قوله: (تمتع النبي صلى الله عليه وسلم)، ونحن نعلم أن التمتع الاصطلاحي ليس هو حج النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً، فالتمتع هنا هو التمتع اللغوي، وهو الالتفاف والانضمام، وهو أنه جمع العمرة إلى الحج، وجمع الحج إلى العمرة قراناً من جهة الاصطلاح، وإن كان من جهة اللغة يسمى القران تمتعاً.
فالاصطلاح أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة بالحج مفرداً، ولما قارب مكة نوى إدخال العمرة على الحج فكان قارناً، فهو أول الأمر كان مفرداً، ثم قرن قبل طواف القدوم.
قال: [تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة -يعني: لما خرج من مكة أهل بالعمرة- ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى -أي: من الناس من ساق الهدي معه من الميقات- ومنهم من لم يهدي -أي: ومنهم من لم يسق معه الهدي من الميقات- فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه)]، يعني: من ساق الهدي معه من الميقات فإن حجه قران، والقارن لا يحل من حجه حتى يتم حجه الأكبر؛ لأن الحج يطلق على العمرة من باب المجاز، والحج الأكبر هو بعد رمي الجمرات والنحر والحلق والطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، فحينئذ يحل له.
والمفرد لا يحل إلا في يوم النحر، وكذلك القارن لا يحل إلا في يوم النحر، أما المتمتع الذي لم يسق الهدي فإنه إذا اعتمر تحلل من إحرامه تماماً وحل له كل شيء حتى النساء، ثم يهل بالحج يوم التروية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: (من كان منكم أهدى -أي: ساق الهدي- فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه)، يعني: يوم النحر.
قال: [(ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل)] يعني: الذي لم يسق الهدي يعتمر، فيطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة، ويقصر أو يحلق ويكون بذلك قد تحلل من عمرته تماماً، وهذا للمتمتع.
قال: [(ثم ليهل بالحج وليهد)]، أي: يهل يوم الثامن وهو يوم التروية.
قال: (ثم ليهل بالحج ثم ليهد)، والهدي يكون في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة سواء كان ذلك بالنسبة للقارن أو للمتمتع
قال: [(فمن لم يجد هدياً)]، وهذا القول متوجه للمتمتع؛ لأن القارن سيتحدد موقفه من الميقات، إذا كان قد ساق الهدي أو لم يسقه، فإذا كان قد ساق الهدي معه فهو قارن لا محالة، وإذا لم يكن قد ساق الهدي فإما أن يجد هدياً في مكة أو لا يجد، فإذا وجد كان متمتعاً وإلا فلا.
قال: (ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هدياً) أي: من المتمتعين الذين تحللوا من عمرتهم تماماً، وفصلوا بينها وبين الحج فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
أما كيفية حجه صلى الله عليه وسلم قال: [(وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء)]، أي: الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود؛ لأن الركن اليماني يطلق على الركنين اليمانيين، بخلاف الركنين الشاميين اللذين هما في مقابل الركنين اليمانيين.
قال: (فاستلم الركن أول شيء)، وهذا طبعاً فيه بيان أن الطائف حول البيت لا بد أن يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، وليجعل البيت عن شماله ثم يكمل طوفة كاملة، فمن الحجر إلى الحجر طوفة، ولا بد أن يطوف من خارج حجر إسماعيل؛ لأنه إن طاف ومر من بين الحجر والكعبة فلا يحسب له طواف؛ لأن حجر إسماعيل من الكعبة، فالذي يعبر من بين الحجر والكعبة كأنه طاف من داخل الكعبة، والأصل في الطواف أنه يكون حول الكعبة.
قال: [(ثم خب ثلاثة أطواف من السبعة ومشى أربعة أطواف)]، معنى خب: هم، وهذا الهم هو الرمل، أن يجري في مكانه، وهذا مسنون.
قال: (خب ثلاثة أطواف) يعني: رمل فيها، ثم في الأربعة الباقية مشى مشياً عادياً.
قال: [(ثم ركع)]، أي: ثم صلى ركعتين، ومن تيسر له الصلاة خلف مقام إبراهيم فهو السنة، ومن لم يتيسر له ذلك فيجزئه أن يصلي ركعتين في أي موطن من الحرم.
قال: [(ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام)]، أي: ركع عند المقام ركعتين يقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب بـ![]() قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ![]() [الكافرون:1]، وفي الثانية بعد فاتحة الكتاب بـ
[الكافرون:1]، وفي الثانية بعد فاتحة الكتاب بـ![]() قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ![]() [الإخلاص:1].
[الإخلاص:1].
قال: [(ثم سلم فانصرف -من صلاته- فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط)]، أي: من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط؛ لأن بعض الناس يخطئ فيعد من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط واحد، وبهذا يكون قد سعى بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً، وهذا طبعاً بخلاف السنة، ولا يفعله إلا الجهلاء من الناس.
أما أهل العلم وطلابه وكثير من الناس فإنهم يعرفون أنه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوطان لا شوط واحد، بحيث يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، كما رتب الله عز وجل. قال: ![]() إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ![]() [البقرة:158].
[البقرة:158].
فهنا الطواف يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة؛ ولذلك أهل العلم يقولون: يتحلل من إحرامه بالحلق عند المروة، كما أن الحاج يتحلل من إحرامه بالحلق عند جمرة العقبة الكبرى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
ولكنه على أية حال إذا حلق في أي مكان من الحرم جاز له ذلك، وقولي: من الحرم أي: من حدود الحرم، لا من حدود المسجد الحرام.
وأنتم تعلمون أن حدود الحرم تبدأ من التنعيم غرباً إلى عرفة شرقاً أو شمالاً، والجعرانة وغير ذلك من الأماكن التي تحد اسم الحرم، فمن حلق في أي مكان منها كان له ذلك، لكن لا ينبغي للمعتمر أو للحاج أن يخرج خارج حدود الحرم فيحلق في الحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته العملية بينت أن المعتمر إنما يتحلل من إحرامه عند المروة، كما أنه أعطى شعره لـأبي طيبة في حجة الوداع، فحلقه عند جمرة العقبة الكبرى، وناول الشق الأيمن لـأبي طلحة رضي الله عنه، فأخذه لنفسه ولأهل بيته، ثم ناوله الشق الأيسر وقال: (يا أبا طلحة ! فرقه في الناس أو اقسمه في الناس)، فقام أبو طلحة يقسم شعر النبي عليه الصلاة والسلام شعرة لكل واحد أو شعرتين لكل واحد.
فهنا بيان أنه يستحب للحاج والمعتمر أن يتحلل بالحلق أو بالتقصير في آخر منسك من منسكه، سواء كان ذلك في عمرة عند باب المروة، أو في حج في منى عند جمرة العقبة الكبرى.
إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المتمتع أنه إذا أتى البيت فطاف به وسعى بين الصفا والمروة أن يقصر أو يحلق، وبذلك يكون قد حل وحل له كل شيء كان حراماً عليه في حال إحرامه، هذا حكم المتمتع.
لكنه عليه الصلاة والسلام أتى البيت فطاف به وسعى بين الصفا والمروة ثم لم يحلل حتى حل بعد أن قضى حجه، أي: في يوم النحر، فرمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم حلق ثم أهدى.
فهنا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارناً؛ لأنه بعد أن قضى عمرته لم يتحلل، وهذا حكم القارن.
شروط وجوب هدي التمتع
أما اتفاقهم فأوله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج)، وأشهر الحج هي: شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، فإذا أتى المعتمر إلى مكة، واعتمر في هذه الأشهر جاز له أن يتحلل من إحرامه انتظاراً ليوم التروية، وليهل بالحج من مكانه.
قال: (الثاني: أن يحج من عامه)، أي: يحج في نفس العام الذي أدى في أشهر الحج منه عمرته.
مثال ذلك: شخص ذهب اليوم واعتمر وهو متمتع، ولما جاء الحج لم يهل بالحج، وقال: أنا باقٍ إلى العام القادم، فهنا لا يظل متمتعاً؛ لأن شرط التمتع أن تقع العمرة والحج في عام واحد، وأنتم تعرفون أن آخر أشهر العام الهجري هو شهر ذي الحجة، فلا يجوز له أن يدعي أنه متمتع إلى العام المقبل، بل من دخل مكة في أشهر الحج فاعتمر وتحلل بنية إدخال الحج على العمرة تمتعاً فإنه لا بد أن يدخل الحج من نفس العام، وهذا محل اتفاق.
قال: (الثالث: أن يكون آفاقياً لا من حاضري المسجد)، ما معنى آفاقياً؟ يعني: من الآفاق البعيدة، وليس من أهل مكة، وحاضره يعني: حاضر أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
يعني: أن يكون آفاقياً لا من حاضري المسجد، وحاضروه هم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر معها الصلاة، يعني: يكون من أماكن بعيدة، أما أهل مكة فالأصل في حجهم الإفراد.
قال: (الرابع: ألا يعود إلى الميقات لإحرام الحج)، يعني: ألا يعود إلى الميقات حتى يهل بالحج في يوم التروية، وإنما يهل من بيته، أو من مكانه، سواء كان مكانه الحرم أو البيت أو السوق أو في أي مكان.
قال: (وأما الثلاثة المختلف فيها: فأحدها نية التمتع).
فمثلاً: واحد ذهب إلى المدينة يوم العيد بعدما اعتكف العشر الأواخر من رمضان في مكة، وقعد في المدينة يومين أو ثلاثة أيام، ولما رجع إلى مكة أحرم بالعمرة، وليس له نية أبداً في التمتع، لكنه قال: أنا أستفيد بعمرة. فأحرم من ذي الحليفة ودخل مكة مرة أخرى على اعتبار أنه يعتمر ويذهب إلى جدة فيسافر، فلما دخل الحرم قال: ما المانع أن الواحد يمكث في الحرم ويجاور إلى أن يحج؟ قال ذلك بعدما عبر الميقات بزمن، فهل يلزمه الآن أن يخرج إلى الميقات إذا أراد الحج؟ الجواب: يحرم من مكانه، حين تنبعث به راحلته يوم التروية، ويبقى متمتعاً؛ لأن عمرته وقعت في أشهر الحج من نفس العام، فإذا دخل منى يوم التروية ومنع من الحج وأمر بترحيله فإنه يلزم في حقه دم، فإن قال: (لبيك اللهم حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)، ثم تعرض له هؤلاء وأمروا بترحيله فليس عليه شيء؛ لأنه اشترط. قال: (فإن حبسني حابس)، أي: منعني مانع (فمحلي)، أي: فأذن لي أن أتحلل بغير قيد ولا شرط كفارة.
قال: فالثلاثة المختلف فيها قال: النية، لا يلزم المتمتع أن ينوي في الميقات التمتع على أرجح أقوال أهل العلم، كما أنه لا يلزم القارن؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج فقط من ذي الحليفة، ولما أتى ووصل إلى الجعرانة أدخل معها العمرة، بدليل أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر شعره، ثم لم يحلل حتى كان يوم النحر.
ومعلوم أن الذي يفرد الحج أو يهل بالحج من الميقات لا يلزمه ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل العمرة على الحج وهي إلى أبد الأبد، ليست خاصة له ولا لأصحابه، فعلى ذلك يجوز إدخال العمرة على الحج الأبد.
الثاني: كون الحج والعمرة في شهر واحد.
والراجح: أنه لا يلزم أن تقع العمرة والحج في شهر واحد؛ لأن أشهر الحج ثلاثة وليست شهراً واحداً.
والثالث: كونهما عن شخص واحد، والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترط، والله تعالى أعلم.
حكم الحاج إذا لم يجد هدياً
قال: [(فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)]، فهو موافق لنص القرآن الكريم، ويجب صوم هذه الثلاث قبل يوم النحر.
ويوم النحر هو يوم العاشر، واليوم الذي قبله يوم عرفات، وأنتم تعلمون أن صيام عرفات مسنون لغير الحاج، ويكره للحاج صوم عرفات.
إذاً: هذه هي الأيام الثلاثة التي يصومها في أشهر الحج، وجمهور العلماء على أن الصيام واجب في الأيام الأول من شهر ذي الحجة، أي: بعد دخول المتمتع مكة وأداء العمرة، فتكون هذه الثلاثة الأيام واقعة بين العمرة والحج، أي: وهو متحلل.
قال: (ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم يوم عرفة منها، أما الأفضل ترك ذلك، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله، والأفضل ألا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة، فإن صامها بعد فراغه من العمرة، وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندنا، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزئه على الصحيح).
قال: (أما صوم السبعة فيجب إذا رجع إلى أهله) وفي المراد بالرجوع خلاف.
قال: (الصحيح في مذهبنا: أنه إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح.
والمذهب الثاني: إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى، ولكن المذهب الأول هو الصحيح.
ولو لم يكن الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام)، يعني: من لم يتمكن من أداء الثلاثة في مكة لا يسقط عنه صومها، بل يلزمه صيام العشرة عند أهله.
لكن يبدأ بالثلاثة أولاً، ثم يجعل بينها وبين السبعة فاصلاً من إفطار، حتى يفرق بين الثلاثة وبين السبعة، ولو صامها كاملة لأجزأه ذلك، والأولى أن يفرق بينها بإفطار.
فلو التمس الهدي في يوم النحر ولم يجد هدياً، أو لم يجد نقوداً يشتري بها الهدي، أو أن نقوده سرقت، فكل هذه الصورة تعني: انعدام الهدي، فيلزمه الصيام حينئذ، ولا يصوم أيام التشريق، فإنه يحرم صومها؛ لأنها أيام عيد، ولو مات قبل الصيام لا شيء عليه، وصيامه يجب في حق الأولياء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه).
ويجزئ أن يتعدد الأولياء. يعني: لا بأس أن يصوم كل ولي من أوليائه يوماً له، بحيث يجتمع له عشرة أيام يقوم بها عشرة من الأولياء، أو واحد يصوم عشرة أيام، أو اثنان يصوم كل منهما خمسة.
بيان حج المفرد
فإذا كان الحاج مفرداً فإنه يذهب مباشرة إلى منى، أو إلى عرفات إذا لم يدرك يوم التروية، ولا شيء عليه؛ لأن إدراك يوم التروية في منى من السنن وليس من الواجبات، وكذلك المبيت بمنى في هذه الليلة ليس بواجب، بل هو مسنون، فإذا أتى الرجل وأدرك الوقوف بعرفة فإنه ينزل بعد ذلك إلى مزدلفة بعد غروب شمس التاسع، فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة، ويبيت بها وجوباً، ثم ينطلق بعد ذلك -أي: بعد شروق الشمس من يوم النحر- إلى منى، ثم يرمي جمرة العقبة الكبرى بعد الزوال -أي: بعد الظهر في يوم النحر- ثم يحلق، وبذلك يتم له التحلل الأول الذي يحل له كل شيء إلا النساء.
فإذا نزل إلى مكة -أي: أفاض إلى مكة وهو يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة حل له كل شيء حتى النساء، وهذا يسمى عند أهل العلم التحلل الأكبر، ولا يبقى هناك محظور من محظورات الإحرام التي تعرفنا عليها آنفاً.
والمفرد ليس عليه هدي كما اتفقنا، إنما الهدي على المتمتع والقارن؛ ولذلك ذهب أهل العلم كما عرفنا في الدروس الماضية إلى أن أفضل صور الحج الإفراد لكماله وتمامه، وهم يرون أن الهدي عند القران والتمتع إنما هو لجبر خلل ونقص في الصورة، هذا الخلل وهذا النقص يتمثل في عدم إلزام القارن والمتمتع بالخروج من الميقات يوم التروية.
اشتراك المفرد والقارن في وقت التحلل
ويستحب للقارن أن يدخل مكة في أول ذي الحجة، أو قبل الحج مباشرة، حتى إذا اعتمر في اليوم السادس أو الخامس أو السابع من ذي الحجة لم يبق له بملابس إحرامه إلا يوم واحد، وينطلق بهذه الملابس أو بهذا الإحرام إلى منى في يوم التروية، فلا يمكث كثيراً في بيوت مكة، أو في بيت الله الحرام بملابس الإحرام.
فإن افترضنا أنه أتى قبل ذلك بأسبوع أو بأسبوعين أو بثلاثة فيلزمه أن يبقى في ملابس إحرامه ولا يتحلل -لا تحللاً أصغر ولا تحللاً أكبر- حتى يؤدي حجه ويتحلل من الحج في يوم النحر، كالمفرد تماماً والذي ذكرنا صورته الآن.
فالقارن والمفرد كلاهما يشترك في صورة، وهي تحلل كل منهما في يوم النحر، بخلاف المتمتع، فالمتمتع يدخل مكة ويعتمر ويتحلل بعد الحلق عند جبل المروة، ثم يهل من مكانه يوم التروية، والمتمتع إذا أدى عمرته حل له كل شيء حتى النساء، بخلاف القارن فلا يجوز له أن يتحلل إلا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح أو الحلق والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة.
معنى إشعار الهدي وتقليده
وقد عرفنا معنى تلبيد الرأس في الدروس الماضية، ثم قال: (وقلدت هديي) وتقليد الهدي: إشعار الهدي وسوقه من الميقات مقلداً مشعراً، وسوق الهدي من الميقات يكون للقارن، أما المتمتع فإنه يأخذ هديه من أي مكان: من منى، من عرفة، من مزدلفة، من مكة، من أي مكان، ولا يلزمه أن يسوقه، فإن ساقه صار قارناً.
وإذا ساق الهدي من الميقات يسن أن يكون هذا الهدي مشعراً في خده الأيمن أو في صفحة وجهه اليمنى، وأن يكون مقلداً في قدمه، إما بلبس نعل أو لبس جلد في قدمه، أو إحاطة القدم بحبل أو شيء يميزه.
ومعنى إشعار الهدي في صفحة وجهه اليمنى: جرح الهدي في جانبه الأيمن أو في أذنه حتى يعلم من نظر إلى هذا الهدي أنه هدي، وأنه ليس بلقطة، وإذا التقطه يلزمه أن ينادي عليه؛ لأن هذا أوقف لله عز وجل، وهذا معنى الإشعار.
فالإشعار: هو قيام العلامة والدليل والأمارة في وجه الهدي، يجرحه في صفحة خده الأيمن أو بوضع علامة في أذنه اليمنى أو غير ذلك.
وتقليده بمعنى: تقييد قدمه بشيء، أي: وضع علامة في قدمه، إما خيط يميزه أو حبل أو لبس نعل من الجلد وغير ذلك، حتى إذا نظر إليه ناظر عرف أن هذه البقرة أو أن هذا البعير أو أن هذه الشاة إنما أوقفت لله عز وجل، فالذي يأخذها يحترم نفسه ويرجعها بسرعة؛ لأنه رزق حرام.
قال: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي -أي: سقت هديي من الميقات- فلا أحل حتى أنحر) وهذا الحديث دليل على المذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحاً بدلائله في الأبواب السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً في حجة الوداع.
وفي رواية: قال لها: (فلا أحل حتى أحل من الحج)، وقالت حفصة رضي الله عنها: (إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت
يعني: لو أحصرت. هل لك أن تتحلل من إحرامك؟ الجواب: نعم. لك ذلك.
وهل يجوز لك أن تدخل الحج على العمرة قراناً؟ الجواب: نعم. يجوز لك ذلك وإن لم تنو من الميقات ذلك.
خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معتمراً، وكان ذلك في أيام الفتنة التي دارت بين الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الله بن الزبير، وأنتم تعلمون أن الحجاج دخل كما تدخل البهائم والحمير بلد الله الحرام، فضرب الكعبة بالمنجنيق، وكانت فتنة عظيمة جداً أكلت الأخضر واليابس.
فـعبد الله بن عمرو دخل مكة في عام الفتنة معتمراً، وقال: [(إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)]، يعني: إن حال بيننا وبين البيت حائل تحللنا من إحرامنا كما تحللنا في عمرة الحديبية.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكة في عام الحديبية معتمراً، وصده المشركون عن البيت، وقامت هناك شروط واتفاقيات من أحد بنودها أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا العام ولا يدخلوا مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم، فتحلل من إحرامه في الحديبية، فـعبد الله بن عمر قال: إن صدني الحجاج أو صدتني الفتنة القائمة بمكة فما الذي يمنعني أن أتحلل في المكان الذي صددت فيه كما تحللنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية.
قال ذلك بعد أن عبر الميقات بأيام ليس بخطوات؛ لأنه أهل من ذي الحليفة بعمرة، وأدخل معها الحج في مكة، ويشترط شرطاً وحيداً أصيلاً فيمن أدخل الحج على العمرة: أن يكون ذلك قبل طواف القدوم، أما المتمتع فله أن يدخل الحج على العمرة بعد طواف القدوم، أما القارن فإنه يلزمه أن يدخل الحج على العمرة قبل بداية الطواف.
قال: [وعن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير . قالا: لا يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت].
يعني: عبد الله بن عبد الله وأخوه سالم يقولون لـعبد الله بن عمر: أترك الحج هذه السنة؛ لأن هناك قتالاً وفتنة عظيمة جداً بين الحجاج وابن الزبير ، ونخشى ألا تتمكن من الحج.
قال: [(فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة -يعني: أحرم بالعمرة من الميقات- فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، ثم تلا: ![]() لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ![]() [الأحزاب:21]، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء -أي: بالمكان الفسيح الذي بجوار الحرم- قال: ما أمرهما إلا واحد -أي: حكم الصد في العمرة كحكم الصد في العمرة والحج- إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة، فانطلق حتى ابتاع بقديد -مكان بالحرم- هدياً ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر)]، وبقية الأحاديث في الباب تشهد للمعنى الذي ذكرناه.
[الأحزاب:21]، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء -أي: بالمكان الفسيح الذي بجوار الحرم- قال: ما أمرهما إلا واحد -أي: حكم الصد في العمرة كحكم الصد في العمرة والحج- إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة، فانطلق حتى ابتاع بقديد -مكان بالحرم- هدياً ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر)]، وبقية الأحاديث في الباب تشهد للمعنى الذي ذكرناه.
وفي هذه الأحاديث جواز التحلل بالإحصار، وفيه صحة القياس والعمل به؛ لأن عبد الله بن عمر اجتهد فقاس هذا على ما كان من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس؛ فلهذا قاس الحج على العمرة في حكم الإحصار من عدمه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها.
وفي هذا الحديث: أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب جماهير العلماء.
يعني: في جواز الإفراد بالحج وجواز القران بين الحج والعمرة.
قال: [عن ابن عمر قال: (أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفرداً)]، هذا كان من ميقات ذي الحليفة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في الجاهلية. قيل: حج مرة وقيل: حج مرتين، والراجح: أنه حج مرة قبل البعثة.
لكن هذا الحديث في حجه عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة -أي: بعد البعثة- وفي العام العاشر، وهو المعروف بحجة الوداع، ويؤيد ذلك أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الإسلام إلى حجة واحدة، وكان إهلاله من ذي الحليفة، ويقول عبد الله بن عمر : (وأنا معه)، ومعلوم أن عبد الله بن عمر لم يحج مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة؛ لأن عبد الله بن عمر لم يكن موجوداً.
اختلاف العلماء في نوع الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم
وقد اختلف العلماء في أي الحج أفضل: الإفراد أو التمتع أو القران؟ وكل من قال بقول قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وظهر هذا في بعض الأدلة.
أما الذي قال: التمتع أفضل اعتمد على ظاهر بعض الروايات التي تقول: تمتع النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة إلى الحج، ورددنا على هذا القول برأيين:
الرأي الأول: أن التمتع في هذا الحديث محمول على التمتع اللغوي لا التمتع الاصطلاحي.
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي من الميقات).
فالذي يسوق الهدي من الميقات هو القارن لا المتمتع.
الأمر الثالث: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر لم يتحلل إلا في يوم النحر بعد أداء هذه المناسك، فهذه كلها شواهد وأدلة تدل على أنه كان قارناً.
والذي يقول: الإفراد أفضل، واعتمد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً في حجه، فاعتمد على منشأ الحج. أي: أصل الحج في ذي الحليفة، فقد أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالحج فقط من ذي الحليفة، والصواب والصحيح: أنه لما بدأ الحج مفرداً أدخل عليه من الجعرانه العمرة، فكان أولاً مفرداً وقبل أداء العمل في الحج أدخل عليه العمرة؛ فاعتمر أولاً ثم حج.
إذاً: كان في أول مشواره مفرداً ولكنه لم يتم هذا الإفراد، بل أدخل عليه العمرة فصار قارناً، وهو الراجح بل الصحيح.
ومعلوم أن سوق الهدي على سبيل الاستحباب للمفرد والمعتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي استحباباً؛ لأنه نوى الإفراد، ولكنه شجعه سوق الهدي على إدخال العمرة فصار قارناً.
وهناك اتفاق بين أهل العلم أن المعتمر لا هدي عليه، وأن المفرد لا هدي عليه، لكن لا يمنع ذلك من أن يهدي المفرد والمعتمر، وليس هناك مانع شرعي.
قال: [وقال أنس : (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً)]، وهذا يورد خلافاً بينه وبين عبد الله بن عمر، فـأنس يقول: سمعته يلبي بالحج والعمرة، وعبد الله بن عمر يقول: أنا كنت معه، وما كان يلبي إلا بالحج فقط.
قال أنس بن مالك : أنا لم أكن صغيراً، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مفرداً، فقد سمعته يقول: (لبيك اللهم حجاً وعمرة)، وعبد الله بن عمر يقسم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لبيك اللهم حجة).
وتفسير هذا الخلاف أن عبد الله بن عمر حكى ما قد سمعه من أول المشوار، من ميقات ذي الحليفة، وأنس بن مالك كان يأخذ بخطام ناقته في مناسك الحج ابتداءً من الجعرانة حتى قضى حجه، فسمعه يقول: (لبيك اللهم عمرة وحجة) فلما أدخل النبي عليه الصلاة والسلام العمرة على الحج سمعه أنس فحكى ما سمعه، وعبد الله بن عمر حكى ما سمعه من أول المشوار، وعلى أية حال كل واحد من الصحابة يحكي ما قد سمعه، وكلام أهل العلم كلام جميل في الجمع بين الخبرين.
وفي رواية: [أن بكر بن عبد الله قال: حدثنا أنس : (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما -بين الحج والعمرة- قال: فسألت
الإمام النووي يقول: (قدمنا أن الرأي المختار -بل الصحيح- في حجة النبي عليه الصلاة والسلام: أنه كان في أول إحرامه مفرداً، ويحمل عليه حديث عبد الله بن عمر ، ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارناً، وهذا حديث أنس وبهذا اتفقت الروايات، وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع، فحديث ابن عمر محمول على أول إحرامه، وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أولاً، ولا بد من هذا التأويل أو نحوه؛ لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبق بيان ذلك).
يعني: من أحرم بالحج فقط.
قال [وبرة : (كنت جالساً عند
انظر الكلام الجميل في التأصيل الفكري عند السلف.
يقول: النبي عليه الصلاة والسلام طاف وسعى، وابن عباس : يقول: لا. فأيهما أحق: الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله أو بقول ابن عباس ؟ يقول: فإن كنت صادقاً في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فاتبعه.
صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف وسعى، لكنه كان قارناً، فالسؤال وجه لمن أفرد الحج: هل يلزمه الطواف والسعي؟ الجواب: لا يلزمه، ولو أنه دخل البيت فيطوف طواف القدوم الذي لا علاقة له بالنسك، ويكون هذا الطواف دون أن يسعى بين الصفا والمروة.
قال: [وبرة : (سأل رجل
يقول له: المسألة هذه فيها خلاف بينك وبين ابن عباس ، لكنك أحب إلينا من ابن عباس ، فأنت رجل عالم وزاهد ورجل فاضل، وابن أمير المؤمنين، أما ابن عباس فقد فتن وفتحت عليه الدنيا، وكان قد تولى الإمارة في البصرة، وعادة الأمراء أنهم أصحاب أموال وأصحاب وجاهة وغير ذلك، فأنت يا ابن عمر ! أحب إلينا من ابن عباس ، ورأيك إن شاء الله محل احترام، وسنعمل به!
فانظر على الفتنة قول وبرة : (أنت أحب إلينا من ابن عباس) كأن هذا الأمر ليس بالعلم، وإنما بالفقر، فهو يستفتي الفقير، والفقير أحب إليه من الغني، هذا كلام غير صحيح، فالأمر كله مداره على العلم الصحيح المؤيد بالدليل.
فقال ابن عمر: (وأينا -وفي رواية: وأيكم- لم تفتنه الدنيا).
فـابن عمر لم يستغل الموقف، ولم يقل: نعم. والله صحيح، فعلاً ابن عباس فتنته الدنيا وأنا رجل فاضل، ولو شاء لحط يده في يد وبرة، وصارا يؤلبان الناس على ابن عباس كما يفعل أهل هذا الزمان. ولا أزكي نفسي.
ثم قال -أي ابن عمر : (رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله ورسوله أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقاً).
المخطئ في هذا كله كما قلنا ابن عمر ؛ لأن ابن عمر يفتي من أراد الحج والعمرة، سواء كان متمتعاً أو قارناً، أما السؤال الموجه في الإفراد فالحق مع ابن عباس .
قال: [عن عمرو بن دينار : (سألنا
قال: [(فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعاً، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)]، يعني: لا تحل امرأته إلا إذا أحل.
هذا الباب في حكم القارن لا المتمتع؛ لأن المتمتع إذا طاف وسعى وحلق أو قصر جاز له كل شيء حتى النساء، أما المفرد فيأتي مباشرة إلى منى أو إلى عرفات. ويتحلل في يوم النحر، وربما لم يبق لإحرامه إلا يومان: يوم عرفة ويوم النحر، على فرض أنه لم يدرك يوم التروية.
قال: [عن محمد بن عبد الرحمن: (أن رجلاً من أهل العراق قال له: سل لي
قال: [(ثم حج
هذا الكلام لا بد من تأويله: (لما مسحوا الركن حلوا)، ويقصد الركن الذي فيه الحجر الأسود، وأن الماسح للركن يمسحه في مبدأ الطواف، وهل هناك تحلل بمجرد البدء بالطواف، أم أن التحلل يكون بعد السعي والحلق والتقصير؟ إذاً: لا بد من تأويل هذا النص. قال: فلما مسحوا الركن حلوا، والتأويل: أنهم لما انتهوا من الطواف والسعي والتقصير حلوا، هذا تأويل ولا بد منه حتى لا تتضارب الروايات.
قال: وقد كذب فيما ذكر من ذلك، وبقية الروايات على نحو هذا.
تحلل أسماء بنت أبي بكر لعدم وجود الهدي وعدم تحلل الزبير لوجود الهدي معه
ومن لم يكن معه هدي فليحلل بعد أداء العمرة. قالت: [(فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع
وفي رواية: قالت: [(قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج)، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج] لما أدخلوا العمرة على الحج، فكان بعضهم ساق الهدي فكان قارناً، وبعضهم لم يكن معه الهدي فصار متمتعاً.
قال: [غير أنه قال: فقال: استرخي عني -يعني: ابعدي عني- فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟]
قال: [وعن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدث: (أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله وسلم)].
الحجون: أعالي مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها؛ ولذلك يسمون مكان الدخول المعلاة إلى الآن، ويسمون مكان الخروج المسفلة، وهذه الشوارع معروفة بهذه الأسماء إلى الآن.
قال: [(كلما مرت
قالت: (فلما مسحنا البيت) أي: فلما أدينا مناسك العمرة في البيت؛ لأن العمرة كلها في بيت الله الحرام، ومناسك العمرة: طواف وسعي وحلق، والنية تسبق ذلك.
قالت: [(ثم أهللنا من العشي بالحج)]، يعني: ثاني يوم بعد الظهر أهللنا بالحج، أي: دخلوا مكة يوم السابع من ذي الحجة واعتمروا، وما مر عليهم إلا الليل وأوائل يوم الثامن، وفي العشي -والعشي يطلق على ما بعد الظهيرة- انطلقوا إلى منى مهلين بالحج.
قال: [عن مسلم القري قال: (سألت
قال: (سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها) أي: عبد الله بن الزبير ، واسم أمه أسماء .
قال عبد الله بن عباس : هذه أم ابن الزبير فإذا كان ابن الزبير ينكر التمتع بالحج، فإن أمه حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير صحابي صغير، ولم يثبت أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بل كان طفلاً صغيراً فلم يحج، فإذا أردت أن تسأل فاسأل أمه، فهي خبيرة بذلك.
قال: [(هذه أم
قال: تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة، فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا أمرأة ضخمة عمياء.
طبعاً هذا الكلام لو قيل على سبيل التنقص لكان غيبة وكان حراماً، لكنه على سبيل التحقق أنه قد دخل وعرف أن هذه أسماء فسألها، وأسماء كانت مثل سودة رضي الله عنها في ضخامتها؛ ولذلك لما لبست سودة النقاب وخرجت إلى حاجتها، وكان عمر يغار على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: فقال: (يا
قال: [(فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها)].
قال: [وقال مسلم القري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم -أي: بعد أداء العمرة لمن كان متمتعاً- فكان
قال: [عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى الأرض)].
هذه -الحمد لله- ظلمة أخرجنا الله عز وجل منها على يد نبينا عليه الصلاة والسلام.
قال: [(كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى الأرض، ويجعلون المحرم صفراً)]، وهذا النسيء الذي تكلم الله عز وجل عنه في القرآن الكريم وفي قوله تعالى: ![]() إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ![]() [التوبة:37].
[التوبة:37].
وكان أهل الجاهلية يرون أن القتال وإراقة الدماء في الأشهر الحرم منقصة عظيمة لا تجوز، والأشهر الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ورجب ليس مع الأشهر المذكورة في الترتيب، بل هو قبل هذه الأشهر بشهرين، ولذلك سموه رجب الفرد، يعني: رجب لوحده، والثلاثة الأشهر الحرم الباقية هي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، لكنهم بمزاجهم، يقولون: المهم أن هناك أربعة شهور حرماً لا نحارب فيها، فيقومون بالنسيء، وهو أن يؤخروا شهراً ويقدموا شهراً مكانه، هذا النسيء الذي حرمه الله عز وجل في القرآن، وجعله مظهراً من مظاهر الكفر.
قولهم: (إذا برأ الدبر) يقصدون: برأ أدبار وأظهار الإبل من التعب والكل وكثرة المشي.
وقولهم: (وعفا الأثر) أثر الجمال في مشيها في الصحراء مع طول الوقت تأتي الرياح بالرمال فتجعل هذه الآثار كأن لم يكن جمل مر من هنا من قبل.
وقولهم: (وانسلخ صفر) يعني: انقضى صفر.
وقولهم: (حلت العمرة لمن اعتمر) يعني: الذي يريد أن يعتمر يعتمر بعد صفر.
قال: [(فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة)] يعني: دخل مكة يوم الرابع من ذي الحجة، يعني: في نفس التوقيت الذي حرم أهل الجاهلية تأدية العمرة فيه.
قال: [(مهلين بالحج، وأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: الحل كله)] يعني: تحللوا تماماً من أعمال العمرة، حتى تؤدى العمرة وحدها والحج وحده في أشهر الحج، خلافاً لما كان عليه الجاهلية.
قال: [عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة)].
قال: [عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طول وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة، إلا من كان معه الهدي)]، فالذي كان معه الهدي يبقى قارناً، يعتمر ويبقى في إحرامه حتى يتحلل يوم النحر.
قال: [قال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذه عمرة استمتعنا بها)] قوله: استمتعنا بها يشمل القارن والمتمتع؛ لأنه ما كان قد نوى عمرة من الميقات، وإنما نوى حجاً فقط، فلما أدخل العمرة على الحج صار مستمتعاً بالعمرة، مع أنه كان قارناً؛ فهذا الاستمتاع في حق القارن استمتاع لغوي، أما في حق المتمتع فإنه تمتع اصطلاحي.
قال: [(فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة)].
قال: [عن أبي جمرة قال: (تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت
إذاً: هذه بشارة، والحق مع ابن عباس لا مع من نهى أبا جمرة عن التمتع.
قال: [(فأتيت
قال: [قال ابن عباس رضي الله عنهما: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن معنى أشعرها: جرحها وخدشها -وسلت الدم- يعني: نظف الدم في موضع الجرح- وقلدها نعلين) يعني: ألبسها نعلين، أتى بجلد فربطه على مؤخرة قدم هذا الهدي، قال: (ثم ركب راحلته) لم يركب التي قلدها وأشعرها، وإنما واحدة أخرى غيرها؛ لأن الهدي لا يركب؛ فقد صار وقفاً لله عز وجل يمنع استخدامه.
قال: [(ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج)].
قلنا: إن من أهل من الميقات إنما يهل إذا استوت به ناقته أو دابته وانبعثت، وذكرنا أن بعض أهل العلم قال: إن الإهلال بالنسك سواء كان حجاً أو عمرة يكون بعد الصلاة وقبل أن يقوم من مقامه في مسجد الميقات.
والصواب: أنه يهل إذا ركب دابته وانبعثت به، أي: وقامت، فبعد أن يتحرك الباص يبدأ في الإهلال، أما الإهلال من المسجد أو بعد الصلاة أو من الساحة أو من البيداء المجاور للمسجد أو غير ذلك فكل هذا ليس صحيحاً، ولذلك ابن عمر قال: (هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتزعمون أنه ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند الشجرة)، وقد بينا في الدروس الماضية أن الشجرة هذه كانت عند باب مسجد ذي الحليفة، ولكن عمر قطعها حتى لا يعبدها الناس من دون الله عز وجل.
إذاً: إذا ركب الرجل دابته وقامت أو تحركت بدأ في الإهلال، أما قبل ذلك وبعد ذلك فلا، فإنه إذا أهل بعد ذلك وجب عليه أن يذبح دماً؛ لأنه قد أهل بعد أن مضى، أو بعد أن عبر الميقات.
والإشعار: هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها، ثم يسلت الدم عنها، وأصل الإشعار والشعور: الإعلام والعلامة، ويقال: إشعار الهدي لكونه علامة له، وهو مستحب؛ ليعلم أنه هدي، فإن ضل رده واجده، وإن اختلط بغيره تميز؛ ولأن فيه إظهار شعار، وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله.
وأما صفحة السنام: فهي جانبه، والصفحة مؤنثة، ومعلوم أن الإشعار سنة وليس بواجب، ويكون الإشعار في الإبل والبقر دون الغنم؛ لأن الغنم أضعف من أن تحتمل الجرح، فضلاً عن أن شعرها وصوفها ووبرها يغطي هذا الإشعار، فلا تكون له فائدة حينئذ.
قال: [قال أبو حسان الأعرج : (قال رجل من بني الهجيم لـ
قال ابن عباس : (لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل -وهذا زيادة من ![]() ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ![]() [الحج:33]).
[الحج:33]).
طبعاً هذا مذهب مخالف لمذهب جماهير الصحابة، فـابن عباس مخطئ في ذلك، فـابن عباس يقول: (من طاف بالبيت) فلو كان يقصد التمتع فكلامه منضبط، أما إذا كان يقصد أن مجرد الطواف يحل للطائف الحل ويحتج بقول الله تعالى: ![]() ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ![]() [الحج:33]، أي: الكعبة، فإنه سيكون مجرد وصول الأغنام أو الأبقار أو الإبل إلى البيت العتيق يجعل صاحب الهدي حلالاً وإن لم يطف؛ لأنه قال:
[الحج:33]، أي: الكعبة، فإنه سيكون مجرد وصول الأغنام أو الأبقار أو الإبل إلى البيت العتيق يجعل صاحب الهدي حلالاً وإن لم يطف؛ لأنه قال: ![]() ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ![]() [الحج:33]، فهذا المذهب خطأ من ابن عباس ، خالفه غيره من الصحابة.
[الحج:33]، فهذا المذهب خطأ من ابن عباس ، خالفه غيره من الصحابة.
ولذلك يقول النووي : هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات، ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل التحللان الكبير والصغير، ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاث التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف.
وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها؛ لأن قوله تعالى: ![]() مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ![]() [الحج:33] معناه: لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام؛ لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف.
[الحج:33] معناه: لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام؛ لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف.
وأما احتجاجه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة، فلا يكون دليلاً في تحلل من هو متلبس بإحرام الحج، يعني: القارن.
يعني: باب جواز التقصير، بل الاستحباب للمعتمر الذي يريد التمتع أن يقصر دون أن يحلق، ويحلق في يوم الكمال والتمام وهو يوم النحر.
قال: [عن ابن عباس قال: (قال لي
قال ابن عباس: إن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة.
هذا الحديث فيه جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر؛ إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق في أكمل العبادتين.
وفيه: أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة؛ لأنها موضع تحلله كما قلنا من قبل، وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة لا في عمرة حجة الوداع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر في عمرة الوداع، وإنما طاف وسعى فقط، ثم انطلق بعد ذلك إلى منى، وحلق في يوم العاشر؛ لأن القارن لا يلزمه التقصير ولا الحلق من عمرته، لأنه قرن بين المنسكين الحج والعمرة، فلا يلزمه الحلق في عمرته أو التقصير، وإنما يلزمه الحلق أو التقصير في حجه.
قال: وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان قارناً، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام حلق بمنى، وفرق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء؛ لأن عمرة القضاء هذه كانت في سنة سبع من الهجرة، ومعاوية لم يكن أسلم في هذا العام، وإنما أسلم في العام الثامن. يعني: بعد ذلك بعام، والله أعلم.
قال أبو سعيد الخدري : (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخاً -هذا كان في حجة الوداع- فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج) أي: من بيوت مكة.
عن أنس رضي الله عنه: (أن
إذاً: المتمتع لا يسوق الهدي، والقارن يسوق الهدي، وإذا ساق الهدي لا يتحلل من عمرته بخلاف المتمتع يتحلل ويهل بالحج من مكانه في يوم التروية.
تتكرر الأحاديث والخلاف بين عبد الله بن عمر وبين أنس بن مالك في مسألة الحج والعمرة.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما).
وهذا يدل على أن عيسى بن مريم هو أحد أفراد أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان نبياً مستقلاً إلا أنه في آخر الزمان يكون تابعاً لأمة الإسلام.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عيسى بن مريم سيأتي في آخر الزمان، إما أن يحج أو يعتمر أو يجمع الحج والعمرة، وهذا يدل على جواز إفراد الحج وجواز التمتع والقران.
يعني: كم عدد العمر التي اعتمرها؟ وفي أي الشهور اعتمر؟
أما عدد العمر فقد وقع الخلاف بين مالك والجمهور:
مالك يقول: اعتمر ثلاث مرات، والجمهور: على أنه اعتمر أربع مرات.
والصواب: هو الجمع بينهما، أن مالكاً قال: اعتمر ثلاثاً غير عمرة حجة الوداع، فلم يعدها، وبذلك تنسجم الروايات ويتألف كلام أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة بعد البعثة، وحج مرة أو مرتين قبل البعثة على ملة إبراهيم عليه السلام.
قال: [قال أنس : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته)]، يعني: ثلاث عمرات في ذي القعدة، وواحدة في يوم الرابع من ذي الحجة.
قال: [(عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته)] أي: في ذي الحجة.
الخلاف بين زيد بن أرقم وبين أنس وبين عائشة وابن عمر وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أقل من ذلك، والصواب ما ذكرناه، وأخطأ من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وما اعتمر في رجب قط، كان عبد الله بن عمر يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر مرة في رجب، والصواب: أنه لم يعتمر في رجب، وراجعته عائشة ، ولما راجعته عائشة سكت ولم يتكلم.
قالت: (يرحم الله
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تكفير الحج المبرور للذنوب
الجواب: ليس كل من وقف بعرفات يغفر له، إنما يغفر له من كان حجه مبروراً.
وفي الحديث: (من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه).
واختلف العلماء في قوله: (كيوم ولدته أمه) ومعلوم أن من ولد لا ذنب عليه، فهل الحج يغفر الذنوب جميعاً كبيرها وصغيرها، أو يغفر الصغائر دون الكبائر.
والراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجماهير: أن الحج يكفر الذنوب جميعاً كبيرها وصغيرها، وهذا فضل من الله.
بيان ما تفعله الفتاة إن أجبرها والدها على خلع النقاب
الجواب: اخلعي النقاب، ولا شيء لك غير ذلك، فإذا رزقت بمن يحفظ عليك أمر دينك فنعما به، لأن كثيراً من الآباء لا يستحقون أن يكونوا آباءً، كما أن الجمع الغفير من الأبناء لا يستحقون أن يكونوا أبناءً.
فالأصل في ضبط هذه المسألة أن كل واحد -أب أو أم- يقف عند حد الشرع، ومن تجاوز ذلك فحسابه على الله عز وجل. أقول لهذه الفتاة أن تخلع النقاب، وألا تخرج من بيتها إلا لضرورة ملحة، وأن تلبسه في خروج يترتب عليه فتنة.
الحكم على حديث (كنت كنزاً مخفياً...)
الجواب: هذا الحديث حديث موضوع غير صحيح، والذي أذكره أن هذا السائل وجه نفس السؤال في الدرس الماضي، وزاد في السؤال: أن هذا الشيخ قال: (حتى يعرفوني) أي: حتى يعرفوا عظمتي وجلالي.
أقول: إن هذا الشيخ الذي قال ذلك -سواء كنتم تعلمونه أو لا- هو في العقيدة ليس على منهج السلف، بل هو يتأول الصفات على منهج الأشاعرة.
فعلى أية حال هو شيخ جليل، وله باع عظيم جداً في الدعوة إلى الله عز وجل، ونحسبه مخلصاً إلا في قضية الصفات، فإنه ليس ينهج نهج أهل السنة، فاحذروا مسائله في الصفات.
أما أن تحذروه برمته فهذا ليس من العدل، بل جهوده مشكورة جداً في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد تاب على يديه آلاف الناس.
حكم تقصير القارن لعمرته وحلقه يوم النحر
الجواب: نعم. يجوز له ذلك، أما وجوباً فلا.
أخطاء العلماء
الجواب: الشيخ أبو زهرة كغيره من أهل العلم، وهو رجل أبلى بلاءً حسناً في نشر دين الله عز وجل، وكان حجر عثرة في وجوه أعداء الله عز وجل في داخل الأزهر وخارجه، وله من الجهود العلمية والمصنفات الفقهية وغيرها ما يحمد له ويشكر، غير أنه أكب هنا، وكان يسلك مسلكاً غير مسلك السلف في بعض القضايا لا في كل شيء، وهذا لا يخلو منه عالم.
فأظن أن منهج أهل السنة في مثل هذا أن يوهب شره لخيره، والنظر إلى ما أخطأ فيه أبو زهرة أو غيره كالشيخ محمد عبده أو رشيد رضا أو غيرهم ما أخطئوا فيه لا أظن أنهم متعمدون للخطأ.
 البث المباشر
البث المباشر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
184763
تكبيرات العيد وتلبية الحجيج
(...) -
82567
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
32857
قصص الأنبياء - قصة ابراهيم في فلسطين وبناء الكعبة - قصة اسماعيل واسحاق- قصة قوم لوط
طارق السويدان -
31130
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي -
22429
الدرس الأول
سمير مصطفى فرج -
21317
أذان محمد الدمرداش - جامع الملك فهد بحائل
محمد الدمرداش -
10095
سورة البقرة
مشاري راشد العفاسي -
7008
سورة البقرة
ماهر حمد المعيقلي

عدد مرات الاستماع
3090288861

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك