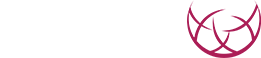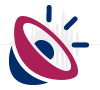 الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- أحمد حطيبة
- محاضرات الحج
- شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة و الحج و الزيارة
- شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - المواقيت الزمانية والمكانية
بيان وقت العمرة وحكم تكرارها في السنة الواحدة
متى تكون العمرة؟ وهل لها وقت مثل الحج؟
نقول: السنة كلها وقت للعمرة، فيجوز الإحرام بها في أي وقت من السنة، ولا تكره في وقت من الأوقات، سواء في أشهر الحج أو في غيرها، إلا إذا كان الإنسان قد تلبس بمناسك الحج فلا ينبغي له أن يأتي بعمرة بعد ذلك، وخاصة إذا كان قد قارب أن يفك الإحرام، أو بدأ في التحلل من حجه، فلا يدخل في إحرام ثان بعمرة، وإنما يكمل تحلله وبعد أن ينتهي الحج فهذا أمر آخر.
وبهذا قال مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء، ولا تكره عمرتان وثلاث وأكثر في سنة واحدة، بل يستحب الإكثار منها، فللإنسان أن يؤدي عمرة في رمضان، ثم بعد ذلك يرجع ويحج في موسم الحج ويؤدي عمرة مع حجه متمتعاً مثلاً، وقد يرجع في جمادى ويؤدي عمرة، فهو يحب أن يعتمر أكثر من مرة في سنة واحدة، فهذا خير عظيم، والله عز وجل ينقي الإنسان من ذنوبه بإكثاره من الحج والعمرة.
وفي الصحيحين: (أن
فالسيدة عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنوي أن تأتي بعمرة، ثم بعد ذلك تحج فحاضت، فلما حاضت وهي محرمة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة رضي الله تعالى عنها.
والناس كانوا قد حلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا متمتعين، وهي كانت تود أن تأتي بعمرة ثم تحل كما حل الناس، ثم تأتي بمناسك الحج، فلم يتهيأ لها ذلك، فصارت قارنة، فلما انتهت من أعمال حجها جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: (فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها) أي: العمرة مع الحج، وفعلاً كانت قارنة فأتت بالحج والعمرة معاً.
وفي رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (قد حللت من حجتك وعمرتك جميعاً) أي: أديت مناسك الحج والعمرة جميعاً، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت) أي: أود أني آتي بعمرة لوحدها ليست داخلة في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فاذهب بها يا
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم، وفي رواية قالت: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم لـ
قال الشافعي رحمه الله: وكانت عمرتها في ذي الحجة، ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي الحجة.
هنا يريد الإمام الشافعي رحمه الله أن يقول: لقد كان لها عمرتان في شهر واحد، فيجوز أن يعتمر الإنسان في الشهر الواحد أكثر من عمرة.
وعن عائشة رضي الله عنها (أنها اعتمرت في سنة مرتين) وفي رواية: (ثلاث عمر)، وجاء في الأثر الذي رواه الشافعي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب : (أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين: مرة من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة)، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، والجحفة ميقات أهل الشام.
ةهذا الحديث يرويه صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد ، فـصدقة تلميذه يقول: هل عاب ذلك عليها أحد؟ فقال: سبحان الله! هل أحد سيعيب على أم المؤمنين أنها فعلت هذا؟ يعني: تأدب واعلم ما تقول؟! إنك تتكلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة ، ومن يعيب عليها وهي من الفقيهات رضي الله تعالى عنها؟
قال صدقة : فاستحييت. يعني: ما كان ينبغي لي أني أقول هذا الشيء، والسيدة عائشة قد فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك.
أيضاً ابن عمر كان يعتمر في عهد ابن الزبير مرتين في كل عام.
ويستحب الاعتمار في رمضان، ويستحب الاعتمار أيضاً في أشهر الحج فيصير متمتعاً، والعمرة في رمضان أفضل منها في باقي السنة؛ لأنه قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو حجة معي)، وجاء: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته) عليه الصلاة والسلام.
فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، فيذكر الراوي أنهن كلهن في شهر ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
بيان الأوقات التي يمتنع الإحرام بالعمرة
وكذا لا يصح إحرامه بالعمرة قبل الشروع في التحلل، فمثلاً: لو أن إنساناً أحرم بالحج وفي يوم التروية ذهب إلى منى، وفي يوم عرفة ذهب إلى عرفة، وبعد ذلك ذهب إلى المزدلفة، ثم رجع إلى منى، وهناك سيبدأ يتحلل من الحج، ففي هذه الحالة المشروع لك أن تتحلل، فكيف تذهب وتحرم في الوقت الذي عليك أن تتحلل فيه؟ فهذا ممنوع من العمرة، فلو أن إنساناً خطر بباله وقال: سأذهب إلى البيت قبل أن أتحلل من الحج وآتي بعمرة وأرجع وأتحلل من الاثنين مع بعض، فهنا يقول العلماء: ليس له أن يفعل ذلك، يقول الشافعي رحمه الله: ولا وجه لأن ينهى أحد عن أن يعتمر يوم عرفة ولا ليالي منى إلا أن يكون حاجاً. يعني: في يوم عرفة وليالي منى يجوز للإنسان إذا كان من أهل مكة أو موجوداً في مكة ولم يحج ذلك العام أن يأتي بعمرة فيها، أما الحاج فيقول الشافعي رحمه الله: هو معكوف بمنى على أعمال من عمل الحج وهو الرمي والإقامة بمنى طاف للزيارة أو لم يطف، فإن اعتمر وهو في بقية إحرام حجه أو خارجاً من إحرام حجه، وهو مقيم على عمل من أعمال حجه فلا عمرة له.
يعني: هو الآن منشغل بأعمال الحج، منشغل بالمبيت في منى، ومنشغل بالرمي، فيجوز له أن يذهب ويطوف بالبيت إن شاء كل ليلة من ليالي منى، لكن لا يؤدي عمرة، هذا كلام الشافعي .
أما الأحناف فقالوا: العمرة تكره تحريماً يوم عرفة وأربعة أيام بعده، فيوجبون الدم على من فعل ذلك.
وقال المالكية: إن أحرم بالعمرة قبل الزوال من اليوم الرابع من أيام النحر لم ينعقد إحرامه، فإذا كان هو في أيام منى وأحرم بالعمرة في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم من أيام النحر أو رابع يوم قبل الزوال فيقولون: لن ينعقد الإحرام.
ويقول المرداوي الحنبلي: لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها.
إذاً: الأئمة الأربعة والفقهاء من المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز له أن يحرم بالعمرة وهو متلبس بمناسك الحج، خاصة إذا بدأ في التحلل من أعمال الحج.
أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج، سواء حج في سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة، فلو أن إنساناً اعتمر في شهر شوال ورجع إلى بلده مرة ثانية، فليس شرطاً أن نقول له: انتظر حتى يأتي عليك الحج، ولكن يجوز أن يرجع إلى بلده، وله أن يرجع بعد ذلك حاجاً أو لا يرجع في ذلك العام.
روى البخاري عن عكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال: (لا بأس، قال
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر في ذي القعدة ثم يرجع للمدينة، ليبين أنه يجوز للإنسان إذا اعتمر في ذي القعدة أن يرجع إلى بلده، ولا يجب عليه أن يمكث حتى يأتي وقت الحج.
وفي الصحيحين عن أنس : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته عليه الصلاة والسلام).
المواقيت المكانية للحج والعمرة
الذي يريد العمرة أو الحج لابد أن يحرم من الميقات، والميقات: هو الموضع وهو الوقت؛ لأن الميقات إما أن يكون ميقاتاً زمانياً، وإما أن يكون ميقاتاً مكانياً، والميقات الزماني للعمرة قدمنا الكلام عليه أنه في أي وقت من السنة يجوز لك أن تحرم بالعمرة، إلا أن يمنع مانع أو سبب من الأسباب، كأن تكون متلبساً بمناسك الحج وستبدأ بالتحلل من مناسك الحج فليس لك أن تأتي حينئذ بعمرة، لكن إنسان آخر في هذه الأيام ليس حاجاً فيجوز له أن يأتي بالعمرة.
والميقات الثاني هو الميقات المكاني، وهذا هو الذي نقصده هنا، فلابد للإنسان الذي يحج أو يعتمر أنه سيمر على الميقات، فعليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، إلا إذا كان من أهل مكة أو من المقيمين فيها، فهذا إذا أراد أن يعتمر وهو بمكة فليخرج إلى الحل ويحرم منه ثم يعتمر.
ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة)، الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام؛ لأنه إذا أحرم قال: لبيك عمرة أو لبيك حجاً، فيرفع صوته بذلك، وكأن الهلال مأخوذ منها؛ لأن الناس كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم: رأيناه، رأيناه، فسمي بذلك لإهلال الناس برفع أصواتهم عند رؤيته.
فهنا قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) هذا هو المكان الذي يحرم منه أهل المدينة وهو ذو الحليفة، ثم قال: (وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن) ، قرن مكان اسمه قرن المنازل، وفي حديث آخر لـابن عمر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة).
فميقات أهل اليمن مكان اسمه: يلملم، وميقات أهل الشام مكان اسمه: الجحفة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة -أي: حدد لهم ميقاتاً يحرمون منه- ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).
أي: أن أهل مكة يحرمون من مكة، والذي بين الميقات وبين مكة يحرم من مكانه، أما من كان وراء الميقات فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه.
أيضاً جاء في حديث رواه مسلم عن جابر، وسئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: (مهل أهل العراق من ذات عرق).
فقد ذكر في هذه الأحاديث خمسة مواقيت مكانية:
الميقات الأول: ذو الحليفة التي تسمى الآن بأبيار علي، وهو مكان قريب من المدينة، وهذا الميقات هو الوحيد البعيد جداً عن مكة، وذلك لأن مكة والمدينة المسافة بينهما يسيرة، فعلى ذلك الخارج من المدينة يحرم من هذا الميقات القريب من المدينة البعيد عن مكة، لكن يشق على غير أهل المدينة أن يحرموا من ميقات بجانبهم، فمثلاً: أهل مصر إذا طلب منهم أن يحرموا من مصر سيشق عليهم، خاصة إذا كان المسافر راكباً البر، وكان الحاج في الماضي يركب على جمل ونحو ذلك، والمسافة طويلة جداً، ولو بقي كل هذه المسافة محرماً لطال شعره ولطالت أظفاره؛ لأن الذي يحج من مصر في الماضي كان يسافر شهراً حتى يصل إلى مكة، ومن يحج من المغرب يسافر أكثر من شهر حتى يصل إلى مكة، فلو أحرم من بلده لصعب عليه وشق عليه ذلك؛ ولذلك الشريعة الكريمة قالت لهذا الإنسان: كن على ما أنت عليه حلالاً من بلدك حتى تأتي الميقات القريب من مكة فتحرم منه؛ تيسيراً على الناس ورفعاً للحرج عنهم.
إذاً: فميقات أهل المدينة هو أبعد المواقيت عن مكة، وبينه وبين مكة حوالي أربعمائة وخمسون كيلو متراً تقريباً، أي: عشر مراحل، والمرحلة تقريباً خمسة وأربعون كيلو، فذو الحليفة هو أقرب المواقيت إلى المدينة وأبعد المواقيت عن مكة.
أما الجحفة فهو ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر، والجحفة قرية اسمها: مهيعة، وتسمى برابغ، وإن كانت الجحفة ليست برابغ؛ لأن قرية رابغ قبلها، وبين الحجفة وبين مكة حوالي مائة وسبعة وثمانون كيلو تقريباً، يقولون: ما بين ثلاث إلى أربع مراحل، والجحفة أجحف بها السيل فصارت مكاناً خرباً، فكانوا يحرمون قبلها من مكان عامر وهو رابغ، وبين رابغ وبين مكة حوالي مائتان وعشرون كيلو.
إذاً: كان الإحرام بعد ذلك من رابغ، فيجوز من رابغ ويجوز من الجحفة بحسب ما يتيسر للمتوجه من المكان.
أما قرن المنازل فهو ميقات أهل نجد، ويمر عليه بعض أهل اليمن، وبينه وبين مكة حوالي تسعون كيلو تقريباً، وهو من ناحية عرفات.
أما يلملم فميقات أهل اليمن، وهو ميقات آخر لهم، وهو يبعد عن مكة بحوالي تسعين كيلو متراً، وهو جبل من جبال تهامة.
أما ذات عرق فهو ميقات أهل العراق، وهو على مرحلتين -نسأل الله عز وجل أن يحررها ممن فيها- وميقات أهل العراق بينه وبين مكة حوالي تسعون كيلو متراً.
وهذا الميقات الذي هو ذات عرق قالوا: إنه قد صار خراباً الآن.
إذاً: هذه هي المواقيت المكانية، وهن لهن ولمن أتى عليهن، فإذا خرجت راكباً سيارة مثلاً من مصر متوجهاً إلى المدينة، وأنت لست بمحرم، فميقاتك ميقات أهل المدينة، ولا ترجع مرة ثانية إلى رابغ أو إلى الجحفة من أجل أن تحرم من هناك، بل ميقاتك ميقات أهل المدينة.
وكذلك إنسان قدم حاجاً من الهند ونزل مصر، وبعد ذلك سيخرج من مصر حاجاً، فميقاته هو الجحفة أو رابغ.
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (هن لهن ولمن أتى عليهن).
حكم الإحرام قبل الميقات وبعده
فلو فرضنا أنك خارج من مصر فميقاتك الجحفة أو رابغ، وبين رابغ وبين مكة مائتان وعشرون كيلو، وأنت إذا ركبت الطائرة فغالباً لن يقول لك سائق الطائرة: أنت فوق الميقات أو غيره، فأنت احتطت من المطار ولبست الإحرام ولبيت وأنت في المطار: لبيك حجاً أو لبيك عمرة، فبإجماع أهل العلم أن ذلك جائز، ولكن خالف داود بن علي رحمه الله وقال: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، ولو أحرم قبله لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات.
نقول: إذا أحرم قبل الميقات أو أحرم بعد الميقات فقد أجمع أهل العلم على صحة هذا الإحرام، وإنما لو أحرم بعدما جاوز الميقات فيلزمه دم أو يرجع إلى الميقات، لكن إحرامه صحيح وليس باطلاً.
يقول داود الظاهري : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة، فهذا يدل على أن الميقات الذي لا يجوز لك أن تتجاوزه هو ميقات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم من عنده، والذي بينه في الأحاديث الأخرى كما قدمنا، لكن لو أنه أحرم قبله فيكون قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحرامه صحيح وليس باطلاً، أما لو جاوزه وهو غير محرم ثم أحرم بعد ذلك، ففعله صحيح، ولكن طالما أنه مريد للحج والعمرة فإما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه ويلبي منه، أو يستمر في إحرامه ويلزمه دم.
إذاً: الإحرام من الميقات هو الأفضل، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ومن حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعاً والعصر في ذي الحليفة ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، فلو كان الإحرام من المدينة أفضل -وخاصة أن مسجد المدينة الصلاة فيه بألف صلاة- لأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ولصلى العصر هناك ثم خرج منه محرماً صلى الله عليه وسلم، ولكن كونه يحرم من ذي الحليفة فهذا دليل على أن الأفضل أن يحرم من الميقات.
أما الذي يريد أن يعتمر وهو من أهل الآفاق الذي نسميه: الآفاقي، أي: الذي أتى من المكان البعيد في الأفق، فهذا يحرم من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم.
مكان إحرام المكي للحج والعمرة
إذاً: إذا كان المسلم مستوطناً مكة أو عابر سبيل وأراد العمرة فميقاته أدنى الحل، والمستحب أن يكون هذا الميقات هو الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، أو من التنعيم؛ لأنه أمر عائشة أن تعتمر منها، أو من أدنى الحل إلى مكة، كل هذا جائز، ولكن الأفضل الجعرانة ثم التنعيم.
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته)، وذكر لـعمر هذا فقال: (عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته في ذي الحجة)، لكن إحرامه صلى الله عليه وسلم كان في ذي القعدة، وقدم لصبح رابعة من ذي الحجة، لكن إحرامه كان في ذي الحليفة لخمس بقين من ذي القعدة.
وأيضاً في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم).
حكم تجاوز الآفاقي للميقات دون إحرام
فإن تجاوز الميقات وهو غير محرم متعمداً لكن بعذر، فهذا عليه دم ويسقط عنه الإثم؛ للعذر، والعذر إما أن يكون خائفاً من قطاع الطريق ومن اللصوص، أو يخاف الانقطاع عن الرفقة فاضطر أن يسرع من أجل أن يلحق الرفقة وألا يضيع ويهلك في الطريق، أو ضاق الوقت، أو كان به مرض شديد فاحتاج أن يتدثر بثياب كثيرة، فيحرم من الموضع الذي هو فيه وعليه دم إذا لم يعد إلى الميقات.
أما إذا لم يعد وهو قادر على الرجوع فإنه يأثم، وإذا كان غير قادر على الرجوع فلا يأثم، لكن عليه دم، فإن عاد بعد الإحرام فأحرم منه فلا دم عليه، سواء كان قد دخل مكة أم لا.
حكم من جاوز الميقات فرجع إليه بعد أن أحرم
فعند الإمام أحمد والإمام مالك أنه سواء رجع للميقات أم لم يرجع عليه دم في الحالتين، أما عند الشافعي وعند محمد بن الحسن فإنه إذا رجع إلى الميقات وعند أبي حنيفة بشرط التلبية عند الميقات فلا شيء عليه، وإذا لم يرجع إلى الميقات فعليه دم.
والراجح في هذه المسألة: أنه لو رجع إلى الميقات وأحرم فلا شيء عليه، لكن لو لم يرجع إلى الميقات وذهب إلى مكة فيلزمه دم؛ لتجاوزه مكان الإحرام وهو غير محرم، ولا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز للميقات عامداً عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، ولكن يفترقون في الإثم، فالناسي نقول له: أمامك خيار من اثنين: إما أن ترجع إلى الميقات وتحرم من هناك، وإما أن تكمل سيرك ويلزمك الدم. والله أعلم.
وللحديث بقية إن شاء الله.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 البث المباشر
البث المباشر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
184763
تكبيرات العيد وتلبية الحجيج
(...) -
82567
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
32857
قصص الأنبياء - قصة ابراهيم في فلسطين وبناء الكعبة - قصة اسماعيل واسحاق- قصة قوم لوط
طارق السويدان -
31130
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي -
22429
الدرس الأول
سمير مصطفى فرج -
21317
أذان محمد الدمرداش - جامع الملك فهد بحائل
محمد الدمرداش -
10095
سورة البقرة
مشاري راشد العفاسي -
7008
سورة البقرة
ماهر حمد المعيقلي

عدد مرات الاستماع
3090314736

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك