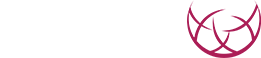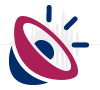 الصوتيات
الصوتيات
- الصوتيات
- علماء ودعاة
- محاضرات مفرغة
- عطية محمد سالم
- سلسلة شرح بلوغ المرام
- شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام
- كتاب الصيام - مقدمة كتاب الصيام [7]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد:
قال المصنف رحمه الله: [ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم) رواه البخاري ].
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مفطرات الصوم، ما يكون منه الفطر وما لا يكون، أو ما يجوز فعله للصائم وما لا يجوز، وبدأ بالحديث عن الحجامة، وقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم) ، وعلى هذه الراوية يكون الحديث عن الحجامة مرتين: مرة في الصيام، ومرة في الإحرام، وهناك رواية أخرى: (احتجم وهو محرم صائم) فتكون الحجامة مرة واحدة في حالة الإحرام ومعه الصيام.
والحجامة من المسائل التي يتناولها الباحث من جهتين: جهة المعالجة، وجهة الفقه.
ويتفقون في الجملة أن للمريض الصائم أن يتداوى كيفما شاء ما لم يصل الدواء إلى الجوف، فإذا كان الدواء يصل إلى الجوف من أي منفذ فلا يجوز للصائم إلا إذا كان يحتاجه ويفطر، وكذلك قال البعض: دواء الشجاج -وهي الشجة في أم الدماغ من الداخل- يبطل الصوم؛ لأن الرأس مجوف، والنووي ينص على أنه لا يبطله.
معنى الحجامة
الحجامة: هي استخراج الدم من الجسم بواسطة شرطة موس، وشفط الدم بالقرن أو ما يماثله، إذاً الحجامة: إخراج الدم من الجسم عن طريق الجلد، وهناك إخراج الدم عن طريق العرق مباشرة، ويسمى الفصد، وهناك إخراج الدم أيضاً عن طريق الجرح أو عن طريق الرعاف، وكل أنواع إخراج الدم من الجسم ما عدا الحجامة يتفق العلماء أنه لا يفطر، ما عدا الحجامة عند الحنابلة كما سيأتي بيانه عند الكلام على الحجامة للصائم إن شاء الله.
فوائد الحجامة
والحجامة من الناحية الطبية يتكلمون عنها من حيث الزمن، ومن حيث الشخص الحاجم والمحجوم، أما من حيث الزمن فإنهم يستحبونها أن تكون في ساعات النهار ما بين الثانية والثالثة بالتوقيت الغروبي -يعني: عند الضحى-، وأما في أيام الأسبوع فيكرهونها يوم الأربعاء ويوم السبت، وأما من حيث الشهر فإنهم يكرهونها في أول الشهر وفي آخره، ويمتدحونها من منتصف الشهر فما بعده، وينصون على السابع عشر والتاسع عشر والواحد والعشرين، ومن العجب أن الفقهاء فطنوا إلى مسألة عجيبة جداً! وهي: أن الحجامة في السابع عشر والتاسع عشر تكون عند هيجان الدم، وينص الفقهاء على أن هذا الوقت هو بتأثير اكتمال ضوء القمر، وهو الذي يعبر عنه الآخرون بالمد والجزر؛ لأن المد والجزر في البحار أشد ما يكون عند اكتمال ضوء القمر في ليلة الرابع والخامس والسادس عشر، ومن هنا قال بعض العلماء الحكماء: إن من حكمة صوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر: اليوم الثالث والرابع، والخامس عشر؛ لأنها تصادف شدة مد الدم في الجسم، والصوم يخفف ويلطف ذلك؛ لئلا يؤثر على الإنسان أكثر، وقالوا: إن الإنسان بحر دم، فكما أن البحر يتأثر مداً وجزراً باكتمال ضوء القمر فكذلك الدم في الإنسان في تلك الآونة تشتد حركته على صاحبه، فإذا صام خفف من هذه الآثار ومن تلك الإثارة.
إذاً: الحجامة من جهة الطب ومن جهة المداواة يختار لها زمن، ثم من حيث المواضع في الجسم يحدده المختص في ذلك، سواء في نقرة القفا، أو على الركبة، أو في الفخذ، أو... إلخ، بحسب الحاجة التي دعت إلى استعمال الحجامة.
وينبهون على أن من لم يحتجم قبل الأربعين لا يحتجم بعدها؛ لأنه لا يتحمل ذلك، ويفرقون بين الحجامة والفصد في العلاج بأن الحجامة علاج للدم في خارج الجسم -أي: الجلد وتحته-، والفصد علاج لداخل الجسم كما هو في الأعضاء الداخلية كالكبد والمعدة والكليتين وغير ذلك.
هذا ما يتعلق بالحجامة، وكان استعمالها سابقاً بكثرة، وأما الآن فتكاد تكون قد تلاشت بالكلية.
حكم الحجامة للصائم
بقي الكلام على حكم الحجامة في الصوم، وسواء كانت حجامة النبي صلى الله عليه وسلم في حال كونه محرماً، أو صائماً بدون إحرام، ونجد العلماء يناقشون في ذلك ويقولون: ما صام صلى الله عليه وسلم في سفر فيه إحرام قط؛ لأنه ما سافر محرماً إلا في حجة الوداع وفي عمرة القضية، أما عمرة ذي الحليفة فما كانت في رمضان، وعمرة حنين أيضاً لم تكن في رمضان، فإذا احتجم وكان قد خرج صائماً محرماً فمتى ذلك؟ قالوا: لم يثبت أنه صام في حال إحرامه، سواء كان إحرام حجة الفرض -وهي حجة الوداع- أو كان إحرامه في عمراته الثلاث التي اعتمرها.
وعلى هذا قالوا: لعله كان صائماً صوم تطوع، وهذا ممكن في بعض أسفاره تلك، فيكون صائماً صوم تطوع، ثم يحتجم وهو صائم، أما رواية: (احتجم وهو صائم) ، لم تحدد المكان، فمن الممكن أن يكون احتجم وهو صائم وهو مقيم، وحينئذ يحتمل أن يكون في رمضان أو في غير رمضان.
والمهم إثبات فعله صلى الله عليه وسلم للحجامة وهو صائم، وبهذا أخذ جمهور العلماء، وقالوا: الحجامة لا تبطل الصوم بصفة إجمالية، لكن جاء عن رافع وعن أوس بن شداد وعن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) وقال أنس في حديثه: (أول ما كرهت الحجامة للصائم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بـ
أما الكلام على نفس الحديث: (أفطر الحاجم)، الحاجم: هو الشخص المداوي الذي يشرط الجلد ويضع القمع، ويشفط من منسم فيه الدم، هذا هو الحاجم، والمحجوم هو الذي يشرط جلده، ويعالج بالحجامة، ويخرج الدم من جلده، فقال العلماء: هل أفطر الحاجم والمحجوم على الحقيقة أو على المجاز؟ ومعنى المجاز هنا: أن يكون مآلهما إلى الفطر، يعني: أخذا بأسباب الفطر، أو تسببا بالفطر وسيفطران، أما حمله على الحقيقة بأنهما أفطرا فعلاً فهذا فيه نظر؛ لأن الحاجم لم يخرج منه دم، هو شرط الجلد، وشفط بفيه الدم، فبم يفطر؟
قالوا: (أفطر) يعني: كاد أن يفطر؛ لأنه لا يسلم أحياناً من كونه يشفط الدم من الجلد إلى المحقن ثم يغلبه الدم ويدخل إلى فيه، فيسبق إلى حلقه فيفطر، قالوا: إذاً: لم يفطر بنفس الحجامة؛ ولكن يفطر بما يغلبه من الدم ويصل إلى جوفه، فإذا لم يصل إلى جوفه شيء فلم يفطر على الحقيقة.
أما المحجوم فإن فطره بخروج الدم.
والحنابلة يقولون: إذا شرط وشفط ولم يخرج دم فلا فطر؛ لأن الأصل في ذلك خروج الدم.
إذاً: الذين قالوا: إن الحجامة تفطر أخذوا بظاهر هذا النص، وسواء كان الفطر على الحقيقة أو على المجاز.
خلاف الأئمة في الفطر بالحجامة
ومذهب أحمد رحمه الله وتبعه أكثر أصحابه -كما في المبدع والإنصاف- أن الحجامة تفطر، قال في الإنصاف: وهو من مفردات المذهب، واختار بعض الحنابلة أنها لا تفطر، وذكر الخلاف بين علماء الحنابلة في أن الحجامة تفطر أو لا تفطر، ولكن الراجح عندهم في المذهب أنها تفطر.
ثم ذكر الفصد، وذكر الخلاف فيه، ورجح أنه لا يفطر، والفصد -كما أشرنا-: هو أن يقطع العرق، ولا يجرح الجلد، يقطع العرق فيتقاطر الدم منه، كما في عملية نقل الدم وأخذ الدم، فإن الطبيب يأتي إلى العرق مباشرة ويدخل فيه تلك الإبرة، ويسحب الدم من العرق مباشرة.
فهذا الفصد فيه خلاف عند الحنابلة في كونه مفطراً أم لا، والصحيح عندهم أو المقدم عند أكثرهم: أنه لا يفطر.
وكذلك ينصون على أن من لم يرد أن يحتجم، ولكن جرح نفسه بدلاً من الحجامة، وليس هناك شفط، وخرج الدم من الجرح فإنه لا يفطر.
واختلفوا فيمن أخرج الدم عن طريق الرعاف من الأنف عامداً متعمداً، هل يفطر أو لا يفطر؟
وعلى هذا فالحجامة للصائم عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله أنها لا تفطر، وبالتالي الفصد، وبالتالي الرعاف، وبالتالي الجرح، وأن للصائم أن يبط الدمل، ويقلع السن إذا احتاج إلى ذلك، وليس فيه إبطال للصوم، وكذلك له أن يعطي الدم لغيره إن كان يستطيع ذلك، فالذي يعطي الدم أو يأخذ الدم لا علاقة لصومه بالدم الذي يعطيه أو يأخذه، هذا عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله.
أما عند الحنابلة فالحجامة والفصد والرعاف والجرح موضع اختلاف بينهم، وأما الحجامة فالراجح فيها عندهم، وهو المقدم عندهم في المذهب أنها تفطر، وهذا القول من مفردات المذهب، واختلفوا في الفصد، والراجح عندهم أنه لا يفطر، فإذا كانت العلة خروج الدم فخروج الدم من العرق أكثر وأغزر من خروجه من الجلد، فلم تفطر الحجامة ولا يفطر الفصد؟ وكذلك إذا لم تحصل الحجامة، ولم يأت بحجام، ولكن جرح جلده وخرج الدم كما لو كان يخرج من الحجامة بمقداره أو أكثر أو أقل، فإذا كانت العلة خروج الدم فلم لم يفطر بتعمده جرح يده؟ وهل الفطر يختص بشرط الجلد؟
الجمهور على أن أحاديث الفطر بالحجامة منسوخة
وابن القيم في زاد المعاد يقول: إن دعوى النسخ لا تثبت حتى نعلم تاريخ الحديثين، وأيهما متأخر؟ هل فعله صلى الله عليه وسلم أم قوله لـجعفر أم قوله للرجلين عند البقيع؟ التاريخ غير معروف، ثم لا نعلم في أي سفر كان، وهل هذا الصوم كان نافلة أو فريضة؟ ويذكر نقاطاً، واستبعد أن حديث ابن عباس يكون ناسخاً لأحاديث الحجامة، ويقول: دعوى النسخ لا يمكن أن نثبتها، وبقي الحديثان متعارضان: حديث من فعله صلى الله عليه وسلم، وحديث من قوله، وإذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل.
فالحنابلة يأبون دعوى النسخ، ويقدمون أحاديث الحجامة على حديث ابن عباس ، وبعضهم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم لا لكونهما يحتجمان، ولكنه رآهما يغتابان وهما يحتجمان، كانا يتكلمان وقت الحجامة، فكان حديثهما غيبة للآخرين، فقال: (أفطرا). أي: بالغيبة.
وكثير من العلماء يتندر بهذه العلة، ويقول: وهل كل من اغتاب إنساناً يفطر؟!
وأحمد رحمه الله لما سمع هذا القول قال: لو أن العلة هي الغيبة لما سلم صوم أحد أبداً.
إذاً: كونهما يغتابان لا دخل له في هذا الموضوع.
إذاً: من الناحية الصناعية الحديثية يكون الحديثان أحدهما فعلي، والآخر قولي، والقولي مقدم، فإذا لم نعرف التاريخ لا نستطيع أن ندعي النسخ، وإذا وجد الفعل منه صلى الله عليه وسلم، ووجد أن الأئمة الثلاثة على أنها لا تفطر، فلابد لترجيح مذهب الأئمة الثلاثة من مرجح، قالوا: جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل: (أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، ولكن من أجل الإرفاق به أو الإبقاء عليه) ، وجاء عن أنس أيضاً قال: (ما نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم والحجامة للصائم إلا إرفاقاً بأصحابه) ، وجاء أيضاً: (ثلاث لا تبطل الصوم: القيء، والحجامة، والاحتلام) ، والقيء سيأتي فيه تفصيل، والاحتلام مفروغ منه، فبالإجماع أن من نام في نهار رمضان فاحتلم فلا شيء عليه، بخلاف من تسبب في إخراج المني، وهذا محله في بحث القبلة، ولكن أخرناه إلى حديث الأعرابي الذي قال: واقعت أهلي، وستأتي تتمة البحث هناك إن شاء الله، ومن هذه الثلاث التي لا تبطل الصوم الحجامة، وهذا محل الشاهد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها مفسدة للصوم، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتجم في نهار رمضان، فلما تقدمت به السن وكبر صار يؤخر حجامته إلى الليل، ومن هنا أخذ الأئمة الثلاثة -من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم- أن الحجامة لا تبطل الصوم، ولكن -كما قال الشافعي رحمه الله- يُنظر إلى الشخص في ذاته، إن كان ضعيف البنية، وإن احتجم زاد ضعفه، واحتاج إلى أن يتناول ما يعوض ما خرج من دمه، ويلجئه ذلك إلى الفطر؛ فهي محرمة عليه، وإن كان معتدل الصحة، لا تؤثر عليه الحجامة، ولا تلجئه إلى الفطر فلا شيء في ذلك، وهذا أعدل الأقوال في قضية الحجامة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله عليه الصلاة والسلام: (أفطر الحاجم والمحجوم) ، حُمل على أنه فطر حقيقي، ومشى على هذا الحنابلة، وحمله الجمهور على أنهما أوشكا أن يفطرا، أما الحاجم فلإمكان سبق الدم إلى حلقه فجوفه، وهذا نظيره حديث لقيط بن صبرة حيث جاء في باب الوضوء: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) لماذا؟ لأن المبالغة في الاستنشاق قد تنزل الماء إلى داخل أنفه، فيصل إلى الدماغ، فينزل إلى الحلق فيبطل صومه، فالنهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم تحفظاً على صومه من أن يسبقه الماء إلى حلقه فجوفه فيبطل صومه، وكذلك هنا منع الحاجم أن يحجم أحداً تحفظاً على صومه من أن يسبقه الدم إلى حلقه فإلى جوفه فيفسد صومه.
أما المحجوم فهو تحفظ عليه؛ لأن في الحجامة إخراج الدم، والإنسان إنما يسير بالدم، فالدم في الجسم هو حياة الإنسان، ويسمى الدم نفْساً كما في قولهم: ( ما لا نفْس له سائلة إذا مات في السمن لا ينجسه) مثل: الذباب إذا وقع في الشراب تغمسه في السائل ثم تشربه إن شئت؛ لأن موته فيه لا ينجسه؛ لأنه لا نفس له سائلة، فالدم يطلق عليه النفْس، وإذا خرج الدم من الإنسان اصفر وصار كالشن، أي: كالقربة الفارغة لا قيمة له، وفارق الحياة، فإذا احتجم الإنسان يضعف قليلاً، وقد يحجمه من لا يعرف قانون الحجامة، فيسحب كل الدم، فحينئذ ينهي دم صاحبه، وقد يموت بين يديه!
ولكن الخبراء في عمل الحجامة يعرفون المقدار الذي يؤخذ، وفي أي موضع من المواضع، إما بتغير لون الدم، وإما بتغير ريحه، ويعرفون الموضع الذي يحجم فيه كم يمكن أن يؤخذ منه، ويراعون سن المحجوم، فهؤلاء لهم خبرة، فإذا لم يكن الحاجم ذا خبرة، أو أخطأ في خبرته، وتجاوز حد ما يؤخذ من الدم، فحينئذ يكون المحجوم على خطر.
فـ(أفطر الحاجم والمحجوم) أي: أوشكا أن يفطرا.
انظروا إلى فقه المؤلف رحمه الله! ساق لنا الأحاديث التي بينها التعارض:
ذكر أولاً حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، ثم حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) ، ثم ختم البحث بحديث أنس ، ماذا في حديث أنس ؟ أنس ممن روى الحجامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سئل: (أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا إبقاءً عليه) فحديث أنس هذا فصل الخطاب.
[ قال: (أول ما كرهت الحجامة للصائم أن
انظروا إلى عرض أنس رضي الله تعالى عنه! لم يقل: رخص النبي بالحجامة للصائم.. لا، بل أتانا بتاريخ الحجامة شرعاً: (أول ما كرهت الحجامة) يعني: هو مستوعب لفقه الحجامة من أولها، ما أولها؟ (أول ما كرهت) يعني قبل قصة جعفر لم تكن مكروهة، كانت ماضية في سبيلها، وأول ما كرهت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر يحتجم، فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم) .
قال: [ (فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم) ].
لما أخبرنا أنس رضي الله تعالى عنه عن بداية كراهية الحجامة بسبب احتجام جعفر رضي الله تعالى عنه، ومرور النبي صلى الله عليه وسلم به وهو يحتجم بالفعل، وقوله لهما: (أفطر هذان)؛ يأتي أنس بالحكم العملي والفقهي: (ثم رخص بعد ذلك) ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم.
إذاً: حديث أنس هذا يدلنا على أن الحجامة أول كراهيتها عند قصة جعفر ، وبعد ذلك رخص في الحجامة للصائم.
إذاً: تكون الحجامة للصائم رخصة، والرخصة تستعمل عند الحاجة، فإذا كان الصائم في حاجة إلى الحجامة نهاراً فعنده رخصة باستعمالها، ولا قضاء عليه، أما إذا كان في غنىً عنها، وعنده ما ينوب عنها، أو عنده سعة ويمكن أن يؤجلها إلى الليل فليست له رخصة فيها، بل يتركها لغيرها أو يتركها لوقت آخر ليس هو فيه صائم، وأعتقد أن حديث أنس هذا هو الفصل، وتقدم لنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ينظر في حالة الشخص الذي يريد أن يحتجم: إن كان يستطيع أن يتحمل أثر الحجامة من الضعف والفتور، ولا يلجأ إلى الفطر؛ فلا مانع، وإن كان لا يستطيع ذلك فيمتنع من الحجامة.
وهكذا سماها أنس رضي الله تعالى عنه رخصة للصائم، يعني: لا تستعمل إلا عند الحاجة الداعية إليها، والله تعالى أعلم.
هذا مما يتعلق بما يكره للصائم وما يجوز، وقد تكلمنا عن الحجامة، وذكرنا الخلاف الخفيف فيها، وقول أنس : إنها رخصة للصائم عند الحاجة، ثم أتى المؤلف بموضوع الاكتحال، وأتى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل)، و(اكتحل): افتعل بوضع الكحل، والكحل محله العين، ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الاكتحال لا يضر الصائم، ولكن نص بعض العلماء أن الكحل له حالتان: حالة يكون خفيفاً جداً لا يتعدى موضعه، وحالة يصل فيها إلى الحلق، فإذا كان يصل إلى الحلق فقد أفطر الصائم؛ ولذا نص الحنابلة على أن من المبطلات والمفسدات للصوم: إذا اكتحل بما يصل إلى الجوف، وهناك أشياء تسري، وهناك أشياء لا تتعدى موضعها، ولكن تمنع سداً للباب، وجاءت آثار فيها النهي عن الاكتحال بالإثمد المطيب، أو الإثمد المروح.
فمن أجاز الاكتحال للصائم قال: النهي عن نوع خاص وهو الإثمد المروح -يعني: الذي فيه رائحة طيبة-؛ لأن الصائم ممنوع من استعمال الروائح الطيبة، ولكن الإثمد مهما كان مروحاً لا يصل إلى حد أن يمنع الصائم منه من أجل الرائحة، وكراهية الروائح الطيبة للصائم إنما هي من قبيل باب القُبلة، قالوا: لأن عرقا الخصيتين في الإنسان مرتبطة بالأنف، فإذا شم رائحة زكية تحرك عليه العرقان؛ فمنعوا من الروائح الطيبة الصائم والحاج، فالحاج إذا أحرم لا يحق له أن يتطيب؛ لأنه مدعاة إلى الإثارة، إذاً: الطيب من حيث هو ليس ممنوعاً، ولكن الممنوع موجب الإثارة، ومهما يكن في الإثمد من رائحة لا تصل إلى الحد الذي يثير عند صاحبه شيئاً.
إذاً: النهي عن الاكتحال إنما هو لكونه في العين، والعين منفذ، فإذا وصل إلى الحلق -كما قال الحنابلة- فإنه حينئذ يكون قد أدخل شيئاً إلى الجوف عامداً، وحينئذ يمتنع عليه أن يكتحل.
والذين يقولون بأن الكحل يؤثر على الصوم يلحقون به كل معالجة للعين ما عدا الماء، فيمنعون الَصِبر للعين، وكذا التوتياء أو الششم أو القطرة، أو أي محلول فيه مادة كيماوية، ويجعلون كل نوع من أنواع المعالجات التي تصل إلى الحلق تابعة للإثمد.
أما علاج العين بالماء فهذا أمر جائز، والإنسان يغسل وجه في الوضوء أكثر من مرة، ومن أنواع علاج العين بالماء: إذا كانت هناك رجرجة أو كانت هناك حرارة، أن تأخذ كأساً من الماء البارد العادي، وكما يقول بعض الأطباء: يبيته في الخلاء في الليل، ثم يأخذه صباحاً، ويفتح العين فيه، ويكون الإناء مليئاً بالماء، ويضعه على بؤبؤ العين، ويحرك حاجبيه أو رمشيه، فيدخل الماء البارد تحت الحاجب هنا أو تحت الرمش -كما يقولون- ويصل إلى شحمة العين، فيستخلص الحرارة منها، هذا نوع من العلاج، وينفع من ضعف البصر في بعض الأحيان، لكن لا دخل له ولا سريان له إلى الدماغ.
إذاً: الكحل للصائم ممنوع، ويلحق به كل ما له نفوذ من العين إلى الجوف، واعتبروا العين منفذ، والأنف منفذ، والأذن عند الحنابلة أيضاً منفذ، وكل دواء لهذه الجهات أو عن طريقها يصل أثره إلى الحلق فهو مبطل للصوم، والله تعالى أعلم.
وللحاكم (من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) ، وهو صحيح ].
ذكر المؤلف رحمه الله من مبطلات الصيام الحجامة، والكحل، ثم جاءنا بمن أفطر أو أكل ناسياً، وكذلك أيضاً إذا احتجم ناسياً أو اكتحل ناسياً، فما حكم من تعاطى مبطلاً للصوم ناسياً بصفة عامة؟ يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث: (من أكل أو شرب وهو صائم ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) .
هذا الحديث يعتبر منة من الله سبحانه وتعالى، ولطفاً من الله، فإنه لا يؤاخذ الإنسان في نسيانه: ![]() رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ![]() [البقرة:286] إلخ، وقال صلى الله عليه وسلم: (رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .
[البقرة:286] إلخ، وقال صلى الله عليه وسلم: (رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .
فإذا نسي الإنسان صومه، وتناول الماء تلقائياً وشرب، أو تناول الأكل تلقائياً وأكل، ثم تنبه بأنه صائم، ماذا يفعل؟
الحديث يقول: (فليتم)، تذكر أنه صائم فليمسك، ويتم صومه بقية يومه، ولا يفطر بما أكله، قال الله: ![]() ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ![]() [البقرة:187] ، والذي أكل أو شرب في نهار رمضان ما أتم الصوم، بل قطعه، لكن الحديث صريح بأن الإنسان يتم صومه، وأنه فضل من الله، وقد أطعمه الله وسقاه.
[البقرة:187] ، والذي أكل أو شرب في نهار رمضان ما أتم الصوم، بل قطعه، لكن الحديث صريح بأن الإنسان يتم صومه، وأنه فضل من الله، وقد أطعمه الله وسقاه.
وقوله: (أطعمه الله وسقاه) هنا واضح، أكل وشرب حتى ولو شبع، كما في بعض الآثار أن جارية دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده ذو اليدين وهما يفطران، فقال: (هلم إلى الطعام) ، فجلست وأكلت، ولما انتهوا قالت: أوه! أنا كنت صائمة، نسيت. فقال لها: أبعدما شبعتِ؟! فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: (أتمي صومك؛ فإنما أطعمك الله وسقاك) .
إذاً: تفسير: (أطعمه الله وسقاه) واضح، أطعمه ما أكل، وسقاه ما شرب، فالإطعام والسقيا هنا حقيقة واقعية لا تحتاج إلى تأويل، بخلاف (لي طاعم يطعمني، وساق يسقيني) ، فهناك فيه الإشكال، أما هنا فلا إشكال، أطعمه الله، أي: ساق له الطعام، وعفا له عن أثره، وصحح له الصيام، فهذه منحة جاءته من حيث لا يعلم.
والأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون: من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه، ويتم صومه ولا شيء عليه.
ومالك رحمه الله يقول: عليه قضاء يوم مكانه. لماذا -يا مالك - فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (أطعمه الله وسقاه) ؟
قال: نعم، ولكن لم يقل: وليس عليه قضاء. بل قال له: (يتم صومه)، وكونه يتم صومه فصومه ماض، لكن في بعض الروايات: (ولا قضاء عليه) قال: لا تصح، والله تعالى يقول: ![]() ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ![]() [البقرة:187]، وهذا لم يتم، (أطعمه الله وسقاه) هذه نعمة من الله، وأنه لم يؤاخذه على الأكل والشرب في رمضان؛ لأنه لو أكل أو شرب عامداً لكان عليه القضاء، ومع القضاء كفارة؛ لأن مالكاً يوجب الكفارة بالأكل والشرب، خلافاً لمن لا يوجبها إلا بالجماع.
[البقرة:187]، وهذا لم يتم، (أطعمه الله وسقاه) هذه نعمة من الله، وأنه لم يؤاخذه على الأكل والشرب في رمضان؛ لأنه لو أكل أو شرب عامداً لكان عليه القضاء، ومع القضاء كفارة؛ لأن مالكاً يوجب الكفارة بالأكل والشرب، خلافاً لمن لا يوجبها إلا بالجماع.
فـمالك أخذ الحديث على الرخصة أو على العفو، وطالب من أكل ناسياً بيوم مكان اليوم، ولكن الصحيح الواضح أن من أكل أو شرب ناسياً فإنه يتم صومه، وصومه كامل، ولا قضاء عليه، والله تعالى أعلم.
 البث المباشر
البث المباشر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
 الأكثر استماعا لهذا الشهر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
-
184763
تكبيرات العيد وتلبية الحجيج
(...) -
82567
البوم روائع القصائد
عبد الواحد المغربي -
32857
قصص الأنبياء - قصة ابراهيم في فلسطين وبناء الكعبة - قصة اسماعيل واسحاق- قصة قوم لوط
طارق السويدان -
31130
أذان بصوت الشيخ ناصر القطامي
ناصر القطامي -
22429
الدرس الأول
سمير مصطفى فرج -
21317
أذان محمد الدمرداش - جامع الملك فهد بحائل
محمد الدمرداش -
10095
سورة البقرة
مشاري راشد العفاسي -
7008
سورة البقرة
ماهر حمد المعيقلي

عدد مرات الاستماع
3090306018

 القرآن الكريم
القرآن الكريم علماء ودعاة
علماء ودعاة القراءات العشر
القراءات العشر الشجرة العلمية
الشجرة العلمية البث المباشر
البث المباشر شارك بملفاتك
شارك بملفاتك